حول الكتاب
الأهالي الأعزّاء؛
كيف نعزّز الفضولَ والتساؤلَ عند طفلنا؟
عندما تجرؤ أنثى الغراب الصغيرة على التساؤل وتفحُّصِ الأمور التي سمِعَتْها من الغربان الأكبر سنًّا، تُقرّر أن تجرّبَ وتغامرَ مُحلّقةً من عُشّها في أعلى الشجرة، لتكتشف أنّ العالم في الأسفل ليس مخيفًا كما قيل لها؛ وأنّ هناك عالمًا واسعًا ينتظرها أعلى الشجرة.
يُبرز هذا الكتاب أهمّية التساؤل والبحث وخوض التجارب الجديدة، ويفتح أمام طفلنا بابًا واسعًا لاكتشاف العالم من حوله، فهو يدعوه أن يفحص ما يسمعه، ويتأمّل فيما يراه، ويجرّب فيبني فهمه الخاصّ بعيدًا عن الأحكام الجاهزة. يمنحُنا الكتابُ الفرصةَ لنرافق طفلنا في التجارب الجديدة التي تتداخل فيها مشاعر الفضول والخوف وحبّ الاستطلاع؛ فنرافقه ونشجّعه على اكتشاف العالم من حوله ونسانده في التحقّق من الحقائق والنظر إلى العالم من زوايا عدّة، من خلال صياغة الأسئلة المفتوحة: ما رأيك؟ لماذا؟ كيف؟ وماذا؟ بذلك، نعزّزه في مسار البحث ونبثّ له رسالة -أنت قادر على التأثير والاكتشاف- تمامًا كما أنثى الغراب الصغيرة.
نتحدّث عن جرأة وشجاعة أنثى الغراب الصّغيرة
نتحاور حول
أحداث القصّة: نتتبّع الرسومات والنصّ مع طفلنا ونسأله: ماذا كانت تعتقد الغربان الأكبر سنًّا في بداية القصّة، ممَّ كانت تحذرُ؟ ولماذا كانت الغربان تَحرُسُ الشّجرة؟ ماذا فعلت أنثى الغراب الصغيرة؟ ماذا اكتشفت؟
الشجاعة والجرأة: نتحدّث عن جرأة وشجاعة أنثى الغراب الصّغيرة، نتوقّف عند الصفحة التي تتساءل فيها أنثى الغراب “هَل ْ يُعْقَل ُ أَن ْ تَكون َ جَميع ُ ٱلْغِرْبان ِ مُخْطِئَةً؟” نتساءل: ما الذي يميّز أنثى الغراب الصّغيرة؟ هل كانت جريئة؟ كيف ؟
تجارب شبيهة: هل حدث معك مرّة أن جرّبت واكتشفت شيئًا جديدًا؟ ما هو؟ هل هناك أمر تريد أن تجرّبه ولا تجرؤ؟ ما هو ولماذا؟
يحتوي نصّ الكتاب على تعابيرَ، تشبيه واستعاراتٍ متنوّعة
نثري لغتَنا
نتعرّف على مفردات وكلمات جديدة – حالِكة، متطفّل، رَصَدت، ، شَهقت وغيرها.
يحتوي نصّ الكتاب على تعابيرَ، تشبيه واستعاراتٍ متنوّعة، مثل: “كرةٌ كبيرةٌ مضيئةٌ” ، “مثل طائرات ورقيّة”. نشجّع طفلنا على استخدام أسلوب التشبيه لوصف ما حوله، مثلًا : عيناك تلمعان مثل النجمة الساطعة وغيرها.
نَرسمُ لوحاتٍ مُسْتوْحاةً مِنَ الكِتابِ بِألْوانِ الأَكْريليك
نُبدعُ
نَرسمُ لوحاتٍ مُسْتوْحاةً مِنَ الكِتابِ بِألْوانِ الأَكْريليك، نُجَرِّبُ التَّدَرُّجاتِ وَالطَّبَقاتِ كَما في الرُّسوماتِ، وَنَبحث عن هذا الفنّ عبر الإِنْتِرْنِت.
نتعرّف على صفات طائر الغراب
نكتشف ونتعرّف
كثيرًا ما يرتبط الغراب بأفكار سلبيّة مثل التشاؤم والخراب، إلّا أنّ الغراب من الطيور الذكيّة والفضوليّة، نتعرّف على صفات طائر الغراب المختلفة، ونتساءل: تُرى لماذا ارتبطت صفاته بهذه الأفكار عند قسم من الشعوب؟
حول الكتاب
المربّيات العزيزات،
دعوة للتساؤل وكسر المألوف.
يدعونا هذا الكتاب إلى الخروج من دائرة المألوف، وطرح الأسئلة بدلاً من تقبّل ما يُقال كحقيقة مطلقة. فهذه من أهمّ المهارات في بناء تلميذ صغير مستقلّ واثق وواعٍ.
من خلال قراءة الكتاب والحوار حوله، يمكننا مساعدة الأطفال على تطوير مهارات أساسيّة في التفكير، مثل الفضول، التساؤل، والتفكير الإبداعيّ. نطرح معهم أسئلة مثل: لماذا فقط ننظر إلى الأسفل؟ هل كلّ ما يقال لنا صحيح؟ ماذا لو جرّبنا بأنفسنا؟
كلّ هذه الأسئلة تحفّز الأطفال على التفكير النقديّ تحليل ما يُعرض عليهم، بدلًا من تقبّله بشكل تلقائيّ أو خاضع. إنّ بيئة الصفّ تشكّل فرصة ثمينة لتعليم الأطفال كيف يلاحظون، يشكّكون، ويستكشفون. نشجع الأطفال على النظر للعالم من زوايا مختلفة، وذلك من خلال أسئلة مفتوحة، مثل: لماذا؟ كيف؟ وهل حقًّا؟
تحمل القصّة أيضًا، رسالة تمكين قويّة للتلميذ الصغير؛ ،فالبرغم من صغر سنّ أنثى الغراب الصغيرة، استطاعت أن تكسر القيود وتؤثّر على من هم أكبر منها.
إنّها تذكّرنا بأنّ لكلّ طفل هناك صوتا خاصًّا وقدرة على التأثير والتغيير، متى ما أتيحت له الفرصة المساحة والثقة.
حول التعامل مع التجارب الجديدة
نتحاور- نفتح حوارًا مع التلاميذ
1) حول أحداث القصّة- ما صفات عائلة الغربان؟ ما هي صفات أنثى الغراب الصغيرة؟ ما الذي يميّزها عن بقيّة الغربان؟ ماذا اكتشفت؟ هل تعتقدون أنّ صغيرة الغراب فعلت الصواب؟ لماذا؟ ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكانها؟
2) حول فهم القصّة والتفكير النقديّ- ” ماذا لو كانوا جميعا مخطئين؟” نتوقّف عند الصفحة عندما تساءلت أنثى الغراب الصغيرة، وندعو التلاميذ الصغار إلى التفكير والحوار. كيف شعرَت أنثى الغراب عندما خطرت في بالها هذه الفكرة؟ هل سبق و صدّقتم شيئًا قيل لكم ثمّ اكتشفتم أنّه غير صحيح؟ ما إيجابيّات/ حسنات هذا التساؤل؟ كيف يمكن أن يساعدنا في الحياة؟ وماذا يمكن أن تكون التحدّيات والصعوبات التي قد نواجهها حين نفكّر بشكل مختلف عن الآخرين؟
حول التعامل مع التجارب الجديدة: كيف تتصرّفون عندما تواجهون تجارب جديدة؟ ماذا تشعرون ؟ هل تشعرون بالخوف، بالفضول، بالحماس؟ ما الذي يساعدنا على التعامل مع هذه المشاعرهل التحديات تعني أنّنا ضعفاء؟ أم أنّها فرصة لاكتشاف أشياء جديدة؟
نثري لغتنا –نستخدم التشبيه لنعبّر بجمال!
نثري لغتنا –نستخدم التشبيه لنعبّر بجمال!
نجد في نصّ الكتاب تعابير تشبيه جميلة، مثل: كرة ضوء كبيرة، طائرات ورقيّة ملوّنة. هذه الصور تجعل الكلام أجمل وأكثر تعبيرًا، وتشعل خيالنا!
- نشجّع تلاميذنا الصغار على استخدام التشبيه لوصف ما يرونه أو يشعرون به من حولهم. من خلال جمل بسيطة، نحو: مدرستنا جميلة كأزهار الربيع. أنت غالٍ عليّ مثل الذهب. ابتسامتك كلحن جميل. كتابي ممتع مثل رحلة في الغابة. الخوف أحيانًا مثل غيمة، وسرعان ما تختفي!
حول الرسومات – نُلاحظ ونُفكّر: نتأمّل الرسومات في صفحات الكتاب ونقارن بين:
- الرسومات داخل الشجرة- (عندما كانت أنثى الغراب الصغيرة تعيش مع باقي الغربان).
- الرسومات عندما طارت خارجها (حين قرّرت الخروج واكتشاف العالم بنفسها).
ما الفرق بين الألوان داخل الشجرة وخارجها؟/ هل الألوان داخل الشجرة كانت قاتمة أو محدودة؟/ كيف كانت التفاصيل خارج الشجرة؟ هل كانت الألوان أكثر إشراقًا؟/ هل تغيّرت طريقة رسم الغراب الصغيرة؟ شكلها؟ نظرتها؟ حركتها؟/ برأيكم، ما المعنى من هذا التغيّر؟/ كيف عبّرت الرسومات عن الحريّة، الاكتشاف، أو الخروج من المألوف؟
نشجّع تلاميذنا الصغار على التواصل مع أفراد عائلتهم
نتواصل – مقابلة واكتشاف
نشجّع تلاميذنا الصغار على التواصل مع أفراد عائلتهم من خلال إجراء مقابلة بسيطة مع أفراد العائلة، فيها فضول ومحبّة، يطرحون فيها أسئلة، مثل:
- هل هناك شيء كنتَ تصدّقه عندما كنت صغيرًا، ثم اكتشفت لاحقًا أنّه غير صحيح؟
- معلومة ظنّوا أنها صحيحة/ قول سمعوه وصدّقوه/ شيء خافوا منه ثم تبيّن أنه لا يُخيف./ تجربة أثبتت لهم أن الواقع مختلف عمّا توقّعوا.
نلعب "بماذا أفكّر؟"
نلعب
نلعب “بماذا أفكّر؟” – نشاط تفكير ولغة في أزواج
نقسم الصفّ إلى أزواج من التلاميذ الصغار، في كلّ زوج:
أحدهما يضمر شيئًا في ذهنه (أرض، حيوان، مكان، شخصية)، والآخر يحاول اكتشاف هذا الشيء والتعرّف عليه، من خلال طرح أسئلة مغلقة جوابها فقط: نعم أو لا. نوجّه التلاميذ الصغار إلى صياغة الاسئلة التي تركّز على:
· صفات، هل هو كبير؟ هل لونه أحمر؟ هل هو ناعم؟
· استعمالات: هل نستخدمه في المدرسة؟ هل هو شيء نأكله؟
ومعايير أخرى تتعلّق بالشيء، نحو:
الفئة أو النوع: هل هو حيوان؟ هل هو شيء من الطبيعة؟
الموقع أو البيئة: هل نجده في البيت؟ في الخارج؟
المكتشفون الصغار
نكتشف ونتعلّم- المكتشفون الصغار- ننطلق مع التلاميذ الصغار في تجربة استكشاف حقيقيّة لما حولنا!
نراقب معًا أنواع الطيور المختلفة التي نراها من حولنا، في ساحة المدرسة، في الطريق، أو من نوافذ الصفّ.
ننظر جيّدًا إلى الطيور: شكلها، لون ريشها، حجمها، أصواتها.
نرسم ملاحظاتنا أو نصوّر الطيور إن أمكن.
ونستعين بموقع سلطة الطبيعة والحدائق لمعرفة أنواعها.
في الرابط التالي:
https://ar.parks.org.il/category/nature-school/
يمكننا جمع المعلومات في دفتر “ملاحظات المكتشف الصغير” ، أو تحضير معرض صور مصغّر للطيور التي تعرّفنا إليها.
لو كنت غرابًا ماذا سأرى؟
نبدع
لو كنت غرابًا ماذا سأرى؟
ندعو الأطفال إلى إطلاق خيالهم، ونتخيّل معًا:
نطلب من الأطفال: “تخيّلوا أنّكم طيورٌ تحلّقون عاليًا في السماء، مثل أنثى الغراب في القصّة… وتنظرون إلى العالم من الأعلى باتّجاه الأسفل”. فما الذي ترونه؟ وكيف تشعرون؟
نتحادث
حول القرصان والقبطان: نتساءل مع طفلنا: هل سلمان قبطان أم قرصان؟ ما الفرق بينهما؟ هل يمكن أن يكون الاثنان معًا؟
حول مرونة التفكير: نسأل طفلنا: هل حدث معك أن فهمت أمرًا بطريقتيْن مختلفتيْن؟ أو فسّره الآخرون بطريقة مختلفة؟
حول خبرات مشابهة: نسأل طفلنا: هل سبق وذهبت في رحلة أو خضت مغامرة اكتشفت فيها شيئًا جديدًا؟ أين وماذا اكتشفت؟
نثري لغتنا
نتعرّف على مفردات جديدة، مثل: صارية، قمرة، دزّينة، عصابة، كهرمان، وغيرها.
نبحث عن المفردات الموزونة في النصّ مثل: قرصان، قبطان، قمصان، سعدان، فرمان وغيرها. نتعرّف إلى معناها، ونبحث عن كلمات جديدة من نفس الوزن.
نبدع
نتنكّر بزيّ القراصنة ونرسم خريطة الكنز، ونقرصن معًا في رحلة بحث شائقة في أنحاء البيت وحوله!
نستكشف
الشخصيات: نبحث عن قصص شخصيّات بحريّة مشهورة، ممّن ذُكرت في النصّ، مثل: ماجلان، وأخرى لم تذكر، مثل: ابن بطوطة، خير الدين بربوس، السندباد. نتعرّف إلى الباحثة جين جودال، وشخصية طرزان الخياليّة.
الخريطة: نتمعّن في الخريطة أدناه ونتتبّع رحلة سفينة القرصان سلمان ونستكشف المدن التي زارها: من هم سكّانها؟ وما هو زيّهم التراثيّ، وطعامهم الشعبيّ؟ https://pjisrael.box.com/s/cnaselkv4l85f1cizx4jh1zruc0eojiu
نقرأ معًا
تتطرّق القصّة إلى مفهوم تعدّد التفسيرات ورؤية الأمور من وجهات نظر مختلفة، تمامًا كالشخصيّة المستوحاة منها -شخصيّة سلمان- نبحث عن حكاية القرصان فرانسيس دريك من العصور الوسطى؛ الذي كان قبطانًا وفارسًا في إنجلترا، بينما لُقّب بالقرصان في إسبانيا. هذه المهارة، تساعد الطفل على زيادة المرونة بتفكيره، وتطوير طرق تقييمه لما حوله.
إضافة إلى أنّ عالم القراصنة من المواضيع المثيرة للاهتمام عند الأطفال، فهو يجمع بين المغامرة والخيال والتاريخ. يمكن استغلال هذا الاهتمام لتعليمهم العديد من المفاهيم والمهارات، مثل التخطيط والبحث والاكتشاف.
نتحادث
حول استنتاجات من القصّة– ماذا تعرفون عن القراصنة؟ ما هي صفاتهم؟ هل سلمان كان قرصانًا أم قبطانًا؟ لنفكّر، نتحاور ونبرّر ما هو رأينا؟ كيف عرفتم الفرق بين القرصان والقبطان؟
حول تطوير مهارة ومرونة التفكير– هل حدث لكم أمر يمكن أن يحمل أكثر من تفسير؟ مثلًا؛ أنت فكّرت شيئًا وصديقك فكّر شيئًا آخر؟
نطلق العنان لخيالنا– ماذا لو خرجتم إلى مغامرة اكتشاف بالبحار البعيدة. تُرى مع مَنْ تسافرون وماذا سيحدث لكم وماذا ستكتشفون؟
نثري لغتنا
نُثري قاموسَنا اللغويّ- تزخر القصّة بمفردات جديدة من عالم البحار والقراصنة – يُمكننا أن نصنع قاموس عالم البحار والقراصنة، نتعرّف على كلمات جديدة ومعانيها.
نعزّز التعبير اللغويّ والوصف- ونتحدّث حول تجارب مشابهة؛ هل زرتم مرّة بلدًا أو مكانًا جديدًا؟ صفوا لنا المكان، سكّان البلد؟ طعامهم؟ صفاتهم؟
تحتوي القصّة على كلمات مسجوعة؛ نستخرجها من القصّة ونحاول إيجاد كلمات شبيهة من نفس الوزن.
نتأمّل الإعلانات المختلفة في القصّة، ونثري لغتنا وكتابتنا الإبداعيّة عن طريق الاستعانة بنشاط حول كتابة إعلان من وحي القصّة، كما مفصّل في موقع مكتبة الفانوس.
نتعرّف على كلمة “القرصبطان”، التي تدمج بأسلوب مميّز بين كلمة قرصان وقبطان – ونحاول أن ندمج كلمات أخرى من وحي خيالنا، مثل – ضخماصور وغيرها.
نبدع
نخطّط يوم اللباس كقراصنة– نشجّع الأطفال على ارتداء ملابس تشبه القراصنة: قبّعة سوداء، شريط عين، وربطة عنق حمراء. يمكنهم إحضار ألعابهم المفضّلة التي تشبه الكنوز أو الخرائط.
نتعرّف على الخريطة ونكتشف بلدان أخرى– نتتبّع مسار القرصان سلمان وطاقم سفينته، بالاستعانة بالنشاط المرفق في الموقع، ونتعرّف على البلدان المختلفة التي زارها في رحلته.
نخطّط ونرسم خريطة الكنز– نوزّع على الأطفال أوراقًا وأقلام تلوين. ونطلب منهم رسم خريطة لجزيرة خياليّة مليئة بالكنوز. يمكنهم استخدام رموز بسيطة للإشارة إلى الكنوز المدفونة، المخاطر، والمسارات.
نتخيّل ونبني سفينة قراصنة- نستخدم علب الكرتون الكبيرة لبناء سفينة، يمكن للأطفال تزيين السفن بالأعلام والأشرعة والصور.
نلعب
لعبة البحث عن الكنز- نختار مكانًا في الصفّ لإخفاء “الكنز” (يمكن أن يكون صندوقًا مليئًا بالألعاب الصغيرة)، نعدّ خريطة بسيطة للكنز ونوزّعها على الأطفال. يمكنهم العمل في مجموعات للعثور على الكنز باستخدام الخريطة.
نبحث
نتتبّع مسار السفينة في الخارطة، في نهاية الكتاب، ونبحث عن المدن الساحليّة التي زارها القرصان سلمان ونتعرّف عليها.
نبحث عن صور وقصص لقراصنة وبحّارة مشهورين مثل- خير الدين بربوس، السندباد، ونعرض صورًا لأساطيل، قراصنة وخرائط كنوز وأعلام، وغيرها من العناصر المرتبطة بهذا العالم الواسع.
نبحث عن معلومات حول الشخصيّات المتنوّعة التي ذكرت في القصّة، مثل- ماجلان، باب خان، جين جودال.
فعاليات حول الملاحة والخريطة والإعلان
تجدين هنا نشاطات مختلفة حول القصّة– حول الملاحة، الخريطة والإعلان:
الأهل الأعزّاء
الأهل الأعزّاء،
تُرى كيف سيتعامل طفلنا إذا ما نقصه شيء؟ هل سيحاول أن يحصّله بذاته؟ أم سيبتعد ويتنازل عن رغبته؟
صحيح أنّه ليس لدى كوكي، السلحفاة الصغيرة بطلة قصّتنا، قوقعة كبقية السلاحف، إلّا أنّ لديها خيالًا واسعًا، وثقة بالنفس وتصميمًا على حلّ مشكلتها، ومساندة من المجتمع المحيط بها؛ فبعد أن اكتشفت كوكي اختلافها عن رفيقاتها، شعرت بالغضب إلّا أنّها لم تيأس، بل استطاعت أن تصنع قوقعة لا مثيل لها، وتنطلق لاكتشاف المحيط الواسع. كلّ ذلك بفضل التعاون مع رفيقاتها، والبيئة الداعمة من حولها، وبفضل إبداعها وإصرارها.
تسلّط هذه القصّةُ الضوءَ على قدرتنا في تغيير حياتنا، إذا توفّرت لدينا الإرادة والمثابرة وحصلنا على المساندة. يكمن دورنا كأهل، أوّلًا، في تقبّل طفلنا ودعمه، وتعزيز الحسّ بالمقدرة لديه، ودفعه نحو الاستقلاليّة في التعامل مع المشكلات والعوائق المختلفة التي قد تواجهه؛ فينمو إنسانًا إيجابيًّا، مصمّمًا، ومبدعًا.
نناقش
- حول الغلاف- في اللّقاء الأوّل مع القصّة، وقبل قراءة عنوانها، يمكن أن تعرضي على الأطفال رسمة الغلاف، وأن تسأليهم حول موضوع القصّة وَفْقَ رأيهم. من هي كوكي؛ أيّ كائن حيّ يا ترى؟ وماذا يمكن أن يحدث معها؟
- حول فهم القصّة- ماذا حدث لكوكي؟ كيف شعرت أنّها لا تملك قوقعة؟ كيف تغلّبت على مشكلتها؟ ماذا فعلت رفيقاتها؟ وكيف ساعدنها؟
- حول الحفاظ على بيئة الشاطئ- يمكن أن تشكّل هذه القصّة نقطة انطلاق للحديث مع الأطفال حول الحفاظ على بيئة الشاطئ، من خلال السؤال: ماذا نرى في الرسومات؟ وكيف يؤثّر رمي المهملات على الشاطئ؟ ماذا فعلت الكائنات البحريّة وكيف نظّفت بيئتها؟ ونحن، ماذا يمكننا أن نفعل، عندما نزور الشاطئ، للحفاظ عليه؟
- حول مميّزاتنا الخاصّة- نستغلّ موضوع القصّة ونبادر للحديث عن موضوع الإتاحة والمساعدات المختلفة التي يمكن أن نراها في بيئتنا الصفّيّة أو في البيئة الخارجيّة. نقارن معًا حول المشترَك والمختلِف بيننا- كلّنا لدينا عيون وأيادٍ وشعر، لكنّ كلّ شخص هو مميّز ومختلف بصفاته وقدراته. إنّ الاختلاف جميل ويساعدنا أن نكمل بعضنا الآخر، وأن نحبّ بعضنا الآخر. ندعو إلى تقبّل الاختلافات فيما بيننا، ونقرّب للأطفال مفهوم استعمال الوسائل المتعدّدة لتساعد الآخرين مثل النظّارة أو سمّاعة الأذن، أو صور توضيحيّة وغيرها، تماما كما فعلت كوكي بصنع قوقعة خاصّة بها، كي تساعدها على السباحة في البحر وتحميها من الحيوانات المفترسة. نشجّع أطفال الروضة على البحث في بيئتهم عن إشارات للإتاحة، ونساعد الأطفال على فهم أنّ الاختلاف هو الطبيعيّ.
نثري لغتنا
- نثري قاموسنا اللغويّ- نتعرّف على كلمات جديدة ونقرّب معناها– لمحت، على مهل، على عجل، هشّة، دوّى.
- الوعي الصرفيّ- تعجّ القصّة بأفعال مؤنّثة- اقتربت، انقلبت، تدحرجت، تثاءبت. وأفعال مذكّرة مثل وصل، أفاق. نميّز بين الأفعال المؤنّثة والمذكّرة ونبحث لكلّ فعل عن صوره الصرفيّة المختلفة للمؤنّث والمذكّر.
- نثري قاموسنا الوصفيّ- نتعرّف كيف نصف ظواهر طبيعيّة مختلفة مثل – هدير الأمواج؛ كما ذكر في القصّة ونتعرّف على هبوب الريح، هطول المطر، ترى ماذا نستعمل للغيوم في السماء؟ أو الماء في الوادي؟
نبدع
- نصنع مجسّما صغيرا لبيئة الشاطئ، من خلال موادّ مختلفة كالورق المقوّى، رمال، أصداف، رسومات مختلفة. ثمّ نضيف مجسّمات أو نرسم كائنات يمكن أن نراها على الشاطئ. ونجمع المعلومات عنها.
- نستعمل تقنيّات الرسم بالألوان المائيّة بالملح ونبدع بلوحات متنوّعة، كما هو مفصّل عن طريق رسّامة القصّة بالفيديو، في موقع مكتبة الفانوس.
نتواصل
- يمكن أن نقوم بزيارة ميدانيّة إلى المتحف الطبيعيّ في تل أبيب أو معرض الكائنات البحريّة في القدس أو إيلات، ونتعرّف عن كثب على المخلوقات الحيّة المختلفة.
- ندعو باحث طبيعة ليعرض لنا معلومات عن الكائنات الحيّة المختلفة.
نكتشف
نسجّل لجولة مشاهدة تفقيس بيض السلاحف البحريّة، التي تقام كلّ صيف في شواطئ البلاد- يمكن التسجيل مسبقا في الرابط أدناه أو من خلال موقع سلطة الطبيعة والحدائق.
https://www.parks.org.il/article/form-sea-turtles/#Z
نتحاور
نَتَحاوَرُ
حول التعامل مع الاختلاف: نسأل طفلنا: بمَ كانت كوكي مختلفة عن صديقاتها؟ كيف شعرت؟ كيف وجدت حلًّا لمشكلتها؟
حول التعامل مع المشكلات: نسأل طفلنا إذا شعر مرّة أنّه مختلف أو واجه مشكلة بسبب ذلك الاختلاف. ماذا فعل؟ كيف تصرّف؟ هل سانده أحد؟ وكيف قام بذلك؟
نبدع
نُبدِعُ
- نصنع قوقعة من أغراض البيت، وننطلق معها بمغامرات مختلفة من نسج خيالنا، نسردها بكلماتنا وحركاتنا.
- نطلب من طفلنا أن يفكّر بطرق مختلفة لاستعمال أغراض متعدّدة – الملعقة، قطعة القماش، الكتاب، القلم، الصدف وغيرها…
نستكشف
نَسْتَكْشِفُ
نزور شاطئ البحر، نبحث عن الكائنات الحيّة في الشاطئ، مثل: السلاحف، سرطان البحر، الطحالب، الصدف وغيرها. يمكننا أن نجمع الصدف لنصنع منه قلادة أو إطارًا للصور.
نتواصل
نَتواصَلُ
يضمّ مجتمعُنا أشخاصًا مختلفين، يعاني جزء منهم من تحدّيات مختلفة كفقدان البصر، ومحدوديّة الحركة وما إلى ذلك. نخرج مع طفلنا في جولة في البلدة، ونبحث عن لافتات تشير إلى إتاحة المكان لأشخاص مع تحدّيات خاصّة. نصوّرها بكاميرا الهاتف ونتحدّث عنها، وعن أهمّيّة الإتاحة بشكل عامّ.
الأهل الأعزّاء
الأهل الأعزّاء،
بفضل روح المبادرة والانتماء والعمل التعاونيّ المشترك، نجح رافي وأصدقاؤه بمهمّة إنقاذ المكتبة من خطر الإغلاق، فامتلأت رفوفها بالكتب من جديد، وعاد لزيارتها الكبار والصغار من أهل البلد.
يكمن دورنا كأهل في تعزيز الحسّ بالمقدرة وتعميق الشعور بالانتماء والمسؤوليّة لدى الأطفال، وتحفيزهم على إسماع صوتهم، وأخذ دور فاعل في التأثير في قضايا تخصّ حياتهم وحياة مجتمعهم. من المهمّ أن نشجّع أطفالنا على السعي من أجل الصالح العامّ، ومساندتهم في التخطيط والتنفيذ، من أجل تطوير قدرتهم على حلّ المشكلات، والتعامل مع التحدّيات والصعوبات بدءًا من البيت، مرورًا بالحارة والبلد، ووصولًا إلى دوائر الحياة الأوسع. إنّ اشتباك الأطفال بالعمل المجتمعيّ، وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم، ينمّي لديهم حسّ الانتماء، والتعاطف، والمسؤوليّة، والمبادرة.
تهدف هذه القصّة أيضًا إلى تشجيع زيارة المكتبات العامّة وقراءة الكتب كمصدر للمتعة والمعرفة. لنا، كأهل، دور كبير في ذلك من خلال استنهاض ثقافة قراءة الكتب في بيتنا. علينا، إذًا، أن نبدأ من أنفسنا، إذ إنّ مشاهدة أطفالنا لنا ونحن نقرأ كتبنا المفضّلة هو أفضل تشجيع لهم ليُقبِلوا على الكتاب بمتعةٍ وشغف.
نتحاور حول...
- حلّ المشكلات: نسأل أطفالنا: ما هي المشكلة التي واجهتها الأرانب؟ كيف شعرت؟ كيف تصرّفت؟ وكيف استطاعت أن تحلّها؟ نقرأ ونتتبّع الرسومات ونتحدّث عمّا فعلته الأرانب.
- التكاتف والقدرة على التأثير: نتحادث مع طفلنا حول تحدّيات يواجهها في المدرسة أو في العائلة: ما مصدر هذا التحدّي؟ ماذا يشعر طفلنا، وكيف يمكن أن يتعامل معه؟ يمكننا أيضًا، أن نبحث عن مشاكل تعاني منها حارانا وبلدتنا، كمشكلة النفايات مثلًا، ونفكّر في دورنا كعائلة في معالجتها.
نثري لغتنا
المكتبة المتنوّعة: صنّفت أمينة المكتبة الكتب ووزّعتها في صناديق مختلفة وفقًا لمواضيعها وأنواعها: موسوعات، ألغاز، قصص الفضاء وغير ذلك. نتصفّح مكتبتنا البيتيّة، ونحاول أن نصنّف معًا كتبها وفق أصنافها الأدبية. نستعير كتبًا متنوّعة من المكتبة العامّة، ونكشف أطفالنا على أصناف أدبيّة غير قصصيّة، مثل: الحزازير، الشّعر، كتب الطبخ الفنون، وأخرى.
نتواصل
- زيارة المكتبة العامّة: نزور المكتبة العامّة، نتعرّف على أقسام المكتبة وأنواع الكتب المختلفة فيها، ونستعير كتابًا نحبّ أن نقرأه. يمكن للإخوة الكبار أن يقرأوا للصغار.
- نشاط مشترك: نخطّط مع الأصدقاء نشاطًا مشتركًا في الحارة، مثل: تزيين أو تنظيف الشارع، تعليق لافتات تحمل عبارات جميلة، وما شابه.
نبدع
- البحث عن الكنز: نرسم خريطة البيت، ونحدّد مسارًا على الخريطة لإيجاد الكنز. نلعب مع طفلنا، وفي كلّ مرة نرسم مسارًا مختلفًا للوصول إلى الكنز.
- الألوان المائيّة: استخدمت رسّامة القصّة الألوان المائيّة. يمكننا أن نصنع معًا هذه الألوان من موادّ متوفّرة في البيت مثل: عصارة الشمندر للّون الليلكيّ، عصارة الجزر للّون البرتقاليّ، عصارة البندورة أو الكتشوب للّون الأحمر. توفّر لنا البهارات، مثل الكركم، مصدرًا ممتازًا آخر لصنع الألوان.
نتحادث
نتحادث حول-
رأيهم في القصّة– كيف أنقذ الأرانبُ المكتبةَ حقًّا؟ ماذا فعلوا؟ هل كان تنينا سحريًّا؟
تجارب مشابهة– هل لديكم شيء تحبّونه وتريدون إنقاذه؟ ماذا يمكننا أن نفعل من أجله؟ هل سبق وحقّقت هدفًا قد رسمته لنفسك؟ ما هو وما الذي ساعدك على تحقيقه؟
مبادرات شبيهة– ما الأمور التي نحبّها ولا نحبّها في أجواء المدرسة- نقترح مبادرات؛ مثل- تزيين الصفّ، تخطيط وتجهيز مشروع فنّيّ لتزيين زاوية في المدرسة أو بناء زاوية للكتب المستعمَلة في المدرسة أو الحديقة العامّة.
نثري لغتنا
نثري لغتَنا–
نتصفّح الكتاب ونتعرّف على كلمات جديدة مثل- بهجة، بحزن وأسى، محبَطين، بوصلة وغيرها.
نزور مكتبة المدرسة ونتعرّف عليها وعلى مصطلحات جديدة مثل– أمينة المكتبة، استعارة الكتب، أنواع الكتب: الأدبيّة– رواية، ديوان شعر، كتاب فنون، كتب تحوي معلومات، وغيرها من مجموعات كتب في مواضيع علميّة مختلفة.
نتواصل
نتواصل-
نخلق روتينًا للقراءة– أن نتحدّث عن أهميّة القراءة شيء، وأن نقرأ ونشجّع القراءة وحبّ الكتب بطرق عمليّة شيء آخر. يمكننا أن نبني روتينًا صفّيًّا، كلّ يوم خميس نقوم بزيارة مكتبة المدرسة ونقوم بقراءة جماعيّة او بأزواج، ثمّ نقوم باستعارة القصص من المكتبة.
نادي القرّاء– من الممكن لكلّ طالب أن يحضر كتبًا؛ يريد إعارتها لطلّاب صفّه، ونتبادل الكتب المستعمَلة بيننها ثمّ نعيدها. من المحبّذ الابتعاد عن مسابقات القراءة؛ لأنّها على الأغلب تقلّل من إمكانيّة الاستمتاع بسحر القراءة وتجعل الطفل يركّز على القراءة بغية المنافسة والفوز.
نبدع
نبدع-
نؤلّف كتابَنا التصويريّ الأوّل– وهو عبارة عن رسومات وصور مختلفة، نُضيف إلى جانبها كتابة قصيرة لنحصل على قصّة أو كتاب فنّيّ.
نتحاور
نتحادث
ننمّي خيال طفلنا ونبتكر نهاية أخرى للقصّة أو نكملها بأنفسنا، يمكن أن نسأل الطفل: ماذا برأيك حدث لآكل النمل؟ هل أحبّ طعم الموز؟ هل هو يأكل الموز حقًا؟ أين اختفت النملات؟ ماذا حدث برأيك بعد ذلك؟
نتواصل
نتواصل
نُقيم حفلة نكات عائليّة. كلّ فرد من العائلة مدعوّ لمشاركة طرفته المفضّلة والملائمة لمستوى الطفل.
نكتشف
نكتشف
نبحث عن معلومات حول أنواع الحيوانات المذكورة بالقصّة. أين يعيش كلّ حيوان؟ ماذا يأكل حقًّا؟ ما هي بيئته المفضّلة؟
نبدع
نبدع
- نقترح على طفلنا ابتكار لوحة مبنيّة من دمج ألوان مختلفة. يمكن استعمال الألوان الشمعيّة وطلائها على الورق واستعمال الألوان المائيّة.
- نقترح على طفلنا تأليف كتابه الفكاهيّ الأوّل أو نسخته الخاصّة من “ماذا يأكل آكل النمل”. يمكن إضافة حيوانات مختلفة وإنهاء القصّة بطريقة إبداعيّة من اختيار الطفل.
نتمعن
يسير النمل على طول الجزء السفليّ من معظم صفحات الكتاب، بينما يمشي آكل النمل عبر المناظر الطبيعيّة في الغابة بحثًا عن وجبة إفطار تحت قدميه. نتتبّع الرسومات ونبحث عن النملات ولا ننسى أن نضحك طول الطريق!
نقرأ معًا
المربّية العزيزة؛
تدعونا هذه القصّة الفكاهيّة، بأسلوبها السلس والمُحبِّب، إلى تطوير مهارة التفكير النقديّ لدى الأطفال وفهمهم للتناقض الكامن في الكلام؛ ما يساعدهم على إدراك الرسائل الاجتماعيّة وبلورة الرأي المستقلّ وتطوير العلاقات بشكل أعمق. تنعكس هذه المهارات في القصّة من خلال المقدرة على فهم النكات والمزاح، الأمر الذي يتطلّب تحديد التناقضات في أحداث القصّة وإدراك الكلام ما بين السطور- فآكل النمل نسي ماذا يأكل، والأفعى لا تقدر على البلع والكسلان مشغول!
كذلك، تحثّ هذه القصّة الطفل على التجربة والتواصل والحوار مع الآخرين، كي يتعرّف على نفسه أكثر ويعرف ما يحبّ وما يكره، وكي يحظى بالانكشاف على مغامرات مختلفة، أصدقاء جدد، أطعمة مختلفة والكثير من الفكاهة والضحك.
نتحادث
نتحادث
ننمّي خيال الأطفال ونبتكر نهاية أخرى للقصّة أو نكملها بأنفسنا، يمكن أن نسأل الأطفال: ماذا برأيكم حدث لآكل النمل؟ هل أحبّ طعم الموز؟ هل يأكل الموز حقًّا؟ أيّ أنواع من الطعام يفضّل برأيكم؟ أين اختفت النملات؟ ماذا حدث برأيكم بعد ذلك؟
نتواصل
نتواصل
كان آكل النمل لطيفا عندما تحدّث مع الحيوانات المختلفة واستعمل عبارات مثلا- آسف على إزعاجك، حظًّا طيّبا، شكرا، لو سمحت إلخ.. يمكن استعمال القصّة في تعلّم آداب التواصل مع الأصدقاء وممارسة هذه العبارات اللطيفة.
نبدع
نبدع
عن طريق ضمّ عدّة أوراق وثنيها معًا إلى النصف، لنحصل على كتاب فارغ فيؤلّف به كلّ طفل كتابه الفكاهيّ الأوّل أو حتّى نكتب نسختنا الخاصّة من كتاب “ماذا يأكل آكل النمل”.
نثري لغتنا
نثري لغتنا
نُعدّ لعبة حزازير من وحي الكتاب، نُعدّ بطاقات لحيوانات وأغراض وفاكهة مختلفة؛ حيث يأخذ كلّ طفل بدوره بطاقة ويخبّئها، فيقوم الأطفال بصياغة أسئلة للطفل ليجمعوا المعلومات ويتعرّفوا على ما في البطاقة. ترافقهم المربّية في صياغة الأسئلة وفقا للمعايير المختلفة، فمثلا: هل هو من مجموعة الحيوانات؟ ماذا يأكل؟ أين يعيش؟…
نمثّل
نمثّل
نوزّع الأدوار المختلفة على أطفال الصفّ، نمثّل أحداث القصّة بعد أن نعطي صوتا مختلفا لكلّ حيوان، مع الانتباه إلى الحالة الشعوريّة وتقمّصها قدر الإمكان. فمثلا: آكل النمل حائر، الكسلان تعبان وقليل الهمّة، الثعبان يشعر بصعوبة، النمر جائع ومكّار.
نستكشف
نستكشف ونتعلّم
نجمع معلومات عن آكل النمل والحيوانات المختلفة في القصّة. أين يعيش؟ ماذا يأكل حقًّا؟ وكم نملة يمكن أن يأكل في اليوم؟ ما هي بيئته المفضّلة؟
حول الكتاب
يستخدمُ المتجوّلون في القصّة حجرًا لإقناع سكّان القرية على التعاون معهم ومشاركتهم طعامهم. لكنّ التعاون ليس سهلًا على الجميع؛ فهناك المتحمّس، وهناك المتشكّك والمعارض؛ إلّا أنّ حيلة ودراية القائدة جعلتا أهل القرية يتعاونون واحدًا تلو الآخر، إلى أن حصلوا على حَساء لذيذ يكفيهم جميعًا.
تسلّط هذه الحكاية الشعبيّة الضوء على أهمّيّة المشاركة والعمل سويًّا، فحتّى الجهود الصغيرة يمكنها أن تؤدّي إلى نتائج مفيدة للجميع. من المهمّ أن نعزّز قيمة التعاون لدى الأطفال منذ بواكير العمر، من خلال الألعاب والأنشطة الجماعيّة، إذ يساهم التعاون في تقوية العلاقات وتطوير المهارات الاجتماعيّة؛ مثل مهارات التواصل وحلّ المشكلات، وطرق التعبير عن الأفكار والمشاعر والإصغاء إلى آراء الآخرين وتفهّم مواقفهم. كذلك، يساهم التعاون في بناء ثقة الأطفال بأنفسهم وفي تعزيز شعورهم بالانتماء إلى البستان.
هذه القصة هي فرصة ذهبيّة لتذويت قيمة التعاون في الصف، كيف؟ على سبيل المثال؛ نشجّع الأطفال على مشاركة الألعاب مع بعضهم البعض، نخطّط لأنشطه جماعيّة نوزّع فيها المهامّ بينهم ونشجّعهم على العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.
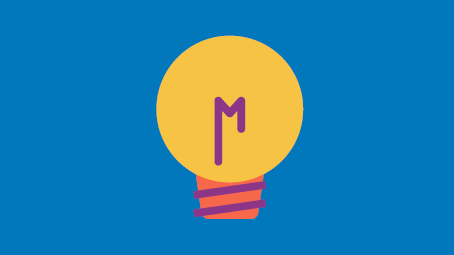
نتحاور
نسأل أطفالنا أسئلة تحفّز التفكير، نحو:
- ما الذي جعل الحساء لذيذًا حقًّا؟ هل تظنّون أنّه كان يمكن للحساء أن يكون لذيذًا دون مساهمة أهل القرية؟
- لماذا كان أهل القرية متردّدين بالمشاركة في البداية؟ كيف تغلّبت القائدة على هذا التردّد؟
- كيف فكّر كلٌّ من الحيوانات في القرية؟ وماذا كان موقفهم قبل الحيلة وبعدها؟
نثري لغتنا
نثري لغتنا
نعدّ حساء خضراوات بمشاركة طفلنا. نتحدّث عن أنواع الخضراوات في الحساء ونستعمل أفعالًا تدلّ على الأعمال التي نقوم بها خلال إعداد الطعام: نغسل، نقشّر، نقسّم، نبرش، نعصر، نرشّ، ننخّل، نخلط، وغيرها.
نبدع
نبدع
نجمع حجارةً ملساء بأحجامٍ مختلفة، نلوّنها أو نكتب عليها، ونزيّن بها فناء أو حديقة بيتنا.
نبحث
نبحث
نبحث بمكتبة بيتنا عن قصص شعبيّة شبيهة أعيدت صياغتها من مكتبة “الفانوس” وغيرها، مثل: الحطّاب، الأصّيص الفارغ، الخالة زركشات تبيع القبّعّات وغيرها.
نتحاور
نتحاور
- حول الحبكة: نتتبّع مع أطفالنا الكتاب برسوماته المتسلسلة، ونُغني القدرة السرديّة لديهم من خلال وصف الأحداث بشكل متسلسل.
- حول الحيلة: تستخدم القائدة الحيلة لتشجيع أهل القرية على التعاون والمشاركة. يمكنك مساعدة الأطفال على فهم الحيلة من خلال الحوار حول أفكار ومشاعر أهل القرية. نسألهم مثلًا: كيف فكّر كلٌّ من الحيوانات في القرية؟ وماذا كان موقفهم ومشاعرهم قبل الحيلة وبعدها؟
- حول قيمة التعاون: ما الذي جعل الحساء لذيذًا حقًّا؟ هل تظنّون أنّه كان يمكن للحساء أن يكون لذيذًا دون مساهمة أهل القرية؟ شجّعوا الأطفال في التعبير عن مواقف تعاونوا بها مع أحد في البيت أو الروضة.
نتعاون
نتعاون
نتعاون معًا ونصنع وجبة مشتركة، نرافقها بالوصف والحوار. نقسّم المهامّ بين أطفال الصفّ، وندعوهم لإحضار كمّيّات صغيرة من الخضراوات أو المكوّنات الأخرى. يعزّز هذا النشاط المشاركة والتعاون ويكسب الأطفال مهارات العمل التعاونيّ، كما يتيح لهم ممارسة مهارات الطهي الأساسيّة.
نبدع
نبدع
نجمع، نلوّن ونكتب على حجارة بأحجام وألوان مختلفة، ونزيّن فناء البستان بزاوية فسيفساء من حجارة ملوّنة.
نستكشف
نستكشف
شخصيّات القصة متنوّعة، فهي من فئات مختلفة من الكائنات الحيّة. نبحث في الموسوعة ومحرّكات البحث ونتعرّف على صفاتها ومزاياها، نصنّفها لمجموعات، ونعدّ كتيّبا ونضيف أفرادًا جددًا لكلّ فئة مع معلومات حولها.
نشارك الأهل
نشارك الأهل
نُعدّ كتاب الطهي الصفيّ، نشجع الأطفال على إعداد حساء في البيت، وندوّن الوصفة مع الأهل. نجمع وصفاتٍ مختلفةً لأنواع حساء من اقتراحات أطفال البستان وننتج كتابًا للطهي في صفّنا ونوزّعه على الجميع.
نثري لغتنا
نثري لغتنا
نعدّ حساء خضراوات بمشاركة الأطفال. نتحدّث عن أنواع الخضراوات في الحساء ونستعمل أفعالًا تدلّ إلى الأعمال التي نقوم بها خلال إعداد الطعام: نغسل، نقشّر، نقسّم، نبرش، نعصر، نرشّ، ننخّل، نخلط إلخ.
نبحث ونلعب
نبحث ونلعب
نبحث في مكتبتنا الصفّيّة عن قصص شعبيّة شبيهة، أعيدت صياغتها، من مكتبة “الفانوس” مثل الحطّاب، الأصّيص الفارغ، الخالة زركشات تبيع القبّعّات وغيرها. نشارك الأطفال أيضًا بألعاب شعبيّة لعبناها في طفولتنا ونلعب معًا.
نمسرح
نمسرح
لعبة الأدوار- نقسّم الأطفال إلى مجموعات لأداء أدوار مختلفة من القصّة. يمكن أن تكون مجموعة واحدة “المسافرين”، ومجموعة أخرى “أهل القرية”، وهكذا. نشجّعهم على التخيّل وإضافة لمساتهم الخاصّة إلى القصّة.
نتحاور
نتحاور:
حول شخصيّات القصّة: نقارن بين صفات التاجر والنمر، الثور والأرنبة. نستنتج من خلال سلوك الشخصيّة ما يميّزها من صفات.
مفهوم العدل: هل الخير يعود علينا دائمًا بالخير؟ سؤالٌ طرحته الشخصيّأت، وقد نظنّ لوهلةٍ أنّ عمل الخير الذي قدّمه التاجر كان سيجلب له كارثةً من النمّر، لكن ذكاء الأرنبة أظهر لنا نتيجةً أخرى. ماذا نستنتج؟
الثقة والحذر: كلمات مجرّدة يمكن التعبير عنها بمشاعر وأفكار وسلوكات. نستذكر أشخاصًا نثق بهم كثيرًا. ممّن علينا أن نحذر؟ من المهمّ الانتباه إلى عدم تخويف الأطفال وإثارة هلعهم، فها هي الأرنبة بذكائها ساعدت التاجر وأنقذته. كيف يمكن أن نوازن بين تقديم المساعدة والحذر من ذوي النوايا السيّئة؟
خبرات من حياتنا: هل فعلنا خيرًا وقدّمنا مساعدةً لأحدهم؟ بماذا شعرنا؟ نستذكر تجارب من حياتنا تلقّينا فيها مساعدةً أو قدّمناها.
نُثري لغتنا
نُثري لغتنا:
كلمات ومفردات جديدة: نتعرّف على الكلمات الغريبة، ونوضح معانيها.
علامات الترقيم: نلاحظ إشارات الاستفهام/ التعجّب/ الاقتباس. ماذا نعني بها؟
أمثال وحكَم: نبحث عن أمثال وحكم ومواعظ تتحدّث عن عمل الخير/ عن العدل/ عن الحذر والحيطة وغيرها من المعاني التي تستوقفنا.
نبدع
نبدع:
اللعب التمثيليّ: يؤدّي كلّ منا دور إحدى شخصيّات القصّة. نفكّر في موقفها ومشاعرها. نتحاور حول تعابير الوجه والجسد، ومدى تعبيرها عن النوايا الحقيقيّة.
لعبة المحكمة: نختار مواقف من حياتنا اليوميّة، ويؤدّي كلٌّ منّا دورًا في الدفاع عن موقف مختلف. مَن منّا القاضي/ المتّهم/ المحامي؟ مَن منّا يؤيّد شخصيّةً أخرى؟
نستكشف
نستكشف:
كوريا: يعرّفنا الكتاب على نموذجٍ من الأدب الكوريّ. تعالوا نستكشف هذا البلد: أين يقع؟ بماذا يتميّز؟ هل نعرف آدابًا وفنونًا أخرى منه؟ نتعرّف على ثقافته ومزاياه.
التكافل في الطبيعة: تنبّهنا الشجرة في القصّة إلى مبدأ مهمّ في تبادل الخيرات. نبحث عن ظواهر طبيعيّة من التكافل وتبادل العون والمساعدة. (النحلة والوردة مثلًا).
نلعب ونستمتع
لعبة النظّارة: نقترح على الأطفال تخيُّل نظّارتين (قد نعدّ نموذجًا لهما)، إحداهما ورديّة والأخرى سوداء. إذا ارتدينا النظارة الورديّة نذكر مواقف إيجابيّةً محبَّبةً من الخير والعدل، ومع النظارة السوداء نستذكر مواقف سلبيّة وغير مرغوبة. ثمّ نرتديهما مع القصّة، ونلاحظ أيّ المواقف أو المشاهد في القصّة يمكن أن نراها بالنظارة الورديّة مثلًا: (مساعدة التاجر للنمر/ موقف الشجرة/ إنقاذ الأرنبة للتاجر)، وأيّها تتبع النظارة السوداء (كموقف النمر من التاجر).
نتحاور
شخصيّات القصّة: نقارن بين صفات التاجر والنمر، الثور والأرنبة. نستنتج من خلال سلوك الشخصيّة ما يميّزها.
مفهوم العدل والإنصاف: هل الخير يعود علينا دائمًا بالخير؟ قد نظنّ لوهلةٍ أنّ عمل الخير الذي قدّمه التاجر كان سيجلب له كارثةً من النمّر، لكن ذكاء الأرنبة أظهر لنا نتيجةً أخرى. ماذا نستنتج؟
الثقة: كلمة مجرّدة يمكن التعبير عنها بمشاعر وأفكار وسلوكيات. نستذكر أشخاصًا نثق بهم كثيرًا. كيف تولّدت تلك الثقة لدينا؟
خبرات من حياتنا: هل فعلنا خيرًا وقدّمنا مساعدةً لأحدهم؟ نستذكر تجارب من حياتنا تلقّينا فيها مساعدةً أو قدّمناها.
نُثري لغتنا
كلمات ومفردات جديدة: نتعرّف على الكلمات الغريبة، ونوضح معانيها.
علامات الترقيم: نلاحظ إشارات الاستفهام/ التعجّب/ الاقتباس. ماذا نعني بها؟
أمثال وحكَم: نبحث عن أمثال وحكم ومواعظ تتحدّث عن عمل الخير/ العدل/ الحذر والحيطة، وغيرها من المعاني التي تستوقفنا.
نُبدع
اللعب التمثيليّ: يؤدّي كلّ منا دور إحدى شخصيّات القصّة. نفكّر في موقفها ومشاعرها وتعابيرها.
لعبة المحكمة: نختار مواقف من حياتنا اليوميّة، ويؤدّي كلٌّ منّا دورًا في الدفاع عن موقف مختلف. مَن منّا القاضي/ المتّهم/ المحامي؟ مَن منّا يؤيّد شخصيّةً أخرى؟
نستكشف
الطبيعة: نخرج في نزهةٍ إلى الطبيعة القريبة. أيّ الأشجار نلاحظ؟ أيّ حيواناتٍ قد نلتقي؟ نصوّر مناظر طبيعيّةً ونجمعها في ذكرى نزهتنا الممتعة معًا.
الحيوانات حولنا: هل في حارتنا حيواناتٌ أليفةٌ تبحث عن مأوى أو طعام؟ كيف يمكن أن نساعدها بطريقةٍ آمنة؟ (قد نحضّر صندوقًا لطعام القطط أو حوضًا لإطعام الطيور).
نتحاور
حول حلّ المشكلات: عرض الملك على أبنائه تحدّيًا ليقرّر من سيخلفه بالحكم. نتتبّع الرسومات مع طفلنا، ونسأله: ما هو الحلّ الذي اقترحه كلّ واحد من الأمراء؟ نصفه معًا ونتحدّث عن إيجابيّات وسلبيّات كلّ واحد من الحلول.
حول المشاعر والرغبات وأفكار الشخصيّات: نتحادث مع طفلنا عن الأحداث المختلفة. نسأل مثلًا: ماذا أراد الملك حين مرض؟ ماذا أراد الأمراء؟ ماذا شعر الملك حيال كلّ حلّ، وبماذا فكّر؟
حول الحكمة: قد نسأل طفلنا مثلًا: ماذا قصدت الأميرة عندما قالت: “يجب أن أتروّى وأفكر بكلّ الاحتمالات وأختار الأفضل منها”؟ من برأيك الإنسان الحكيم؟ لماذا؟ هل فكّر الأميران بكلّ الاحتمالات؟ ما هو الجانب الذي لم يفكّرا به؟
حول العدل: نتحادث حول مفهوم العدل ونيسّر لطفلنا فهمه. قد نقول: رفض الملك الحكيم حلول الأميرين لأنّها لم تكن عادلة، أي لأنّها أضرّت بالناس والحيوانات. نسأله: ماذا كان الضرر من كلّ حلّ؟ لماذا كان حلّ الأميرة عادلًا؟ هل حدث أن قرّرت شيئا أسعدك، لكنّه أضرّ بغيرك؛ كأن تأخذ جميع قطع الحلوى ولا تترك لغيرك قطعة؟
حول صفات ومميّزات الشخصيّات: نتحادث عن صفات الإخوة الثلاثة- الأميرين والاميرة- وكيف ظهرت في سلوكيّاتهم؛ كأن نقول إنّ الأميرة تروّت وفكّرت، وبعد ذلك اتخذت القرار الأفضل. نسأل الطفل: ما هي الصفات التي تميّزك، وكيف تظهر في سلوكك؟
نبدع ونتخيّل
نتحدّى أطفالنا ليطوّروا خيالهم وتفكيرهم العلميّ فنسألهم: بماذا يمكن ان نملأ الغرفة أيضًا؟
نُثْري لغتنا
الحكاية غنيّة بالمفردات اللغويّة الجميلة والجديدة (وادعة، تدهورت، أتروّى، هانئة، مضاءة)، نفسّرها لأطفالنا أثناء القراءة، ونحاول أن نستخدمها في سياق حياتنا اليوميّة.
نتمتّع
استخدمت الرسّامة عناصر بصريّة من ثقافاتٍ شرقيّة مختلفة. نحاول أن نخمّن مكان الحكاية وزمنها بالاستعانة بهذه العناصر.
نتحاور حول
• أين ومتى: تحدث القصة في زمان ومكان غير معروفين. نتحدّث مع الأطفال حول هذه المُركّبات، فنسألهم عن المكان: حسب رأيكم، أين حدثت هذه القصّة؟ لماذا تعتقدون ذلك؟
ونسألهم كذلك عن زمان القصّة: هل هو في الماضي، أم الحاضر، ام المستقبل؟ أو في الصّباح أو في اللّيل؟ لماذا تعتقدون ذلك؟
• مشاعر الملك: ملأت الطّفلة القاعة بالناس الذين جاءوا ليتمنّوا الشّفاء للملك. كيف شعر الملك حينها؟ لماذا شعر بذلك؟ هل شعرت مرّة بمثل هذه المشاعر؟
• الحكم الملكي: في الحكاية، الملك هو الذي يحكم الناس، ويتوّلى أحد أبنائه الحكم من بعده. نتحدّث مع الأطفال حول الحكم الملكيّ ونستمع إلى آرائهم وأفكارهم حوله. هل كنتم تودون أن تعيشوا في مكان كهذا تحت حكم الملك؟ لماذا؟
• العنوان: نكرّر قراءة الكتاب ونقترح عنوانًا آخر للقصّة.
نتواصل
نبادر لاستضافة الجدّ أو الجدّة في البستان ليسردوا لنا الحكايات الشّعبية أو حكايات من الماضي الجميل.
نستكشف
أبدت الطفلة حكمة كبيرة وذكيّة في إنارة القاعة الكبيرة. نبحث عبر المصادر المعلوماتيّة عن شخصيّات عالميّة لفتيات تركن بصمة طلائعيّة في العالم نحو: زها حديد.
نبدع
نتقمّص الشّخصيّات ونمثّل: يتمتّع الاطفال بمسرحة القصة. نوزّع الأدوار مستخدمين تجسيدات مختلفة لشخصيات القصة يصمّمها الأطفال بأنفسهم. دمى أصابع/كف عصي مصنوعة من خردة وقماش، ريش وأزرار وغيرها.
ساعة قصة
نتحادث
- • الرغبات والأمنيات: رغب جبل أن يرى الشمس، ولكنّه لم يستطع ذلك. نتحادث مع طفلنا عن الأمور التي يرغب بها ويتمنّاها: أيّ الأمور بإمكانه الحصول عليها، وأيّها يصعب عليه الحصول عليها؟ ما هو شعوره؟ نفكر ونقترح طرقًا مختلفة لتحقيق الرغبات.
- • المشاعر: نتتبّع الرسومات برفقة أطفالنا، ونتحدّث عن المشاعر المتعدّدة لدى جبل وأصدقائه، فنسمّيها ونسأل الأطفال عن أسبابها، نحو: مشاعر الإحباط عندما لم يستطع أن يرى الشمس؛ الشعور بالحماسة؛ التعاطف من قبل الأصدقاء. نقرن بين المشاعر وتأثيرها على السلوك.
- • حلّ المشكلات: حاول الأصدقاء التعامل مع مشكلة جبل بواسطة اقتراح عدّة حلول. نتحدّث برفقة أطفالنا عن الحلول التي اقترحها الأصدقاء، ونقترح حلولًا أخرى لم يقترحوها. نمرّن أطفالنا على التفكير المرن الإبداعيّ والمتشعّب.
• المساعدة والتعاون: تعاطَفَ الأصدقاء مع جبل، وحاولوا تحقيق رغبته في رؤية الشمس. نسأل أطفالنا: هل ساندك أحد في الحصول على شيء ترغبه؟ ثمّ نسأله: من ساندك؟ وكيف كان شعورك؟
نلعب ونتخيّل
نختار غرضًا ونفكّر خارج الصندوق، ونقترح له استعمالات عديدة غير الاستعمال التقليديّ المعروف.
نمثّل ونبتكر
نمرّن أطفالنا على التفكير المرن، وذلك من خلال اقتراح قضايا ومشكلات تواجه طفلنا في الحياة اليوميّة، والبحث عن الكثير من الحلول، وتمثيلها.
نتحاور حول
• الرغبات والأمنيات: رغب جبل أن يرى الشمس، ولكنّه لم يستطع ذلك. نتحادث مع الأطفال عن الأمور التي يرغبون بها ويتمنونها: أيّ الأمور بإمكانه الحصول عليها، وأيّها يصعب عليه الحصول عليها؟ ما هو شعوره؟ نفكر ونقترح طرقًا مختلفة لتحقيق الرغبات.
• المشاعر: نتتبّع الرسومات برفقة الأطفال، ونتحدّث عن المشاعر المتعدّدة لدى جبل وأصدقائه، فنسمّيها ونسأل الأطفال عن أسبابها، نحو: مشاعر الإحباط عندما لم يستطع أن يرى الشمس؛ الشعور بالحماسة؛ التعاطف من قبل الأصدقاء. نقرن بين المشاعر وتأثيرها على السلوك.
• حلّ المشكلات: حاول الأصدقاء التعامل مع مشكلة جبل بواسطة اقتراح عدّة حلول. نتحدّث برفقة الأطفال عن الحلول التي اقترحها الأصدقاء، ونقترح حلولًا أخرى لم يقترحوها. ندعو الأطفال لمشاركتنا تحدّيات وصعوبات واجهتهم في الصفّ والساحة، أو في البيت والحارّة، كيف تخطّوها ومن ساندهم في ذلك. نمرّن الأطفال على التفكير المرن الإبداعيّ والمتشعّب.
• المساعدة والتعاون: تعاطَفَ الأصدقاء مع جبل، وحاولوا تحقيق رغبته في رؤية الشمس. نسأل الأطفال: هل ساندك أحد في الحصول على شيء ترغبه؟ ثمّ نسأله: من ساندك؟ وكيف كان شعورك؟
نتواصل
قد لا يتمكّن الأطفال أحيانًا من اكتساب مهارة حلّ المشكلات بمفردهم. لذا، نُساندهم ونتدرّب معا على خطوات عمليّة لتعلّم مهارة حل المشكلات:
نحدّد المشكلة بوضوح. نسأل الطفل: ما هي المشكلة؟ ونساعده على قولها بصوت مسموع. مثلًا: “مشكلتي هي أنّ صديقي لا يريد أن يلعب معي”. نقترح أكثر من حلّ، ونفكّر بالحلول المتعدّدة والمختلفة للمشكلة. نفسح المجال أمام الطفل ليجرّب الحلّ، ونتحدّث معًا حول هذه التجربة.
نثري لغتنا
ندعو الأطفال ليشاركونا ويصفوا لنا تجارب مشابهة ساعدوا خلالها الأصدقاء في الساحة. نسألهم، مثلًا: كيف شعرتم عندما قدّمتم المساعدة؟ هل ستقدّمون المساعدة في مرّات قادمة أيضًا؟ لماذا؟
نُبدع
نصنع بيئة طبيعيّة جبليّة خاصّة لكلّ طفل. نُعيد استعمال العلب الكرتونيّة وندعو الأطفال لإحضارها إلى الصفّ. نوفّر مجسّمات لكائنات حيّة ومواد طبيعيّة؛ كالرّمل والحصى والحجارة. يصمّم ويصنع كلّ طفل عالمه الصغير للّعب والمحاكاة.
ساعة قصة
نشاط مع الأهل
- يمكن أن نسترجع مع طفلنا ما قام به كلّ من الغراب، والسلحفاة، والفأر لإنقاذ الغزال من شبكة الصّيّاد. هل كان يمكن أن يتحرّر الغزال من الشّبكة لو لم يتعاونوا معًا؟
- نستذكر مع طفلنا حدثًا في عائلتنا أو في حارتنا، تعاون فيه الجميع لمساعدة أحد أفراد العائلة/الجيران. ماذا فعل كلّ واحدٍ منهم؟ وماذا فعل طفلنا؟ هذه مناسبة للتّحادث عن أهميّة دور كلّ فردٍ، حتّى لو كان صغيرًا، وكانت مساهمته متواضعة.
- صيد الغزال ممنوعٌ في بلادنا، والغزال حيوانٌ مهدّد بالانقراض. هذه فرصة للحديث مع الطّفل حول ظاهرة صيد الحيوانات البرّيّة. لماذا يريد البعض اصطيادها؟ قد نرغب بإجراء مشروع بحثيّ صغير مع طفلنا حول الحيوانات الممنوع صيدها في بلادنا، وفي العالم بسبب خطر انقراضها.
- تبدأ القصّة برسمة الأصدقاء وهم يلعبون معًا لعبة الشّطرنج، والشّطرنج من ألعاب الطّاولة. قد تشجّعنا الرّسمة على اللّعب مع طفلنا بإحدى ألعاب الطّاولة الّتي يحبّها…
- الفأر وأصدقاؤه الثّلاثة في مسرحيّة! يمكننا أن نرسم أو أن نبحث عن أقنعة وجوه الحيوانات الأربعة، ونمثّل القصّة. مَن سيقوم بدور الصّيّاد؟
-
تُرى، ماذا سيحدث مع الأصدقاء الأربعة في اليوم التّالي؟ نشجّع طفلنا على تخيّل أحداث قصّة جديدة، وقد نرغب بكتابتها. مَن يدري، فربّما وجدت طريقها يومًا إلى النّشر!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
-
- تحادثي مع الأطفال حول رسمة الغلاف: أيّ حيواناتٍ نرى، وماذا يدلّنا على أنّ الأربعة أصدقاء؟ ادعي الأطفال لتأمّل زيّ الغراب، من يلبس هذه القبّعة وربطة العنق عادةً؟
- في حبكة القصّة العديد من المواقف الدّراميّة الّتي تتطلّب منك أسلوب سردٍ مشوّق للأطفال، باستخدام نبرات صوتٍ مختلفة. نقترح عليك أن تتدرّبي على قراءة القصّة قبل سردها على الأطفال لتضمني سردًا شيّقًا يجذب أسماعهم.
-
- يستخدم الأصدقاء الحيلة لإنقاذ صديقهم. يمكنك أن تساعدي الأطفال في فهم معنى الحيلة من خلال الحديث معهم حول أفكار الصّياد حين رأى الشّبكة مقروضة مثلًا، أو حين رأى الغزال ممدّدًا على الأرض.
- شجّعي الأطفال على الحديث عن مواقف ساعدوا بها صديقًا في الرّوضة أو خارجها.
- ينجح الأصدقاء في الهروب من الصّياد بفضل تخطيطهم، وتقسيم المهامّ بينهم. تأمّلي مع الأطفال الخريطة الّتي رسمتها السّلحفاة في ص 10: ماذا نفهم منها؟ استذكري مع الأطفال مشروعًا جماعيًّا قمتم به في الرّوضة (مثل زراعة أحواض، أو بناء مجسّم كبير، وغيرهما) ماذا كان دور كلّ طفل؟
-
- هذه إحدى القصص الملائمة للمسرحة لغنى أحداثها، والحوارات بين الشّخصيات. يساعد تمثيل الأدوار الطّفل في فهم مشاعر الشّخصيات، ودوافع سلوكها.
- هل نحبّ أن نعرف أكثر عن الفأر، والغزال، والسّلحفاة، والغراب؟ يمكن أن نشرك الأهل في جمع المعلومات وعرضها.
- في النّصّ ذكرٌ لصوت الفأر (تس تس)، وصوت الغراب (قاق قاق). ترى كيف تُسمع أصوات حيواناتٍ أخرى يعرفها الأطفال؟
- اهتمّت الرّسامة برسم أشجارٍ تتميّز بها طبيعة بلادنا، مثل شجرتَيْ السّنديان، والرّمان. أيّ أشجار أخرى نعرفها في حدائقنا؟ من الممتع الخروج مع الأطفال في هذا الفصل إلى منطقة طبيعيّة قريبة والتّعرّف على أنواع أخرى، مثل: البطم، والكينا، وغيرها.
- العديد من الحيوانات في العالم مهدّدة بالانقراض نتيجة لكثرة صيدها، والغزلان أحدها. هذه مناسبة للحديث مع الأطفال حول بعض هذه الحيوانات من أجل رفع وعيهم بأهميّة الحفاظ على الطّبيعة وكائناتها.
-
- صادت شبكة الصّياد الغزال، فماذا يمكن أن تصيد أيضًا؟ وماذا إذا كانت في البحر؟
- تنتهي القصّة بجملة “وحين أشرقت الشّمس ثانيةً، بدأت حكاية جديدة من حكايات الفأر وأصدقائه الثّلاثة…” ادعي الأطفال إلى تأليف حكاية جماعيّة جديدة عن مغامرة أخرى للأصدقاء الأربعة.
-
تجدين في صفحة الفانوس اللّغوي (أنظري “روابط نوصي بها” في صفحة الكتاب) اقتراحاتٍ لأنشطة لغويّة حول الكتاب.
الفانوس اللّغويّ
ماذا في الكتاب؟
في نظرة:
- رسومات القصّة ملائمة للحوارات الوصفيّة والتحليليّة.
- رسومات الشخصيات توفّر فرصةً للحديث عن مزايا كلّ شخصية “وعائلتها” من الكائنات الحيّة.
في قراءة:
- شخصيّات القصّة منوّعة، من فئاتٍ مختلفة من الكائنات الحيّة، ما يُتيح إمكانيّاتٍ للتعرّف إلى مزايا كلّ فئة، وتصنيفها وتنمية مهارات التصنيف والتعميم.
- لكلّ شخصيّةٍ طريقتها في الحركة (طيَران، زحف، مشي على أربع)، وهي فرصةٌ لإغناء قاموس المفردات الحركيّة وإيقاعها/ سرعتها.
- النصّ يجسّد طريقةً لمفهوم التّعاون، وهو ملائم لتنمية الكفايات اللغويّة حولها.
نقترح:
- إقامة أنشطة للتصنيف وفق مزايا مشتركة.
- إقامة أنشطة حركيّة بطرقٍ وبسرعاتٍ مختلفة.
- إتاحة حواراتٍ حول مفهوم التعاون والمشاركة وحلّ المشاكل لتعزيز مناخٍ تربويّ إيجابيّ، وتمنية مهارة العمل في طاقم.
قبل الانطلاق: لنتذكّر ما ينصّ عليه منهج التربية اللغويّة
- أطفال الرّوضة “يصنّفون ويعرفون كلماتٍ ويحدّدون مزاياها من حيث البُعد الدّلاليّ (المعنى) والوظيفيّ”.
- “يصنّفون مجموعةَ أغراضٍ إلى حقولٍ دلاليّةٍ عامّة وفرعيّة”.
تعالَوا نتحدّث:
- نتحدّث عن سلوك الشخصيّات، نحكي تجاربنا مع أصدقائنا. يمكن الاستعانة بوردة الصّداقة. يقدّمها الطفل لأحد أصدقائه ويحكي عن تعاونٍ بينهما أثناء اللعب في الروضة.
- نتحدّث عن المهامّ الصعبة التي احتجنا فيها إلى مساعدة الأصدقاء.
- نتحدّث عن الحكايا التراثيّة التي نعرفها/ الألعاب التراثية/ الأغاني وغيرها.
- نتحدّث عن الحبكة وتسلسل الأحداث. يمكن أن نحضّر قصةً محوسَبة يرتّبها الطفل وفق الصور ويُعيد حكايتها.
حفل الكلمات:
غراب- فأر- قوارض- سلحفاة- غزال- صياد- شبكة- حيوانات بريّة- تعاوُن- بطيء- سريع- يزحف- يطير…
- نطوّر أنشطةً حركيّةً وفق طريقة كلٍّ من الشخصيات في التحرّك : نطير- نرفرف- نمشي على أربع… نزحف سريعًا/ بطيئًا..
- نتعرّف إلى موسوعة الكائنات الحيّة ونصنّف كلّ شخصيّةٍ مع عائلتها. نصوّر تقليدَ الأطفال لها ونبني كتيّبًا من صوَرنا الحركيّة.
- نتحدّث عن تجاربنا المشتركة وتعاوُننا وحلّ مشاكلنا. نشارك أصدقاءنا بالحديث عن مشاعرنا مع التعاون/ المساعدة/ المشاركة.
الوعي الصّرفيّ والصّوتيّ:
- نحضّر بطاقاتِ تعريفٍ للشخصيات: اسم وأوصاف كلّ شخصية، طريقة حركتها، سلوكها، وميزاتها. تكتب المربية الكلمات وتشارك الاطفالَ تقطيعها إلى مقاطع/ فونيمات وفق مستوى الأطفال.
- نحضّر قصّةً محوسَبة من الصّوَر: نلائم الأوصاف للشخصيّة ونرتّب تسلسلَها. نلائم الكلماتِ للصورة.
- نلعب ألعابًا صوتيّةً مع المفردات الملائمة :تعاوُن/يتعاوَن/متعاوِن- يساعد/مساعَدة…
الكفايات اللغويّة:
- نتعرّف إلى صفات كلّ شخصيّة، نصنّفها مع عائلتها. نتعرّف إلى موسوعة الكائنات الحيّة ونبحث عن كائناتٍ أخرى تنتمي لنفس العائلة.
- نصنّف أغراضًا أخرى في الرّوضة وفق مزاياها المشتركة.
- قد نبني حديقةً للحيوانات في ركن البناء ونوزّعها وفق صفاتها وعائلاتها المشتركة: أين نضع كلّ شخصية؟ ماذا تحتاج كلّ عائلةٍ لبناء بيتها؟
ماذا أيضًا:
- قد نجمع حكايا تراثيّةً أخرى ونضيفها لركن المكتبة/ نستضيف حكائيًّا أو جدًّا يحكي لنا الحكايا الشعبيّة.
- نبني موسوعةً للحيوانات التي تعرّفنا إليها، من الصّور المتوفّرة. نحضّر لعرضٍ مسرحيّ ونتبادل الأدوار.
- نطوّر أنشطةً رياضيّةً ونتحرّك مع الموسيقى في مجموعاتٍ مثل الفأر/ السلحفاة/ الغزال/ نمشي على أربع/ نزحف/ نطير. (نصف حركة مجموعة الفئران/ مجموعة السلاحف…). نصوّر الأطفال ونضيف الصّور إلى ركن الرياضة في الروضة.
عملًا ممتعًا..
أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة.
نتحادث
حول المشكلة: في القراءة الأولى، وقبل الوصول إلى الحلّ، نسأل طفلنا: طلبت الأمّ من أليف أن يجد الحلّ للمشكلة، “كيف من الممكن أن يحصل على الكعكة بطريقة أفضل”؟ ماذا تقترح أن يفعل؟ نكمل القراءة ونسأل طفلنا مرّة أخرى ما هي الحلول التي اقترحها أليف؟ وما هو الحلّ المناسب؟
- حول المشاعر: نتتبّع الرسومات ونتحدّث حول مشاعر أليف. نسأل أطفالنا: بِمَ شعر أليف عندما رأى والدته تحضّر الكعك؟ بِمَ شعر عندما رفضت أن تعطيه الكعك وطلبت إليه أن يفكّر في طريقة للحصول عليه؟ بِمَ شعر عندما لم يجد الحلّ؟ بِمَ شعر في نهاية القصّة؟
- حول المحاولة: حاول أليف عدّة مرّات وجرّب عدّة طرق للوصول إلى الحلّ. نسأل أطفالنا: هل حدث ذات مرّة أن حاولتم عدّة مرّات الحصولَ على شيء ما، أو فعْلَ شيء ما؟ كم مرّة جرّبتم؟ متى نشعر بالإحباط؛ بعد كم من التجارب؟ ماذا نفعل عندما نُحبَط؟
- حول حلّ المشكلات: نتحادث نحن وطفلنا عن حالات شبيهة وَجَبَ فيها عليهم أن يجدوا حلولًا لمواقف أو مشكلات. نسألهم: هل واجهتم مشكلة؟ ما هي؟ كيف كان شعوركم؟ كم مرّة حاولتم؟ كيف وجدتم الحلّ؟ مَن ساعدكم؟ إذا كنتم لم تجدوا حلًّا، كيف كان شعوركم؟ كيف تعاملتم مع الشعور بالإحباط؟
- التفاعل بين الأم وطفلها: تقوم الأمّ بتحضير الكعك لأليف والعائلة. نتحادث نحن وطفلنا عمّا يَحْدث في بيتنا: ما هي الأمور التي تقوم بها الأمّ والأب لنا؟ ما هي الأمور التي تحبّ أن نقوم بها معًا؟
- مواقف حياتيّة واجتماعيّة: قدّمت أمّ أليف بسلوكها نموذجًا متطوّرًا للحِوار والأخذ والعطاء. نتحادث نحن وطفلنا عمّا يَحْدث في بيتنا. نسألهم: ماذا يحدث عندما تقوم بشيء مختلف عمّا تريده أمّنا أو أبونا؟ كيف تتصرّف؟ كيف تحبّ أن نتحدّث معك؟
نُثْري لغتنا
قصّتنا تحوي في جعبتها قاموسًا شعوريًّا وذهنيًّا واجتماعيًّا: يحبّ؛ رغب؛ أحبط؛ فكر ؛ خطرت له فكرة؛ خطرت بباله فكرة؛ شكرًا؛ من فضلك؛ عفوًا. نستعملها في السياق اليوميّ.
نحاكي ونبدع
نختار مواقفَ اجتماعيّة مختلفة، ونتعرّف مع الأطفال على التعابير اللطيفه الملائمة لهذه المواقف، فنمثّل معًا التصرّف المناسب ونوظّف التعابير الاجتماعيّة المناسبة -على سبيل المثال: حفلة عيد ميلاد؛ زيارة لمريض؛ اعتذار؛ استقبال الضيوف؛ الحلول ضيوفًا؛ عندما نحتاج مساعَدة…
نتحادث
- حول المشكلة: في القراءة الأولى، وقبل الوصول إلى الحلّ، نسأل طفلنا: طلبت الأمّ من أليف أن يجد الحلّ للمشكلة، “كيف من الممكن أن يحصل على الكعكة بطريقة أفضل”؟ ماذا تقترح أن يفعل؟ نكمل القراءة ونسأل الأطفال مرّة أخرى ما هي الحلول التي اقترحها أليف؟ وما هو الحلّ المناسب؟
- حول المشاعر: نتتبّع الرسومات ونتحدّث حول مشاعر أليف. نسأل الأطفال: بِمَ شعر أليف عندما رأى والدته تحضّر الكعك؟ بِمَ شعر عندما رفضت أن تعطيه الكعك وطلبت إليه أن يفكّر في طريقة للحصول عليه؟ بِمَ شعر عندما لم يجد الحلّ؟ بِمَ شعر في نهاية القصّة؟
- حول المحاولة: حاول أليف عدّة مرّات وجرّب عدّة طرق للوصول إلى الحلّ. نسأل الأطفال: هل حدث ذات مرّة أن حاولتم عدّة مرّات الحصولَ على شيء ما، أو فعْلَ شيء ما؟ كم مرّة جرّبتم؟ متى نشعر بالإحباط؛ بعد كم من التجارب؟ ماذا نفعل عندما نُحبَط؟
- حول حلّ المشكلات: نتحادث مع الأطفال عن حالات شبيهة وَجَبَ فيها عليهم أن يجدوا حلولًا لمواقف أو مشكلات. نسألهم: هل واجهتم مشكلة؟ ما هي؟ كيف كان شعوركم؟ كم مرّة حاولتم؟ كيف وجدتم الحلّ؟ مَن ساعدكم؟ إذا كنتم لم تجدوا حلًّا، كيف كان شعوركم؟ كيف تعاملتم مع الشعور بالإحباط؟
- طرق التواصل السليم: يكتسب الأطفال الخبرات والمهارات اللازمة لفهم وإدارة عواطفهم ورغباتهم من خلال ممارستها معهم ومساندتهم. في الكتاب، استطاعت الأم أن تصل إلى أليف بسهولة وأن تؤثّر فيه، فعلمته آداب الطّلب والتّوجه بأسلوب متفهّم وصبور. ندعو الأطفال لمشاركتنا مواقف شعروا فيها بمعاملة لطيفة ساندتهم في التّعامل مع التحدّيات.
نستكشف
نلعب لعبة التّخمين: نغمض عيوننا بمنديل قماشيّ، ونحاول تمييز أنواع زطعمة مختلفة بالاعتماد على رائحتها وملمسها وطعمها. نصفها ونسميها باستعمال المفردات الدقيقة.
نتواصل
- نعزّز التواصل الاجتماعيّ السليم وتوظيف المفردات الاجتماعيّة من خلال زيارة مرضى أو بيت المسنين، ونتمرس باستعمال المفردات الاجتماعيّة مع الأطفال.
- نُعِدّ يومًا مشترَكًا للأمّهات والأطفال في الروضة. نجهّز أنشطة تُغْني علاقة الأمّ بالطفل وتتيح التقارب والتواصل، كما نُعِدّ إضاءات إرشاديّة للأمّهات تعزّز علاقتهن بطفلها.
نثري لغتنا
- وردت في الكتاب كلمات نحو: من فضلك، شكرًا، عفوًا. نحضّر بطاقات تظهر مواقف اجتماعيّة مختلفة (مثلًا: حفلة عيد ميلاد). نتعرّف مع الأطفال على العبارات الكلاميّة الملائمة لهذه المواقف ونستعملها في حديثنا اليوميّ.
- نشجع الأطفال على التعبير والتواصل العاطفيّ، نبدأ بجملة وندعو الأطفال لإكمالها: أنا فخور بالتّمساح الصغير لأنّه……..، تعلمت من التمساح الصغير أنّ……..، لو كنت مكان التمساح ل…..
نحاكي ونبدع
- التصرّف بالمواقف: نختار مواقفَ اجتماعيّة مختلفة، ونتعرّف مع الأطفال على التعابير اللطيفة الملائمة لهذه المواقف. نمثّل معًا التصرّف المناسب ونوظّف التعابير الاجتماعيّة المناسبة. على سبيل المثال: حفلة عيد ميلاد؛ زيارة لمريض؛ اعتذار؛ استقبال الضيوف؛ الحلول ضيوفًا؛ عندما نحتاج مساعَدة…
- حل المشكلات والصراعات: نحضر بطاقات تُظهر وضعيّات بمثابة تحدّيات للطفل. مثلًا: طفل يستصعب ربط حذاءه؛ طفل يودّ الانضمام للّعب مع الأصحاب لكنّه لا يستطيع؛ طفل وقعت منه البوظة واتسخت ملابسه، وهكذا. نفكّر معًا وندعو الأطفال لاقتراح حلول لهذه التّحديات.
نتحاور
- حول الحاجة الى المساعدة: نتحدّث عن مشاعر الدب الكبير قبل وبعد أن تعاون الجميع لمساعدته. نسأل طفلنا: كيف شعر الدب عندما لم يجد مكانّا يجلس فيه؟ كيف شعر بعد أن وجد له مكانًا مع بقية الدببة؟ نسمي هذه المشاعر، ونسأله: لماذا راودته هذه المشاعر؟
- حول تحدّيات تواجهنا: واجهت الدب الكبير مشكلة، نسأل الطفل: ما هي المشكلة؟ هل واجهتك مشكلة ما؟ كيف تخطيتها؟
- حول تجاربنا عن المشاركة والتّعاون: نشارك طفلنا بتجربة تعاوّنا فيها مع أشخاص آخرين لمساعدة أحدهم، ثم نسأله عن تجربة مُماثلة مرّ بها في البيت اوفي الروضة: ماذا شعرت عندما تعاونت مع آخرين، أوعندما قدمت المساعدة لمن يحتاجها؟ ماذا برأيك شعر الشخص الذي ساعدته؟
نثري لغتنا
- قاموس حسّي حركي: تحتوي القصة على مفردات حسيّة، نحو: قطنيّ/ طريّ، وتحتوي على مفردات حركية، نحو: يجرّ، يقف، يجلس. نيسّر استعمالها في حياتنا اليومية لوصف أغراضنا وأداءاتنا الحركية ونفسح المجال للطفل ليعبّر عن حركاته وأفعاله.
- – قاموس الوعي الرياضي: تحتوي القصة على مفردات رياضيّة تراتبيّة، نحو: الأوّل، الثّاني، اثنان ثلاثة، وخمسة. يمكننا التدّرب واللّعب حول ترتيبنا في العائلة المصغّرة وترتيب الأعمام والأخوال، العمّات والخالات في العائلة المُوسّعة.
نستكشف
نبحث في مصادر مختلفة عن معلوماتٍ حول الدُّببة: أنواعها، طعامها وطرق معيشتها. قد نتمتّع أيضًا مع طفلنا بمشاهدة فيلم وثائقي حولها.
نبدع
نحضّر برفقة أطفالنا دببًا من أقمشة وخامات مختلفة متوفّرة في البيت، مثل: جوارب، قمصان، أزرار وخيطان صوفيّة مُلوّنة.
نلعب معًا
نلعب معًا لعبة الكراسي. نصفّ الكراسي وندور حولها على أنغام موسيقا. حين تتوقف الموسيقا، نجلس على الكراسي، وفي كلّ مرة ننقص منها واحدًا. هل ننجح في أن نجلس كلّنا على كرسيّ واحدٍ؟ لنجرّب!
نتحاور
- حول الحاجة إلى المساعدة: نتحدّث عن مشاعر الدبّ الكبير قبل وبعد أن تعاون الجميع على مساعدته. نسأل الأطفال: كيف شعر الدبّ عندما لم يجد مكانًا يجلس فيه؟ كيف شعر بعد أن وجد له مكانًا مع بقية الدببة؟ نسمّي هذه المشاعر، ونسألهم: لماذا راودته هذه المشاعر؟
- حول تحدّيات تواجهنا: واجهت الدبّ الكبير مشكلة، نسأل الأطفال ما هي المشكلة؟ هل واجهتك مشكلة ما؟ كيف تخطيتها؟
- حول تجاربنا في المشاركة والتّعاون: نشارك الأطفال بتجربة تعاونّا فيها مع أشخاص آخرين لمساعدة شخص ما. ثمّ نسألهم عن تجربة مُماثلة مرّوا بها في البيت أو في الروضة: ماذا شعرت عندما تعاونت مع الآخرين أو عندما قدّمت المساعدة لمن يحتاجها؟ ماذا، برأيك، شعر الشخص الذي ساعدته؟
نثري لغتنا
قاموس حسّيّ حركيّ: تحتوي القصة على مفردات حسيّة، نحو: صوفيّ، ناعم. وتحتوي على مفردات حركيّة، نحو: يصعد، يتسلّق، يجلس. نيسّر استعمالها في حياتنا اليوميّة لوصف أغراضنا وحركاتنا، ونفسح المجال للطفل ليعبّر عن حركاته وأفعاله.
قاموس الوعي الرياضيّ: تحتوي القصة على مفردات رياضيّة تراتبيّة، نحو: الأوّل، الثّاني، الثّالث، الرّابع. يمكننا إدخالها ضمن الأنشطة المختلفة بالروضة (مثل الأنشطة الحركيّة في الساحة عند الانتظار بجانب الألعاب…).
نبدع
- نستضيف في الصفّ ورشة للأهالي، أو الأجداد، ونحضّر برفقة الأطفال دببًا من أقمشة ومواد مختلفة متوفّرة في البيت، نحو: جوارب، قمصان، أزرار وخيطان صوفيّة مُلوّنة.
- نحضّر لعبة من وحي القصة، نحو لعبة ذاكرة تحتوي على مفاهيم المكان مثل (بجانب، بين، تحت)، صفات (منقّط، مخطّط)، ومفاهيم أخرى من وحي القصّة.
نمثّل
حياتنا في الروضة غنيّة بالمواقف التي يجد الطفل فيها صعوبة في المشاركة، وخاصّة وقت اللعب. نشاهد الأطفال، ثمّ نقوم بتمثيلها مجدّدًا ونتبادل الأدوار. بعد ذلك، نتحدّث ونتحاور حول مشاعر ورغبات الشركاء في الموقف، وعن الصعوبات التي واجهناها وطرق التعامل معها. نساندهم في التعبير عن مشاعرهم، ونبيّن لهم أنّ المشاركة تعني الاهتمام بالآخر وإظهار ودّنا له.
نلعب معًا
“في صفّنا مكان لكلّ طفل“: نلعب معًا لعبة الكراسي. نصفّ الكراسي وندور حولها على أنغام موسيقيّة. حين تتوقف الموسيقى، نجلس على الكراسي، في كلّ مرة نوقف فيها الموسيقى نُنقص كرسيًا. هل ننجح في أن نجلس كلّنا على كرسيّ واحدٍ؟ لنجرّب!
نشاط مع الأهل
- يمكنكم أن تتأمّلوا مع طفلكم رسومات الكتاب. من المثير أن تنتبهوا إلى زوايا النّظر المختلفة في الرّسومات: أيّ الرّسومات تُظهر الأحداث من مكان مرتفع وأيّها من الجانب؟ يمكن أن تتحادثوا مع طفلكم حول اختيار الرسّامة لرسم المشاهد على الجسر من هذه الزّوايا.
- أحيانًا، تمرّ في خاطرنا عدّة أفكارٍ، قبل أن نصل إلى الفكرة النّاجحة. نسترجع مع الطّفل الأفكار الّتي اقترحها الدّب والعملاق لعبور الجسر، ونتحادث حول سلبيّات وإيجابيّات كلّ فكرة.
- يعيش طفلكم مواقف يوميّة عديدة، تتصادم فيها رغباته مع رغبات أفراد العائلة الآخرين. فقد يرغب باللّعب في وقت راحتكم، وقد يريد النّوم في وقتٍ يريد به أخوه أن يقرأ في فراشه، وقد ينغمس في اللّعب لحظة خروجكم من البيت. هذه مناسبة للحديث معًا حول هذه المواقف، وفي تذكّر الطّرق الخلاّقة للتّعامل معها.
- قطع اللّيجو، أو أعواد البوظة، أو المكعبّات، هي موادّ ممتازة لبناء جسرٍ معًا، ولمسرحة القصّة.
- هل تذكرون لعبة ” يا جسر من ذهب”؟ تقفون أنتم وطفلكم متقابلين وتمسكون بالأيدي وترفعونها إلى الأعلى وتغنون:” يا جسر يا جسر من ذهب/ تحتك مُنمْرُق وفي حدا بِنْمَسك”. أثناء الغناء يمّر أصدقاؤكم أو أفراد العائلة تحت الجسر، وحين تصلون إلى كلمة “بنمسك” تقبضون على المارّ في تلك اللّحظة، ويخرج من اللّعبة.
-
من الممتع أن تستكشفوا وأن تستذكروا جسورًا في منطقتكم. قد يكون جسرًا صغيرًا في متنزّه قريب من مكان سكناكم، أو جسرًا كبيرًا عبره الطّفل ذات مرّة. بماذا تختلف الجسور؟ وبماذا تتشابه؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن أن تتحادثي مع الأطفال حول الحلول المختلفة الّتي اقترحها الدّب والعملاق. ماذا كان يمكن أن تكون عواقبها؟
- يمكن أن تجسّدي الجسر بأن تلصقي شريطًا على الأرض، أو تبني بمساعدة الأطفال صفًّا من المكعّبات، وتدعي الأطفال إلى أن يمرّوا على الجسّر دون أن “يقعوا”. ادعي طفلين إلى عبور الجسر من جهتيه في نفس الوقت. هل سيضطران إلى التّعانق كما فعل الدّب والعملاق، أم هناك حلولٌ أخرى؟
- استذكري مع الأطفال مواقف خلاف يحدث بين طفلين في البستان يوميًّا (عند تسلّق سلّم الزّلّاقة، أو النّزاع حول استخدام لعبة): ماذا يشعر كلّ طفل؟ كيف يمكن أن نحلّ معًا هذا الخلاف؟ هناك مواقف يشهدها أو يعيشها أطفالنا يوميًا في الشّارع، مثل: الخلاف على حقّ المرور أو ركن السّيارة. هذه مناسبة للحوار مع الأطفال حول رأيهم في كيفيّة حلّ هذه النّزاعات.
- يمكنك أيضًا أن تدعي الأهل إلى الكتابة عن موقف خلافٍ في العائلة، تنازل فيه الطّفل لأخيه/أخته بعد طول انتظار، أو بادر إلى حلّ مبدعٍ. من الجميل أن تشاركي هذه المواقف مع الأطفال في البستان، وبذا تعزّزي ثقة الأطفال بقدرتهم على حلّ الخلافات بطرقٍ مُبدعة غير عنيفة.
- قامت الرسّامة برسم الأحداث من زوايا مختلفة. ندعو الأطفال إلى تأمّل كلّ رسمة. ماذا يرون فيها؟ أيّ رسومات رسمتها برأيهم من زاوية النّظر من فوق، ومن تحت، ومن الجانب؟
- استمرارًا للعمل على موضوع زوايا الرّؤية، يمكن دعوة الأطفال إلى تأمّل غرضٍ، والنّظر إليه من زوايا مختلفة، ثمّ رسمه. ما الفرق بين الرسومات؟ وما الذي ساعده على الرسم بزوايا مختلفة؟
- النّصّ مناسبٌ جدًا لمسرحته، وبأدواتٍ بسيطة. سيكون جميلًا إذا عرضه الأطفال في لقاء مع الأهل، أو قد يرغب بعض الأهل في المشاركة بإعداده وتمثيله.
-
لعبة “يا جسر من ذهب” من الألعاب التّراثيّة الجميلة، والّتي يتمتّع بها الأطفال. أنظري وصف اللّعبة في الاقتراحات للأهل في نهاية الكتاب.
نتحاور
حول العنوان: نقرأ العنوان برفقة أطفالنا ونسألهم: ماذا برأيكم يمكن أن نفعل بمشكلة؟ نستمع ونصغي إليهم، ونكمل قراءتنا للكتاب.
حول الحبكة: الحِوار حولها يمكّن طفلنا من فهم الكتاب والانطلاق بعدها لفهم ما بين السطور. نتتبّع الرسومات ونتحادث مع طفلنا حول الأحداث المختلفة. نسأله -مثلًا-: ماذا حدث للطفل؟ بِمَ أحسّ؟ بُيِّنت المشكلة في الرسم كغيمة سوداء. ماذا برأيك يمكن أن تكون تلك المشكلة التي واجهته؟ كيف حدثت؟ كيف تعامل معها؟ ماذا حدث عندما تجاهلها وطردها؟ وماذا حدث عندما واجهها؟ ماذا اكتشف عندئذ؟
حول المشاعر والأفكار: توضّح الرّسومات المشاعر على نحوٍ جميل. نتتبّع مع أطفالنا الرسومات ونسأل حول كلّ حدث: ماذا شعر الطفل؟ ماذا كان يفكّر؟ ماذا كان يرغب؟ نسمّي المشاعر والأفكار بأسمائها: الارتباك عندما ظهرت المشكلة؛ الغضب؛ القلق؛ الخوف… ونسأل أيضًا: لماذا راوَدَ الطفلَ هذا الشعور؟
حول الأفكار: ما هي الأفكار التي راودت الطفل؟ نعدّدها برفقة أطفالنا: “ماذا سيَحدث لو ابتلعتني”؟ “ماذا يحدث لو أخذت كلّ أشيائي؟” ونسأل الطفل: هل فعلًا من الممكن أن تتحقّق هذه الأمور؟ وكيف؟ هل حدث أن فكّرت على هذا النحو؟ متى؟ كيف كان شعورك؟
حول حلّ المشكلات والخروج من المأزق: نسأل الطّفل: ما المقصود بـِ “أن نواجه المشكلة”؟ وما المقصود بأنّه “داخل مشكلتي هناك فرصة مختبئة”؟ ونسأل طفلنا: هل وقعتَ ذات مرّة في مشكلة؟ بِمَ شعرت؟ كيف استطعت الخروج منها؟ مَن ساعَدَك؟ ماذا تعلّمت من تلك التجربة؟ نشارك طفلنا بطرق حلّ المشكلات: نحدّد سبب وجود المشكلة، ثمّ نحدّد ما هي المشكلة، وبعد ذلك نضع الحلول الممكنة لها ونحدّد ما هي تبعات كلّ حلّ، وعلى هذا الأساس نختار الحلّ الأفضل.
حول تمكين الطفل: يستند الأطفال إلى قدراتهم وخبراتهم الإيجابيّة ونجاحاتهم السابقة في التعامل مع المشكلات. نذكّر أطفالنا بتجارب سابقة استطاعوا فيها اجتياز المشكلات والصعوبات، ونتحادث حول الصفات والأمور التي ساعدتهم في التغلّب على المشكلة ومواجهتها.
نمثّل
نكتب برفقة أطفالنا سيناريو لمشاكل عديدة قد يقع فيها طفلنا، ونتمرّن حول الأمور التي من الممكن أن يقولها لنفسه ويقوم بها لمواجهة المشكلات، نحو: الضياع في المجمَّع التجاريّ؛ التعرّض لتنمُّر؛ حدوث مشكلة مع صديق؛ أن يطرق غريبٌ البابَ والأهل ليسوا في البيت… نمثّل مع أطفالنا ونتقمّص الشخصيّات المختلفة. نتحدّث عن مشاعرنا وأفكارنا وتصرّفاتنا.
نُثري لغتنا
الكتاب غنيّ بالمفردات اللغويّة الجميلة والجديدة. نفسّرها لأطفالنا أثناء القراءة ونتحدّث عنها بعدها أيضًا، نحو: أواجه المشكلة؛ أتجاهلها؛ تسلّلت؛ تمويه؛ فرصة. نستخدم تلك الكلمات في حياتنا اليوميّة كي تصبح جزءًا من قاموس طفلنا اللغويّ.
نتحاور
حول العنوان: نقرأ العنوان برفقة التلاميذ الصغار ونسألهم: ما المقصود بأن تواجهنا مشكلة؟ أيّ المشكلات من الممكن أن تواجهنا؟ ماذا برأيكم يمكن أن نفعل بمشكلة؟ نستمع ونصغي إليهم، ونكمل قراءتنا للكتاب.
حول الحبكة: الحِوار حولها يمكّن التلاميذ الصغار من فهم الكتاب والانطلاق بعدها لفهم ما بين السطور. نتتبّع الرسومات ونتحادث حول الأحداث المختلفة. نسأل –على سبيل المثال-: ماذا حدث للطفل؟ بِمَ أحسّ؟ بُيِّنت المشكلة في الرسم كغيمة سوداء. ماذا برأيك يمكن أن تكون تلك المشكلة التي واجهته؟ كيف حدثت؟ كيف تعامل معها؟ ماذا حدث عندما تجاهلها وطردها؟ وماذا حدث عندما واجهها؟ ماذا اكتشف عندئذ؟
حول المشاعر والأفكار: نتتبّع الرسومات برفقة التلاميذ الصغار. هنالك انسجام كبير بين النصّ والرسومات؛ فقد برزت المشاعر من خلال الرسومات. نتتبّع الرسومات ونسأل حول كلّ حدث: ماذا شعر الطفل؟ ماذا كان يفكّر؟ ماذا كان يرغب؟ نسمّي المشاعر والأفكار بأسمائها: الارتباك عندما ظهرت المشكلة؛ الغضب؛ القلق؛ الخوف… ونسأل أيضًا: لماذا راوَدَ الطفلَ هذا الشعورُ؟
حول الأفكار: ما هي الأفكار التي راودت الطفل؟ نعدّدها برفقة التلاميذ الصغار: “ماذا سيَحدث لو ابتلعتني”؟ “ماذا يحدث لو أخذت كلّ أشيائي؟” ونسأل التلاميذ الصغار: هل فعلًا من الممكن أن تتحقّق هذه الأمور؟ وكيف؟ هل حدث أن فكّرتم على هذا النحو؟ متى؟ كيف كان شعوركم؟
حول حلّ المشكلات والخروج من المأزق: نتحاور مع التلاميذ الصغار ونسألهم: ما المقصود بـِ “أن نواجه المشكلة”؟ وما المقصود بأنّه “داخل مشكلتي هناك فرصة مختبئة”؟ ونسأل التلاميذ الصغار: هل وقعتَ ذات مرّة في مشكلة؟ بِمَ شعرت؟ كيف استطعت الخروج منها؟ مَن ساعَدَك؟ ماذا تعلّمت من تلك التجربة؟ نشارك التلاميذ الصغار بإستراتيجيّات حلّ المشكلات: نحدّد سبب وجود المشكلة، ثمّ نحدّد ما هي المشكلة، وبعد ذلك نضع الحلول الممكنة لها ونحدّد تَبِعات كلّ حلّ، وعلى هذا الأساس نختار الحلّ الأفضل. لمزيد من المعرفة، يمكننا الاستعانة بوثيقة تطوير التفكير.
حول تمكين الطفل: يستند التلاميذ الصغار على قدراتهم وخبراتهم الإيجابيّة ونجاحاتهم السابقة في التعامل مع المشكلات. نذكّر أطفالنا بتجارب سابقة استطاعوا فيها اجتياز المشكلات والصعوبات، ونتحاور حول الصفات والأمور التي ساعدتهم في التغلّب على المشكلة ومواجهتها.
نبدع
نوجّه التلاميذ الصغار أن يشاركوا في عرض مشكلة واجهتهم، وذلك من خلال التعبير بالكتابة، أو بالتعبير الشفهيّ بالـﭭـيديو، وأن يوضّحوا كيف استطاعوا مواجهتها.
نمثّل ونعرض
نختار مشكلة تشغل التلاميذ الصغار في الصفّ. برفقتهم نقوم بإعداد سيناريو لها يتضمّن المشكلة ومعالجتها. نُمَسْرِحها ونعرضها في المدرسة أمام التلاميذ أو الأهالي.
نُثْري لغتنا
الكتاب غنيّ بالمفردات اللغويّة الجميلة والجديدة. نفسّرها أثناء القراءة ونتحدّث عنها بعدها أيضًا، نحو: أواجه المشكلة؛ أتجاهلها؛ تسلّلت؛ تمويه؛ فرصة. نستخدم تلك الكلمات في حياتنا اليوميّة كي تصبح جزءًا من قاموس طفلنا اللغويّ.
نشاط مع الأهل
- فِل الخارق يستطيع الطّيران في السّماء، والعمّة زيلدا خيّاطة ماهرة، وفيلو ماهرٌ في ابتكار الحِيَل. نتحادث عن أمورٍ يستطيع طفلنا أن يقوم بها بمهارة تجعله “خارِقًا”.
- نتخيّل لو صادف الفيلانِ قطيع زرافاتٍ، أو مجموعة دببة، أو ضفادع في بركة. أيّ حِيل سيبتكرها فيلو حتّى يتجاوزها؟
- نفكّر لماذا لوّن الرّسام فيلو والعمّة زيلدا بألوانٍ مختلفة بينما رسم باقي الفيلة بلونٍ رماديّ.
- ساعد فيلو صديقه الصّغير. هل ساعدنا مرّة صديقًا لنا؟ كيف؟
- ورشة عائليّة لتصميم أزياء تجعلنا خارقين! كلّ ما نحتاجه هو ملابس قديمة، وأصباغٌ للرّسم على القماش، وبعض القطع الصّغيرة للتّزيين، مثل الأزرار، والرّيش، والأقمشة البرّاقة، وغيرها.
نتحادث
قبل القراءة نتمعّن في صفحة الغلاف، ونسأل الأطفال ما الملفت النظر في الفيل الكبير؟ بماذا يشبه الفيلة في الغابة وبماذا يختلف عنها؟
نتعرّف مع الأطفال على الفيل فيلو بالاستعانة بالشبكة العنكبوتية. الفيل فيلو هو شخصية محبوبة وفكاهية مشهورة ومعروفة باسم إلِمر (Elmer) وهو بطل سلسلة القصص للكاتب والرّسّام البريطاني دافيد ماكي، والّتي صدر عنها أكثر من أربعين كتابًا.
“الصّديق وقت الضّيق” – نتحدّث مع الأطفال عن مفهوم الصداقة، وعن مشاكل واجهتهم وكيف تعاملوا معها، ومن ساندهم في ذلك.
وقع فل الخارق في مأزق وهبّ صديقه فيلو لمساعدته. نتحدّث عن المشاعر والأفكار الّتي تراودنا عند الوقوع في مأزق. نسأل الأطفال: هل وقعت في مشكلة؟ كيف كان شعورك؟ هل ساعدك أصدقاؤك في حلّها؟ هل ساعدت صديقًا كان في ضيق، وكيف؟ ماذا كان شعوره وشعورك عندما فعلت ذلك؟
فيلو كان فطينًا وبارعًا في حلّ المشكلات. نتتبع مع الأطفال الحِيَل المختلفة التي ابتكرها فيلو، ونتحدّث عنها: نطلب من الأطفال وصف الحيلة، ونسألهم عن أفكار الشخصيات ونواياها. مثلًا، في الحيلة مع الفيلة نسأل الأطفال: لماذا حكى فيلو نكتة للفيلة؟ ماذا قصد من ذلك؟ ماذا اعتقدت باقي الفيلة؟ هل قصد فعلاً قضاء وقت ممتع معها؟ نتابع الحوار مع الأطفال حول باقي الحيل.
نشبك الكتاب بحياة الطّفل ونطوّر قدرته الاجتماعيّة والذّهنيّة المتعلّقة بفهم المآزق وإيجاد الحلول، من خلال الحوار وتقمّص الأدوار. تقوم المربية بتحضير صور لمواقف اجتماعية وأحداث تحتاج إلى التّفكير في حلّ لها، مثلًا ابتعاد طفل عن أهله في مجمّع تجاري أو بكاء صديق في الرّوضة لسبب ما، ثمّ تعرضها على الأطفال وتحاورهم طالبةً منهم وصف الحدث أو المشكلة، وتسألهم حول مشاعر الشخصيات وأفكارها، ثمّ تطلب منهم إعطاء حلول. تستطيع أيضًا تمثيل الحدث أو المشكلة مع الأطفال.
نستكشف
“الفيلة لا تنسى أبدًا” هل هذه المقولة صحيحة؟ نقوم بمشروع تعلّمي نستكشف من خلاله حقائق مدهشة عن الفيلة.
نثري لغتنا
الكلمة “خارق” ترافقنا طيلة النص. نسأل الأطفال ما معنى “خارق”؟ ما الذي يدلّنا على معنى الكلمة في الرّسومات؟ هل نعرف شخصيّات أخرى “خارقة”؟
الكتاب غنيّ بالمفردات، منها مثلًا: الأفعال (تجاوز، دع، يلهي)، والصّفات (مكسور، ممزّق، مندهش). من الجيّد أن نلفت انتباه الأطفال إلى هذه المفردات وغيرها، ونفسّر الصعبة منها ونوظّفها في لغتنا اليومية.
نبدع
فيلو ملوّن بمربّعات جميلة. نحاول تحضير قصاصات ورقية وكرتونية ملوّنة ونستعملها كتقنيّة للتّلوين.
نصنع كولاجًا لفيل من القصاصات الملونة أو أوراق الجرائد. تجدين في هذا الرابط نموذجًا لفيل جاهزٍ للتلوين.
نحتفل في روضتنا ب“يوم الأبطال الخارقين”. يحضّر كلّ طفل قطعة قماشيّة أو عباءة (او شالًا) يستطيع الرّسم عليها. نلوّنه مع الأطفال في أعقاب قراءة القصّة، وعند الانتهاء يرتدي كلّ طفل عباءته السّحرية، ويرقص جميع الأبطال على أنغام الموسيقى في حفلةٍ صفّية.
نتواصل
في كل سنة من شهر أيار يصادف عيد ميلاد فيلو – إلمر (Elmer). يمكن كتابة بطاقة معايدة مع الأطفال، وإرسالها عبر صفحته الخاصة في الانستجرام elmerthepatchworkelephant.
للمشاركة في عيد ميلاد فيلو – إلمر ولتفاصيل إضافية ادخلوا هذا الرابط.
نشاط مع الأهل
- نسترجع مع طفلنا خبرة تعلّم مهارةٍ جديدة، مثل ركوب الدّرّاجة، أو عبور الشّارع. ماذا دفعه إلى تعلّم هذه المهارة؟ مَنْ ساعده؟ وكيف تعلّمها؟ من الجميل أن نشارك طفلنا خبراتنا نحن في تعلّم مهارات مثل استخدام الحاسوب أو الهاتف النّقّال، وغيرها.
- نتحادث مع طفلنا حول الأمور الّتي يقدر أن يقوم بها (مثل تركيب عدد معيّن من قطع البازل، تحضير طعام بسيط، وغيرها)، وعن الأمور الّتي يرغب أن يقوم بها ولا يقدر بعد. نشير إلى أنّ العديد من القدرات تتطوّر خلال مسار النّمو، وأيضًا بالممارسة.
- تمرّ مامبا ببلادٍ ألوانها مختلفة، ومعها نرى تغيّر الفصول في الطّبيعة. ما شكل بلادٍ لونها برتقاليّ أو ليلكيّ مثلًا؟ قد يرغب طفلنا برسمها.
- الذّئبة تعوي، فماذا تفعل القطة، والعصفور، والكلب، وحيوانات أخرى؟ هذه مناسبة ليتعلّم طفلنا أصوات حيوانات مألوفة له عن طريق لعبة بطاقات صور مثلًا، أو استخدام دمى حيواناتٍ متوفّرة في البيت.
- تقصد مامبا جدّتها لتعلّمها العواء. ماذا تعلّم طفلنا من جدّته أو جدّه؟ وماذا يحبّ أن يتعلّم؟
- هل حقًا تعوي الذّئاب حين يكون القمر بدرًا فقط، كما نرى في الرّسمة الأخيرة؟ هيّا نفتّش مع طفلنا عن حقائق أوفى عن هذه الحيوانات المثيرة.
نتحادث
- نتحادث عن أسباب صعوبة مامبا في العواء. هل نستصعب نحن أيضًا القيام ببعض الأمور؟ ما هي؟ وماذا نشعر حينها؟
- نسترجع مع الأطفال المراحل الّتي تعلّمت فيها مامبا أن تعوي (راقبت الحيوانات، جرّبت أن تستخدم صوتها لتنبيه السّائق، تدرّبت على العواء مع جدّتها). نتحادث حول خبراتٍ تعلّميّة مرّ بها الأطفال، مثل ركوب الدّراجة، ربط خيطان الحذاء، وغيرها.
نتواصل
- ندعو أحد الأجداد إلى البستان ليعلّمنا مهارةً معيّنة (مثل: إعداد طعامٍ، صنع طائرة ورقيّة) أو لعبة تراثيّة، وغيرها.
- يمكن أن نعدّ رسمة قطارٍ إلكترونيّة أو من الكرتون، وفيه مقطورات بعدد وأسماء الأطفال. يسجلّ كلّ طفلٍ في مقطورته، وبمساعدة الأهل، مهارةً واحدة تعلّمها من جدّه/ جدّته. قد يرغب الأطفال بالرّسم ايضًا.
نُثري لغتنا
- القطّة تموء، والكلب يعوي. ماذا نسمّي أصوات حيواناتٍ أخرى؟ يمكن أن نعدّ لعبة من بطاقاتٍ عليها صور حيواناتٍ، فيأخذ كلّ طفل بطاقة، وعليه أن يقلّد صوت الحيوان ويقول اسمه.
- ” وصلت مامبا بلادًا بلون النّعنع”، يمكن أن نعزّز قدرة الأطفال على استخدام أسلوب الاستعارة (استعارة لون غرضٍ ما للدلالة على اللّون نفسه). نجمع أغراضًا بألوان مختلفة في كيس كبير، مثل قطع ليغو ملوّنة، ويقوم كلّ طفل بمدّ يده داخل الكيس والإمساك بغرض يراه دون أن يُريه للأطفال الآخرين. يحزّرهم على نحو: معي غرض لونه مثل لون….، وعلى الأطفال أن يحزروا اللّون.
نُبدع
- نُخطّط مع الأطفال مشروعًا في البستان. قد يكون زراعة حديقة أزهار في الخارج، أو الإعداد لحفلة في البستان بمناسبة معيّنة، أو إعادة بناء وترتيب المكتبة. نتحادث مع كلّ طفلٍ حول ما يقدر أن يقوم بفعله.
- كيف تبدو بلادٌ لونها ليلكيّ، أو أسود، أو أحمر يصلها قطار مامبا؟ قد نرغب بإعداد معرضٍ للوحات الأطفال.
نشاط مع الأهل
- القنفذ يخطو، والأرنبة تقفز، والسّنجاب ينطّ، يمكننا أن نتبادل الأدوار مع طفلنا في تقليد وتخمين مشية الحيوانات في القصّة.
- خَطْ- خطوة، قَفْ-قفزة، ماذا كان سيكتب المؤلّف لو التقى القنفذ بحلزون وبغراب؟
- نتحادث مع طفلنا حول السّؤال في نهاية القصّة: ماذا يربح وماذا يخسر إذا شارك التّفاحة مع أصدقائه، وإذا لم يشاركها؟ نحاول أن نصغي لطفلنا جيّدًا، وأن نتفهّم صعوبته في هذه السّن بإشراك الآخرين بما لديه.
- نتحادث عن لحظاتٍ نشارك فيها آخرين بما لدينا، مثل تقديم الطّعام للضّيوف، ومشاركة لعبة مع طفلٍ آخر. بماذا نشعر؟
- يخطط القنفذ لتقسيم تفّاحته إلى قطعتين، ثمّ ثلاثة، ثمّ أربعة. يمكننا أن نلفت طفلنا إلى هذه المفاهيم الحسابيّة أثناء تحضير الطّعام معًا، وأثناء اللّعب بالمعجونة (الملتينة).
- توفّر الجمل الحواريّة المتكرّرة فرصةً ممتازة لإشراك الطّفل في السّرد، إن قرأنا القصّة عدّة مرّات.
- يمكننا أيضًا أن نمثّل القصّة باستخدام دمًى متوفّرة في البيت، أو تحضير دمى عصيّ بسيطة.
- هذه مناسَبة لدعوة الجيران، أو الأصدقاء، أو الأقارب والاحتفاء بتناول وجبة مشتركة!
- طوّر هذه الاقتراحات فريق عمل في مكتبة الفانوس من وزارة التّربية والتّعليم ومن مؤسّسة غرنسبون.
نتحادث
- نتأمّل الغلاف معًا. ماذا نرى على الغلاف الأمامي؟ وماذا نرى على الغلاف الخلفي؟ هل يمكن أن نخمّن عمّا تتحدّث عنه القصّة؟
- نتحادث عن قرار القنفذ أن يقدّم تفّاحته للآخرين (أن يشارك تفّاحته). لماذا فعل ذلك؟
- تنتهي القصّة بسؤال موجّه للقرّاء. نطرح السّؤال على الأطفال ونصغي إلى إجاباتهم جيّدًا. من المهمّ ألّا نرفض أيّ إجابة.
- نتحادث عن أوقاتٍ خلال اليوم نتشارك فيه أغراضًا وألعابًا، مثل: اللّعب في ركن البناء أو اللّعب التّمثيلي، اللّعب في السّاحة بالطّابة، أو التّشارك بطعامٍ وقت الفَطور، أو التّشارك بأغراضٍ مع الإخوة في البيت. لماذا مهمّ أن نتشارك؟ ماذا نشعر حين نشارك أصدقاءنا بالألعاب، وحين يرفض أصدقاؤنا مشاركتنا؟ هل هناك أشياء أخرى يُمكن أن نشاركها مع أصدقائنا أو مربّيتنا في الرّوضة؟
نستكشف
- الأرنبة تقفز، والسّنجاب ينطّ، والفأر يثب. أيّ فعلٍ يدلّ على حركة الحيّة، أو العصفور مثلًا؟ يمكننا أن نمثّل هذه الحركات.
- يخطّط القنفذ لتقسيم التّفاحّة إلى قطعتين، ثم ثلاث قطعٍ فأربع. يمكننا أن نتدرّب على هذه المفاهيم الحسابية حين نلعب بالمعجونة أو نأكل طعامنا.
اضغطوا هنا لقراءة المقال:
نشاط مع الأهل
- نسترجع معًا المواقف الّتي مرّ بها فارس أثناء يومه، والّتي أدّت إلى إفراغ دلوه. ماذا شعر؟ نتحادث حول مواقف أخرى كان يمكن أن يصادفها فارس في البيت، وفي الشّارع، وفي المدرسة تؤدّي إلى إفراغ دلوه.
- نسترجع مع طفلنا المواقف الّتي شعر فيها أنّ دلوه يمتلئ. ماذا شعر فارس في كلّ موقف؟ هل يمكن أن نتخيّل مواقف أخرى يشعر فيها بأنّ دلوه يمتلئ؟
- كيف نشجّع ونساعد الآخرين في حياتنا اليوميّة؟ نتحادث مع طفلنا حول ما يقوم به وما يمكن أن يقوم به في سبيل ذلك.
- “نحن عائلة تملأ دِلاءَها” عنوان لورقة كبيرة يمكن أن يسجّل فيها أفراد العائلة أعمالًا وأقوالًا تساعدهم في ملء دلائهم، مثل قول كلمة شكرًا، المساعدة في المهامّ المنزليّة، المشاركة بين الإخوة بالألعاب، وغيرها.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- في القراءة الأولى نتوقّف عند الغلاف، ونشجّع التّلاميذ على التّفكير بماذا يمكن أن يمتلئ دلو فارس؟ وكيف يمكن أن يملأه. نحاول أثناء القراءة أن نستخدم نبرات صوتٍ مختلفة للإشارة إلى الشّخصيات.
- نسترجع معًا الأعمال الّتي ملأت دلو فارس، وأخرى أفرغته. ماذا يمكن أيضًا أن يملأ وأن يفرغ دلوه؟
- نتحادث مع التّلاميذ حول مشاعر فارس حين أساء إليه الآخرون. هل نشعر نحن ايضًا أحيانًا بمشاعر مشابهة، متى؟
- يمكن أن يصمّم كلّ تلميذٍ دلوًا صغيرًا (من خردة بلاستيكيّة يحضرها من البيت) على هيئة حصّالة ويزيّنها، ويحملها معه إلى البيت. وحين يمرّ عليه حدثٌ يُشعره بالبهجة، يُلقي في الدّلو غرضًا صغيرًا، مثل حصوة أو خرزة وما شابه، ويوثّق ذلك بمساعدة أهله. مَن يرغب من التّلاميذ يمكنه أن يُحضر دلوه إلى الصّفّ ليشارك زملاءه بأحداثٍ ساهمت في ملء دلوه.
- يمكن أن نوظّف القصّة بيوم الأعمال الطّيّبة في المدرسة/ الحيّ/ إطار مجتمعيّ آخر، ونملأ دلو الصّف بناءً عليها. قد يرغب التّلاميذ بعرض دلو صفّهم والحديث عنه أمام تلاميذ الصّفوف الأخرى لتشجيعهم على السّير على خطاهم.
- يمكن أن نعرّف التّلاميذ على قصص أخرى تتناول موضوعًا مشابهًا مثل قصّة “بينوكيو” -اللّعبة الخشبيّة الّتي يطول أنفها حين تكذب، وقصّة عصفورة النّفس الّتي تكبر حين يعانقها أحدٌ ما.
- يرفض فارس أن تشاركه أخته في اللّعب بدعوى أنّها صغيرة. هذه مناسبة للحديث مع التّلاميذ حول المواقف الّتي يشعرون فيها أنّهم كبارٌ، وأخرى يشعرون فيها أنّهم صغارٌ.
- يتعلّم فارس من جدّه قيمةً جميلة. نتحادث مع التّلاميذ حول أمورٍ يفتخرون بأنّهم تعلّموها من أجدادهم.
- نقفز بين اللّغتين: المعياريّة والمحكيّة. قد نعرض للتّلاميذ كلماتٍ وردت في النّصّ مثل: حافلة، رقائق القمح، دلو، مقعد الدّراسة، حقيبة، تعثّر، صفّق، وغيرها، ونشجّعهم على التّفكير بكلماتٍ مرادفة بالعامّيّة.
- “طَق” هو صوت قطرة الماء حين تسقط في الدّلو. ماذا يمكن أن يكون صوت: سيّارة الإسعاف، الجرس، الرّيح في الشّتاء، الهرّة السّعيدة، وغيرها. من المحفّز أن نحثّ إبداع التّلاميذ بتخيّل أصواتٍ لأفعال لا صوت لها. ماذا يمكن أن يكون صوت الشّمس حين تشرق في الصّباح، أو صوت الدّمعة حين تسيل من عيننا؟
- الضّخماصور هو الدّيناصور الضّخم. ماذا يمكن أن نسمّي: السّاحرة الشّريرة، البائع المتجوّل، التّنّين النّاري، وغيرها؟
ساعة قصة
نشاط مع الأهل
- بعد قراءة القصّة مع طفلنا، يمكن أن نغمض أعيننا ويسترجع كلّ واحدٍ منّا الرّائحة أو الرّوائح الّتي تذكرّه بالآخر. أيّة روائح ترتبط في ذاكرتنا بأفراد العائلة الآخرين؟
- ترتبط الأماكن أيضًا في ذاكرتنا بروائح معيّنة. أيّة رائحة نشمّها حين نتذكّر البيت، أو البستان، أو بيت الجدّ، أو أحد الأصدقاء؟
- نتحادث عن روائح يحبّها طفلنا في البيت، وأخرى لا يحبّها، وقد يرغب برسم مصادرها. كيف يمكن أن نجعل روائح البيت أحلى؟
- شو بحبّ أعمل أنا وماما سوا؟ قد نرغب بإعداد قائمةٍ مرسومة نعلّقها في مكان ما في البيت، ونختار كلّ أسبوعٍ نشاطًا نقوم به معًا.
- كيف نختار هديّة لشخصٍ نحبّه؟ نتحادث عن أمورٍ نأخذها بعين الاعتبار حين نختار الهديّة، مثل: ذوق الشّخص، واهتماماته، وحاجاته، وغيرها.
- “رائحة ابي/ جدّي/جدّتي/أختي/أخي” قد يكون عنوانًا لكتابٍ جميل نساعد طفلنا في تأليفه ورسمه.
- “ما هذه الرّائحة؟” لعبة ظريفة يمكن أن يشترك بها جميع أفراد العائلة. نجمع أغراضًا مختلفة (أطعمة، نباتات…) ونغمض عينيّ أحدهم، وعليه أن يستدلّ بحاسّة الشّمّ فقط على مصدر الرّائحة.
الفانوس اللّغويّ
في المنهج:
أطفال 5-6: يوسّعون قاموسهم اللغويّ بكلمات متنوّعة ومجردة من عوالم مضامين مختلفة، يصنّفون ويعرفون كلمات من حيث البعد الدلاليّ والوظيفيّ، ينتجون بشكلٍ حدسيّ كلماتٍ مختلفةً حسب صلتها بالجذر والوزن الصرفيّ، يتعرّفون على ظروف المكان والزمان ويستعملونها بشكل صحيح، يربطون بين أسماء بعض الحروف وأشكالها، يكتبون كلماتٍ بكتابة صوتيّة جزئيّة”.
حفل الكلمات:
حصّالة- نقود- حديقة- تربة نديّة- محتار- رحّبت- مشتعل- منعش- قوارير- طازج- شهية- لذيذ- اقترحَت- بلهفة- تسلّلت- ربما- قضم.
- نتعرّف على المفردات والصياغات الجديدة، ونشرح معناها. قد نحضّر مع الأطفال ركنًا للاحتفاء بالكلمات الجديدة، ونبرزها مع صور أو رسومات أو تداعيات تتعلق بها.
- نتعرف على الكلمات: “نقود، حصّالة، شاقل”. هي فرصة للتعرف على أنواع العملات وقيمتها.
- نتعرف على كلمة “محتار” ونتحدث عن مواقف نشعر فيها بالحيرة. قد نمثل بأجسادنا تعابير تدل على الحيرة.
- نتعرف على الأوصاف والنعوت، نميّز الأوصاف المتعلقة بالأطعمة والروائح (شهية/ لذيذ/ طازج)، نتحدث عن استعمالاتها. نقترح أوصافًا أخرى نعرفها.
- “رحّبت البائعة بماجد” نتحدث عن التحيات وطرق الترحيب (أهلاً وسهلاً- صباح النور- يا مرحبا) وغيرها. نشدّد على القيمة التربوية الاجتماعية للحفاوة. قد نعرّف الأطفال على أمثال وأهازيج شعبية عن إكرام الضيف لتعزيز القيمة الاجتماعية. قد نؤدّي لعبًا تمثيليًّا ونشاهد كيف يعبّر كل طفل عن الترحيب بصديقه/ أو الترحيب بفكرة تناسبه.
- “قوارير” كلمة جديدة، ما أوصافها؟ نتعرف على أنواع الأوعية وأنواع القوارير، ونصنفها وفق الأحجام/ وفق المواد المصنوعة منها أو أي معيار يحدده الأطفال.
- ماذا لو راقبنا حديقة البستان وتأملنا التربة والمزروعات؟ هي فرصة للاستمتاع بالروائح المنعشة وإغناء قاموس الأطفال بأوصافها، إضافة إلى تعزيز القيم البيئية والمحافظة على الطبيعة.
تساهم هذه الأنشطة في إثراء قاموس الطفل، وتوسيع معرفته العامة والمعرفة الميتا لغوية، إضافةً إلى مهارات الوصف والمقارنة.
تعالوا نتحدث:
- نتحدث عن الأشخاص الذين نحبهم: هل يذكّرنا أحدهم برائحة ما؟ أية روائح نحب وبماذا تتميز هذه الروائح؟
- قد نتشمّم أشياء من موجودات البستان (توابل من الحديقة، ثمارًا وفواكه، ألعابًا وغيرها)، ونحاول أن نصف روائحها. نلعب ألعابًا للتخمين، ونحاول معرفة ما نشمّه من رائحته.
- نتحدث عن الهدايا، نقترح هدية نحبّ أن نقدّمها للماما أو لشخص نحبه: عمَّ تعبر الهدايا؟ لماذا نقدمها؟
- نتحدّث عن الادّخار والتوفير، كيف يمكن أن ندّخر نقودنا؟ نتحدّث عن البيع والشراء والقيم الاستهلاكية: أشياء نرغب بشرائها، أشياء نحتاج لها ولا نملك ثمنها، إلخ.
- نتخيل روائح أخرى كان يمكن أن يتذكرها ماجد، ونقترح لها أوصافًا.
- تساهم هذه الحوارات في تنمية التعبير الشخصي للطفل ومهارات التفكير الإبداعيّ.
الكفايات اللغويّة:
- نتعرف على التشبيه وإمكانيات التعبير عنه، ونقترح صيَغًا لذلك. نصف أشياء ونشبّهها بما تذكّرنا به. قد نستعمل صيَغًا من المحكية أو المعيارية ونستذكر صيَغًا تعرّفنا إليها في كتب سابقة.
- نفكر بعبارات نرفقها بالهدية: ماذا يحبّ كل طفل أن يقول لأمه؟ قد نحضّر نماذج لبطاقات تهنئة ونختار العبارات الملائمة.
- تساهم هذه الأنشطة في تنمية مهارات الوصف والمقارنة وتعزيز القيم الاجتماعية. والإنسانية
الوعي الصرفيّ:
- نلاحظ الفرق بين صيَغ المذكر (ماجد) والمؤنث (الأم/ البائعة). نلعب مع التصريف. قد نؤدي المشاهد وننتبه لتصريف الأفعال والضمائر مع كل من الشخصيات. يمكن أن نحضّر مساحتين واحدة للمذكر وأخرى للمؤنث، وننتقل بينها مع الأفعال الملائمة.
الوعي الصوتيّ ومعرفة الحروف:
- نستثمر تحضير البطاقات لنتيح للأطفال كتابة كلمات بطريقة الكتابة الصوتية، نقسم الكلمة إلى فونيمات ونختار من مسطرة الحروف الحرفَ الملائم لكل صوت. نشدد على الملاءمة بين اسم الحرف وصوته وصورته.
ماذا أيضًا:
- قد يفكر كل طفل في تحضير هدية رمزية لأمه/ لجدّته/ لأحد أفراد العائلة، أو لصديق من البستان. هي فرصة لتعزيز التعبير الشخصي بسماع اقتراحات الأطفال ومساعدتهم في تنفيذها أو التصويت على اقتراح يلائم عددا أكبر من الأطفال. نتحدث عن المواد والأدوات اللازمة. نتحدث عن مشاعرنا في تحضير الهدايا أو تلقّيها. نتحدث عن قيمة الهدايا ومعناها وما تعبر عنه، نكتب كلمات وجملاً بوساطة المربية مع توضيح أسس الكتابة.
- قد نطوّر ركن البيع والشراء في البستان، نحضّر قائمة بالأسعار، نحضّر إعلانًا مع الأطفال. قد نبتكر جملًا مسجوعة للإعلانات مع التركيز على الأوصاف والمعايير الملائمة للأغراض. نحدد مع الأطفال القوانين الملائمة للركن، ونتيح لهم التمرس باستعمال النقود. يساهم مثل هذا النشاط في تنمية القيم الاجتماعية واحترام الدور والأمانة.
عملًا ممتعًا
أنوار الأنوار- المرشدة المركّزة للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع طفلنا حول شعور زياد حين عجز عن الانضمام لأقرانه في المدرسة. هل حدث وأن مرّ طفلنا بخبرة مشابهة، بماذا شعر؟
- نتحادث مع طفلنا حول محاولة زياد في الوصول إلى المدرسة بقوى ذاته. أّية مصاعب واجهته؟ ماذا كان يمكن أن يسهّل وصوله إلى المدرسة دون أن يطير؟
- تنتهي القصّة بسؤالٍ مفتوح. ماذا يخطّط زياد مع والده؟
- في النّهاية استطاع زياد أن يطير بفضل الجناحين المعدنيّين. نفكّر في أشخاص يعيشون معنا، وفي مجتمعنا ممّن يستصعبون الحركة، مثل المسنّين أو المُقعدين أو الكفيفين. أيّة وسائل مُتاحة لهم تسّهل عليهم التّنقّل والعيش؟
- نصطحب طفلنا في جولة في شوارع بلدتنا وفي بعض المؤسّسات العامّة، مثل المراكز الصّحيّة، والمصارف، وغيرها. نبحث معًا عن وسائل تسهّل على الأشخاص محدودي الحركة التّنقّل واستخدام المرافق العامّة، مثل الصّوت العالي الّذي ينبّه المكفوفين إلى تغيير الشّارة الضّوئية، أو مطلع للكرسي المتحرّك في مداخل البنايات، أو مصفّ سيّارة خاصّ بمحدودي الحركة، وغيرها. هل “ترى” بلدتنا هؤلاء الأشخاص؟
- قد نرغب بأن ننضمّ إلى زياد ووالده في التّخطيط لأجل تسهيل حركة هؤلاء الأشخاص في بلدتنا. سيكون جميلًا إذا وثّق طفلنا المخطّطات بالكلمة المكتوبة وبالرّسمة، وشاركها مع أولاد صفّه.
- لو قُيّض لنا أن نضع جناحين ونطير، إلى أين نتّجه؟ ومن نأخذ معنا؟
- هل يستطيع الإنسان أن يطير بجناحين؟ سؤال علميّ مثير يُشغل بال العديد من الأطفال، وهو مناسبة لأن نسترجع مع طفلنا تاريخ الطّيران، بدءًا من محاولات العربيّ عبّاس بن فرناس الطّيران بجناحين، إلى الإخوان رايت ومن بعدهما.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- قبل القراءة الأولى، ادعي التّلاميذ إلى تأمّل غلاف الكتاب: ما الأمور الغريبة الّتي يلاحظونها في الرّسومات؟ ماذا تخبّرنا وضعية جسم زياد ووجه دبدوبه عن مشاعره؟ ما معنى كلمة نورس، ولماذا برأيهم سُمّيَ الجبل الّذي يجلس زياد على إحدى قممه بجبل النّورس؟
- في النّصّ عدد من الكلمات الّتي قد تكون جديدة على مسامع التّلاميذ. يمكن أن تفسّري لهم هذه الكلمات باستخدام حركات الجسم، أو نبرة الصّوت، أو الرّسومات. نورد على سبيل المثال كلمة “طًوف” الّذي تظهر رسمته في صفحة 15، أو الفعل “أدغدغه” في الصّفحة 4. حين ترتبط الكلمة الجديدة الّتي سمعها الطّفل برسمة أو بحركة أو صوت، وفي سياق قصصيّ، تنغرس في ذهنه. لا بديل بالطّبع عن تفسير بعض الكلمات أو التّعابير، مثل: يشعر بالغصّة في حلقه (ص 11) تحامل على نفسه أو وجد مشقّة (ص 15).
- تحادثي مع التّلاميذ حول مشاعر زياد حين أدرك أنّه ليس كباقي الأطفال. هل حدث وأن أحسّوا بمشاعر مشابهة؟
- تتبّعي مع التّلاميذ مبادرة زياد للوصول على المدرسة. أيّ عقبات اعترضت طريقه؟ هل كانوا سيتصرّفون مثله؟
- ينضمّ زياد إلى أولاد صفّه بفضل جناحَين يبنيهما بمساعدة والديه وصديقته سارة وأمّها. ادعي التّلاميذ إلى التّفكير بأشخاصٍ محدودي الحركة في مجتمعنا، ويستخدمون وسائل تساعدهم على التّنقّل وتلبية حاجاتهم، مثل: كرسيّ العجلات.
- تنتهي القصّة بتساؤلٍ حول ما يبنيه زياد وأبوه. شجّعي التّلاميذ على التّفكير بإجاباتٍ على السّؤال.
- شجّعي التّلاميذ على تفحّص الأماكن العامّة في البلدة الّتي يعيشونها، مثل المجمّع التّجاري، وملاعب الأطفال، والشّوارع. هل هناك تسهيلات للأشخاص محدودي الحركة توفّرها السّلطات المحلّيّة، مثل: معابر مائلة في مداخل البنايات، مصاعد كهربائيّة، ألعاب خاصّة للأطفال محدودي الحركة، إشارات صوتيّة على معابر المشاة تساعد الكفيفين على عبور الشّارع، مواقف سيارات خاصّة، وغيرها؟ ماذا بشأن مدرستهم؟
- بناءً على البحث الّذي قام به التّلاميذ بمساعدة أهلهم، شجّعيهم على التّفكير بطرقٍ ممكنة تسهّل تنقّل الأشخاص محدودي الحركة في الحيّز العامّ. يمكن أن يرسم التّلاميذ أفكارهم، وأن يكتبوا عنها بلغتهم. من الجميل أن يعرض التّلاميذ أعمالهم في المدرسة ليساهموا في رفع وعي أقرانهم لهذا الموضوع.
- يمكن أن تُعدّي ورشة (ربّما بمساعدة الأهل) لبناء طائراتٍ ورقيّة.
- يجذب عالم الطّيران الأطفال، وهذه مناسبة للحوار معهم حول تاريخ طيران الإنسان، وربّما زيارة متحفٍ مثل متحف العلوم في حيفا والتّمتّع بالعرض وبالفعاليات التّي يقدّمها في موضوع الطّيران.
نشاط مع الأهل
- بعد قراءة الكتاب معًا، نستعيد مع طفلنا حوادث السّير الجويّة الّتي مرّ بها فيني وفلّيني. بماذا كان يمكن أن يصطدما أيضًا وهما يطيران؟
- بعصاها السّحريّة حوّلت فيني مكنستها إلى وسائل نقلٍ مختلفة. قد يرغب طفلنا بالتّلويح بعصًا صغيرة وبالهتاف: “آبرا كادابرا!”وتحويل المكنسة إلى وسيلة نقلٍ جديدة تستخدمها فيني. ماذا سيحدث لها هذه المرّة؟
- على الرّغم من الكوارث الصّغيرة التّي مرّت بها فيني، لكنّها لم تيأس، وبقيت معنويّاتها عالية. نتحادث مع طفلنا حول خبرة مشابهة مرّ بها. كيف تصرّف؟ وماذا يمكن أن يساعده في مواقف كهذه؟
- عانت فيني من ضعفٍ في نظرها سبّب لها كلّ هذه الحوادث. إذا كان طفلنا يضع نظّارة طبّية، نتحادث معه حول سلوكه وشعوره حين يتجوّل في البيت أو المدرسة بدون نظّارة، ومعها. يمكن أن نصمّم مع طفلنا نظّارة كرتونيّة بعدستين من ورق السيلوفان. كيف يبدو لنا العالم حين يتشوش نظرنا؟ ماذا نشعر؟
- يشهد عالم اليوم ارتفاعًا حادًّا في نسبة الأطفال في العالم الّذين يعانون من ضعفٍ في النّظر، يردّه الأطّباء إلى السّاعات الطّويلة الّتي يقضيها الأطفال أمام شاشات الأجهزة الإلكترونيّة. هذه مناسبة للتّحادث مع طفلنا عن هذه المخاطر، والاتّفاق على سلوكيّات تقي نظر طفلنا، مثل: زيادة ساعات اللعب والنّشاط خارج المنزل، تحديد ساعات استعمال الهاتف النّقال والألعاب الإلكترونيّة، النّوم لساعات كافية، وغيرها.
- طائرة، صاروخ، منطاد، حصان، لوح تزلّج ودرّاجة، هي بعض وسائل النّقل الّتي استخدمتها فيني. أيّ وسائل نقلٍ برّيّة، وبحريّة، وجوّيّة أخرى يعرفها طفلنا؟
- تمتاز رسومات الكتاب بتفاصيلها الكثيرة والمضحكة. ندعوكم للتّمتع مع طفلكم بتأمّل الرّسومات والتّحادث حولها: من يسكن في البرج العالي الّذي اصطدمت به فلّيني؟ ماذا تخبّرنا ملابس الرّجل ذي العمامة في صفحة 18 عنه؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- استرجعي مع التّلاميذ حوادث “السّير” الّتي اعترضت طريق فيني. ما الّذي سبّبها كلّ مرّة؟
- ادعي التّلاميذ إلى تأمّل وسائل النّقل الجوّيّة في الصّفحات الأولى من الكتاب وتسميتها. هل هناك وسائل أخرى كان يمكن أن تعترض طريق فيني؟ لو أردنا وضع إشارات سيرٍ في السّماء، كيف سيكون شكلها؟
- شجّعي التّلاميذ على اقتراح وسيلة نقل أخرى غريبة كان يمكن أن تستخدمها فيني للوصول إلى بيتها، وتخيّل ما يمكن أن يحدث لها. قد يرغب التّلاميذ أوّلًا بالتّلويح بعصاهم وقول كلمة السّحر: آبرا كادابرا!”
- تحادثي مع التّلاميذ حول أزمة السّير في بلدتهم. ما هي أسبابها وتأثيراتها على حياة النّاس؟ ادعي التّلاميذ إلى التّفكير بحلول تخفّف من أزمة السّير في بلدتهم، قد يرغبون برسمها ومشاركتها مع زملائهم في الصّفّ.
- ترى فيني العالم على نحوٍ غير واضح. تُرى كيف سيبدو العالم بعيوننا لو استخدمنا نظّاراتٍ من ورق سيلوفان ملوّن؟
- يزداد عدد الأطفال الّذين يعانون من ضعفٍ من النّظر نتيجةً لاستخدام الحاسوب والهواتف النّقّالة لساعاتٍ طويلة. هذه مناسبة للتّحادث مع التّلاميذ حول الاستخدام الآمن لهذه الأجهزة، وطرق الحفاظ على أعينهم من مشاكل في النّظر.
- يستمتع الأطفال في هذا العمر بحفظ النّكات وروايتها، وقد يرغبون بتأليف كتاب نكتٍ يرفقون نصوصه برسوماتهم. من الممتع أن يفكّروا بمشاركة هذه النّكات مع تلاميذ مدرستهم، مثل تنظيم “يوم النّكات” أو “يوم الضّحك” في المدرسة.
- تساهم رسومات الكتاب المضحكة في إضفاء جوّ المرح عليه. يمكن أن تطلبي من التّلاميذ التأمّل في كلّ رسمة والحديث عمّا يضحكهم فيها.
- هل يعرف تلاميذك كتبًا أو أفلامًا أو مسلسلات تلفزيونيّة أبطالها سحرة؟ ما الفرق بينهم وبين صديقتنا فيني؟
- ورشة لتصميم قبّعة فيني. . تجدين في هذا الرّابط نماذج جاهزة لتصميم قبّعة السّاحرة. يمكن أيضًا تصميم قبّعاتٍ ترتبط بهنٍ معيّنة مثل: قبّعة الشّرطيّ والطّبّاخ، ولعب أدوار أصحاب القبّعات.
- يمكن أن يتتبّع التّلاميذ مسار فيني أثناء عودتها إلى بيتها. أية أماكن أخرى كان يمكنها أن تمرّ بها في مدينة السّحرة؟ قد يرغب التّلاميذ في رسم هذه الأماكن.
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا رسومات الرّيح، ونبحث عن مظاهر هبوبها. ننظر معًا من النّافذة: هل تهبّ الرّيح في هذه اللّحظة؟ ماذا تفعل؟
- بعض النّاس يحبّون الجوّ الحارّ وآخرون يفضّلون الجوّ البارد. ماذا نحبّ أن نفعل في الأيّام الحارّة؟ وبماذا نستمتع في الأيّام الباردة؟
- يمكننا أن نمسرح القصّة ونعرضها على أفراد العائلة والأصدقاء. كيف سيبدو قناع الشّمس وقناع الرّيح؟
- قد نرغب بأن نستكشف مع طفلنا تأثير الرّيح على أغراضٍ مختلفة. ننفخ على حجر، ورقة، ريشة، وملعقة. أيّ الأغراض تطير بسهولة؟ وأيها لا تتحرّك، أو تتحرّك بصعوبة؟ لماذا؟
- نستذكر معًا مواقف من يومنا تصرّفنا فيها مثل الرّيح، وأخرى مثل الشّمس. ماذا كانت نتيجة كلّ تصرّف؟
- ما الّذي يدلّنا في الرّسومات على أنّ الحكاية قديمة؟ هل نعرف مدنًا تشبه المدينة في الكتاب؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- في القراءة الأولى، يمكن أن تتوقّفي عند نهاية النّص في صفحة 8(ولكن، لتحاول كلّ واحدة منّا أن تقوم بذلك. تفضّلي، حاولي أنت أوّلًا). شجّعي الأطفال على تخمين ما قد يحدث حين تحاول كلّ منهما.
- يمتاز النّصّ بسهولة مسرحته. يمكن أن تشجّعي الأطفال على تمثيل القصّة بأن تُغني زاوية اللّعب التّمثيلي بأغراضٍ ترتبط بالقصّة، مثل: عباءة، تيجان على هيئة شمس وريح، مروحة كهربائيّة، عصا بهيئة رأس حصان، وغيرها.
- يمكن أن تعرضي على الأطفال مواقف تحدث في البستان أو في البيت (مثلًا: حين يرغب طفلٌ باللّعب بالدّراجة في السّاحة في الوقت الّذي يرغب آخر باللّعب بنفس الدّراجة، أو حين تريد الطّفلة أن تجلس إلى جانب أبيها في البيت ويسبقها أخوها…) كيف يتصرّف الأطفال في هذه المواقف لو كانوا “شمسًا” أو كانوا “ريحًا”؟ قد ترغبين بتشجيع الأطفال على مشاركة مواقف تصرّفوا فيها كالشّمس في رقّتها، وحصلوا على مبتغاهم.
- ادعي الأطفال إلى تأمّل الرّسومات ووصف مظاهر اليوم العاصف واليوم الحارّ. يمكن أن توزّعي عليهم قطعة كرتون في منتصفها خطّ، وأن تطلبي منهم أن يصفوا بالمعجونة أو بالرّسم كيف يبدو اليوم العاصف واليوم الحارّ. من المثير أن تعلّقي أعمال الأطفال على الحائط ليخمّنوا أيّ من الرّسومات تدلّ على كلّ يوم.
- تندرج هذه القصّة ضمن الصّنف الأدبيّ المدعوّ بالأمثولة. نعرف من هذا النّوع حكايات كليلة ودمنة، وحكايات لافونتين، وأمثال إيسوب الإغريقي. أصدرنا في مكتبة الفانوس عددًا من الكتب الّتي تنتمي لهذا الصّنف، مثل: من يتحدّى الأرنب؟ ملك الغابة، الخالة زركشات تبيع القبّعات، من يقرع الجرس؟ الفأر وأصدقاؤه الثّلاثة. يمكن أن تستعيدي بعض هذه القصص مع الأطفال، وتتحادثي معهم حول حكايات الأمثولة.
- يمكن أن تعدّي لعبة حركيّة بعنوان “الشّمس وريح الشّمال”. حين يسمع الأطفال كلمة “ريح الشّمال” عليهم أن يسيروا في الغرفة وهم يقلّدون ريح الشّمال، وحين يسمعون كلمة “شمس” عليهم أن يتصرّفوا برقّة مثل دفء الشّمس. يمكن أن تستعيني بموسيقى ملائمة، وبأغراضٍ مثل قبّعة صوفيّة وشال، أو قبّعة شمس ونظّاراتٍ شمسيّة، وغيرها.
- ادعي الأطفال إلى تأمّل الرّسومات. ما الّذي يدلّنا على أنّ القصّة قد حدثت قديمًا؟ هل تشبه المدينة المرسومة في القصّة مدنًا أخرى نعرفها (مثل يافا، عكّا والقدس المحاطة بالأسوار)؟
- كيف يمكننا أن نقيس سرعة الرّيح؟ هذه مناسبة لأن يتمتّع الأطفال وأهاليهم بورشة صنع “دولاب هواء/ مروحة ورقيّة” يركض بها الأطفال في مكان واسعٍ. يمكنك أن تجدي وصفًا لصنعها في هذا الفيلم.
الفانوس اللّغويّ
في الكتاب:
- النصّ قصصيّ ومترجم، ويُوضح العلاقة بين الإنسان والطبيعة وحالات الجوّ إضافةً للمساحة الاجتماعية حول الهدوء والغضب أو القوة.
في المنهج:
- الأطفال في جيل 5-6 سنوات: “يصنّفون ويعرفون كلماتٍ من حيث البُعد الدلاليّ والوظيفيّ/ يستعملون صفاتٍ متنوّعةً لوصف مفاهيم محسوسة/ يُظهرون تفضيلاتٍ لكتبٍ ومؤلفين وموضوعاتٍ معينةٍ وأنواعٍ أدبية/ يُنتجون قصصًا من سلسلة صورٍ ويصفون أحداثًا مختلفةً مع استعمال صلة السبب والنتيجة والتعبيرات الوصفيّة والتعبير عن موقف.
القاموس اللغويّ: حفل الكلمات:
فارس/ عباءة/ يبدو فرحًا/ هبّت/ عصفت/ هاجت/ هتفَت/ أرسلت دفئَها/ طنّت/ غرّدت/ استلقت/ خلَعَ ملابسه/ شمال.
- نتعرّف إلى المفردات، ونوضح معانيها: في أيّ سياقٍ نستعملها؟ نعرض صورتها المكتوبة. قد نبحث عن كلماتٍ تشبهها من نفس الجذر.
- نتعرّف إلى كلمة “فارس” ونبحث عن علاقتها بالفرس. ننتبه أنها كلمةٌ مرتبطةٌ بالحكايات القديمة. بماذا نستبدلها اليوم وماذا حلّ محلّ الفرس والفارس؟ فرصة للتحدث عن وسائل النقل المتنوعة.
- نتعرّف إلى المفردات الملائمة للريح (هبّت/ عصفت/ هاجت) ونقارن بينها من حيث شدّتها. قد نلعب ألعابًا تمثيليّةً للتعبير عنها مرةً بحركاتٍ خفيفةٍ أو بطيئةٍ ومرةً بقوّةٍ وشدّة. نغيّر قوّة حركتنا مع الموسيقى والكلمات، ونضيف أصواتًا ملائمةً للتعبير عن شدة الهبوب.
- “أرسلت دفئها” وصفٌ أدبيّ لسطوع الشمس. أية أوصافٍ أدبية أخرى نتذكر من قصصٍ سابقةٍ؟ قد نبتكر أوصافًا مجازيةً تُثري لغة الأطفال.
- “طنّت الحشرات وغرّدت العصافير”، لنبحث عن أوصافٍ أخرى لمجموعاتٍ دلاليةٍ. بماذا قد نصف انطلاق الحيوانات مثلًا؟
تعالوا نتحدث:
- نتحدّث عن تأثّرنا بحالات الجوّ المختلفة. هذا العام امتدّ الشتاء والمطر، ماذا فعلنا مع ظهور الربيع والدفء والشمس؟ نتحدّث عن الجو في الفصول المختلفة وتأثّر الطبيعة والإنسان فيه.
- نتحدّث عن الهدوء والغضب وخبراتنا معه: كيف نستجيب لتوجّه أحدهم لنا بأسلوبٍ معيّن وماذا نشعر مع كل أسلوب؟
- نتحدّث عن الأجواء الشعبية للحكايا القديمة/ عن الفارس والعباءة ومميزات أخرى نجدها في الحكايات.
- نتحدث عن الترجمة من لغاتٍ أخرى. أية لغاتٍ نعرف؟ قد نقول التحية مثلا بالعربية والعبرية والإنجليزية. نتحدث عن الفرق بين القصص المترجمة وبين المكتوبة بالعربية، ربما ننتبه أن الرسومات مختلفة تبعًا للبلدان. أية قصص أخرى مترجمة تعلمنا؟ قد نصنف مجموعة كتبٍ إلى عربية ومترجمة.
الوعي الصّرفيّ:
- نتعرّف إلى كلمة فارس/ فرس، طارت/ طيّرت، نكتشف العلاقة بينها ونلعب ألعابًا اشتقاقيّةً من نفس الجذر. قد نحضّر مجموعة أغراضٍ أو صورٍ ونبحث عن كلماتٍ تشترك معها بنفس الجذر.
الوعي الصوتيّ وبدايات القراءة والكتابة:
- يبرز في القصة الحرف “تاء” في الصيَغ المؤنثة. نتعرّف إلى الحرف وصوته. نتعرّف على كلمات أخرى تبدأ أو تنتهي به. نميّز النغمات الأخيرة من الكلمات. قد نلعب ألعابًا للحزازير الصوتيةً مثل :
معي كلمة تبدأ بالصوت عَ وتنتهي بالصوت “تْ”، ما هي؟
الكفايات اللغويّة:
- الريح الشمالية أو الغربية/ تتعدد التسميات وفق الجهات. فرصةٌ للتعرف على الجهات وتعزيز الإدراك المكانيّ. نتعرّف إلى الجهات، ونتحرّك في المكان وفق التعليمات.
- لتنمية القدرة على إنتاج قصة من صور، نحضّر بطاقاتٍ مع صوَرٍ لحالاتٍ جويّةٍ مختلفةٍ وأشخاصٍ معها، يرتب الأطفال الصورَ وفق التسلسل المنطقيّ للأحداث، وينتج كلّ طفلٍ قصةً حول مجموعةٍ من الصور. ننبّههم إلى علاقة السبب والنتيجة، ظروف الزمان والمكان، وغيرها. يمكن إنتاج القصص ورقيّةً أو محَوسبةً.
ماذا أيضًا:
- قد نضيف بعض الكتابات من الأطفال إلى القصص التي أنتجوها، بوساطة المربية وتنبيههم على مهارات الوعي الصوتيّ، ونعدّ كتيّبًا من إنتاجهم نضيفه إلى المكتبة.
عملًا ممتعًا
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.
نشاط مع الأهل
- نسترجع معًا ما قام به الملك والملكة وأهل القصر من محاولاتٍ لمساعدة الأمير على النّوم. أيّ من هذه المحاولات أحبّ طفلنا؟ قد يرغب باقتراحٍ طرقٍ أخرى على أهل القصر.
- نتحادث عن صعوبة النّوم الّتي يواجهها طفلنا أحيانًا ونواجهها نحن الكبار. ما الّذي يسبّبها؟ نفكّر معًا في طرقٍ نساعد بها أنفسنا على الاسترخاء في السّرير، مثل: تعتيم الغرفة قليلًا، أو النّوم في مكانٍ بعيد عن الضّجة، أو قراءة كتابٍ معًا.
- لماذا مهمّ أن ننام؟ وماذا يحدث لنا إذا لم ننم ساعاتٍ كافية؟ نحاول أن نربط ذلك مع خبرة الطّفل الحياتيّة.
- نستذكر معًا طقوس الاستعداد للنّوم لدى كلّ فردٍ من أفراد العائلة، مثل: احتساء مشروب ساخن، أو مشاهدة التّلفاز، أو قراءة كتابٍ.
- تطلب العجوز من الأمير الصّغير أن يغمض عينيه، وأن يتخيّل أحداث القصّة. سيكون ممتعًا أن نقرأ هذه القصّة لطفلنا وهو مُغمض العينين! هل رأى شخصياتٍ مختلفة عمّا في رسومات القصّة؟
- ” كيف نام….؟” قد يكون عنوانًا لكتابٍ ظريف يؤلّفه ويرسمه طفلنا، عن خبرةٍ شخصيّةٍ عاشها حين استصعب أن ينام ذات ليلة.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- في القراءة الأولى، توقّفي عند عنوان الكتاب، وشجّعي الأطفال على تخمين إجاباتٍ للسّؤال. يمكن أن تكون هذه المحادثة مدخلاً شيّقًا لقراءة الكتاب معًا.
- في القراءة الأولى يمكن أن تشوّقي الأطفال بأن تضعي بجانبك سلّة فيها نسخة من هذا الكتاب، وتغطّيها. توقّفي عند صفحة 29 بعد جملة ” أخرجت العجوز من سلّتها…” ومدّي يدك إلى السّلة ليخمّن الأطفال ” الحلّ المدهش”، ثمّ تابعي القراءة!
- استرجعي مع الأطفال ما قام به الملك وأهل القصر والزّوّار من أفعال لمساعدة الأمير على النّوم. لماذا لم تساعد هذه الأفعال الأمير على النّوم؟ شجّعيهم على التّفكير باقتراحاتٍ أخرى.
- تحادثي مع الأطفال حول طقوس نومهم. كيف يحبّون أن يناموا؟ لماذا نستصعب كلّنا أحيانًا أن ننام؟ وماذا يمكن أن يساعدنا؟ شجّعي الأطفال على مشاركة خبراتٍ عينيّة من حياتهم.
- أعدّي ورشة كتابة إبداعيّة مع الأهل وأطفالهم، بعنوان: كيف ينام (اسم الطّفل/الطّفلة)؟ يمكن أن يعدّ الطّفل مع أهله كتابه الخاصّ ويقوم برسمه.
- خذي الأطفال في رحلة خياليّة يزورون فيها مكانًا خاصًّا وعيونهم مغمضة. اطلبي منهم أن يتخيّلوا المكان والشّخصيات أثناء السّرد، وأن يشاركوا ما رأوا مع الآخرين. هذا مدخل جميل للحديث مع الأطفال حول وظيفة الرّسومات في الكتاب، فهي تعبيرٌ عمّا تخيّله الرسّام وهو يقرأ النّصّ.
- ندعوك لقراءة “القاموس اللّغوي” وما يتضمّنه من إضاءاتٍ غنيّة للنّشاط مع الأطفال في مجال اللّغة.
الفانوس اللّغويّ
في الكتاب:
• النصّ مترجَم، وهو بنمط الحكايات الشعبية، وفي قالبٍ لغويٍّ مسجوع.
• في النصّ الكثير من المفردات المتضادّة، وصيَغٌ صرفيّة للمفرد والمثنى والجمع، وللمذكر والمؤنث.
في المنهج:
• الأطفال في جيل 5-6 سنوات: “يعرفون العلاقة بين أسماء وأصوات وأشكال الحروف”/ “يُنتجون بشكلٍ حدسيّ كلماتٍ مختلفةً حسب صلتها بالجذر والوزن الصّرفيّ”/ “يميّزون بين كتبٍ من أنواعٍ مختلفةٍ ويعرفون طريقة استعمالها”.
القاموس اللغويّ: حفل الكلمات:
حان، تثاءب، انتفض، حضّر/ أعدّ، تستمرّ، أمنح، فكرة، نداء، أمهر، ملءَ الملعقة، محتجًّا، مُملّ، تمايلوا، اهتزّوا، إلى الأمام/ إلى الخلف، خدَع سحرية، لوّح، ردّد، سرب عصافير، همس، صاح/ صرخ، وسادة، مثل نتفة القطن، تناثرَ، غلبهم النعاس، التهاليل، تجيدين، غطّ في نومٍ عميق.
• نتعرّف إلى المفردات، ونوضح معانيها: في أيّ سياقٍ نستعملها؟ نعرض صورتها المكتوبة. قد نبحث عن كلماتٍ تشبهها من نفس الجذر.
• نتعرّف إلى الأفعال الحركيّة (تمايلَ/ اهتزّ: رقصَ/ دبك)، نؤدّيها بأجسادنا. نصوّر الأطفال أثناء تأديتها ونُضيف الصور مع الكلمة إلى ركن الرّياضة كي يتمرّس الأطفال بها. قد نستذكر أفعالًا حركيّةً أخرى نعرفها من قبل ونضيفها.
• نقارن بين الكلمات المتضادّة ونبحث عن مفرداتٍ أخرى (قليل/ كثير، كبير/ صغير، همسَ/ صرخ). أية مفرداتٍ متضادّة أو عكسية نعرف؟ هي فرصة لتذويت المفاهيم.
• نختار مفرداتٍ تدلّ على أصواتٍ (همس/ صاح/ صرخ)، ونقلّدها، نلعب ألعابًا صوتيّة. نغنّي أغنيةً مع الإشارات: مرةً همسًا وأخرى صياحًا، ونقارن بين الصيغتين. نتحدّث عن شعورنا عندما يكلمنا أحدهم همسًا أو يصيح. هل يذكّرنا هذا بكتاب “جيران مضجّون”؟ هي فرصةٌ للمقارنة بين الكتابين.
• نتعرّف إلى القاموس، وقد نُعدّ قاموسًا للمفردات الجديدة، تكتب المربية الكلمة، ويرسم الأطفال ما يعبّر عنها. نتيح توفّر القاموس في متناول أيدي الأطفال.
• متى نقول “غطّ في نوم عميق”؟ نتعرف إلى الصيغة واستعمالها.
• نقارن بين ملء/ نصف/ بعض. (نتعرّف على أوصافٍ للأحجام).
تعالوا نتحدّث:
• نتحدّث عن النوم، الملل، المتعة، وعن الكلمات التي تعرفنا إليها: متى يحدث شيء منها وبماذا نشعر؟ نتحدث عن الشعور بالملل، معناه، كيف يمكن تسلية أنفسنا إذا شعرنا بالملل؟
• نتحدث عن الكتب وسيلة للنوم، نتذكر كتبًا أخرى عن أهمية الكتاب (مثلا الكتاب العجيب).
• نتحدث عن الأفكار التي وردت في القصة لنوم الأمير: هل لدينا أفكار أخرى؟ من كان يمكن أن يأتي إلى القصر أيضا وماذا سيفعل؟ قد ننتج نصوصًا جديدة.
• نتحدّث عن الترجمة، ونتعرّف إلى كلماتٍ من لغاتٍ أخرى نستعملها في حياتنا اليومية، ونكشف الأطفال إلى ألفاظها العربية (مُكيّف، شاحن، هاتف وغيرها).
الوعي الصّرفيّ:
• نتعرّف إلى صيَغ المفرد والمثنى والجمع، قد نلعب فرادى، أزواجًا وجماعاتٍ، ونصف ما نفعل بالكلمات.
• نتعرّف إلى المذكر والمؤنث: (العجوز أمسكت/ الطفل أمسك). نعرض صورًا لطفل/ طفلة ونصف ما يفعل كل منهما. نصنّف كلماتٍ نعرفها، ونضيف لها أوصافًا ملائمةً.
• هل تذكّرنا العجوز بكتاب جدّي؟ كنّا قد تعرّفنا إلى مراحل عمر الإنسان. نتعرّف إلى كلمة عجوز الملائمة للمذكر والمؤنث، ونبحث عن كلماتٍ أخرى نستعملها لكليهما (أطفال مثلًا هي مفردة ملائمة للذكور وللإناث).
• نتعرّف إلى صيَغ التشبيه (ناعم مثل نتفة قطن). بماذا يمكن أن نشبّه أشياء نعرفها؟ نستعمل قوالب للتشبيه (كثير مثل أوراق الشجرة/ مكوّر مثل حبة بندورة).
الوعي الصّوتيّ ومعرفة الحروف:
• يحتفي النصّ بالسجع. نقرأ الجمل ونتوقّف قبل المقاطع الصوتية المتشابهة. نتعرّف إلى الكلمات ونحدّد الأصوات المتشابهة. قد نعرض صورة الكلمة ونلاحظ التشابه في الحروف الأخيرة لتعميق مفهوم العلاقة بين اسم الحرف وصوته وشكله.
• صندوق السجع: نحضّر بطاقات صوَرٍ لأغراضٍ متنوّعة. يختار الطفل بطاقةً ويلائم لها البطاقات التي تشكل معها سجعًا (تتشابه أسماؤها في الصوت الأخير)، مثلًا: جوز/ موز/ لوز- باب/ كتاب. للتعرّف على الحروف قد نضيف الكلمات مكتوبةً لينتبه الأطفال إلى الحروف المشترَكة، بينما للوعي الصّوتيّ نكتفي بالغرض أو الصورة ليتمكن الأطفال من الأصوات. قد نرتبها في قائمةٍ ونعدّ الكلمات في كلّ مجموعة.
بدايات القراءة والكتابة:
• تعالوا ننتبه إلى الكلمات السحرية. (شَل شبيش). يتكرّر حرف الشين فيها. نتعرف إليه ونقترح كلماتٍ نسمع فيها صوته. ماذا لو استبدلنا الشين بحرفٍ آخر لنبتكر كلماتٍ سحريةً جديدة؟ قد نلعب لعبة صياد السمك: في الحوض نجد أسماكًا وكلّ سمكة تحمل حرفاً. “يصطاد” الطفل السمكة فنحاول التعرّف إلى الحرف المكتوب عليها، ثمّ نحاول استبدال الشين بالحرف لننتج كلماتٍ سحريةً أخرى (كلكميش/ ململيش/ دلدميش).
ماذا أيضًا:
ماذا لو جمعنا من الأهل والأجداد حكاياتٍ شعبيةً فيها قصر أو أمير؟ سنحصل على كتيّب يمتع الأطفال.
عملًا ممتعًا
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.
ساعة قصة
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا الرّسومات في صفحة 5. كيف تستعدّ نوسة وعائلتها للنّوم؟ وكيف نستعدّ نحن في عائلتنا للنّوم؟ نتأمّل معًا الصفحة قبل الأخيرة في القصّة حين تستيقظ النّعجات صباحًا. كيف تبدأ كلّ نعجة نهارها؟ وكيف يبدأ النّهار في عائلتنا؟
- نتحادث مع طفلنا حول أهميّة النّوم. ماذا يحدث إذا لم يحصل جسمنا على قسطٍ وافٍ من الرّاحة؟
- أحيانًا يستصعب طفلنا، وأيضًا نحن الكبار، الخلود إلى النّوم. ماذا يمكن أن يساعدنا؟ (ربّما أن نقرأ كتابًا، أو أن نسمع قصّة، أو أن نتناول شرابًا دافئًا…)
- هل يمكننا أن نرى الضّفدع الظّريف المختبئ في كلّ رسمة؟
- لنوسة قبّعة ظريفة خاصّة ترتديها للنّوم. قد نرغب بأن نصمّم مع طفلنا قبّعة خاصّة له يرتديها حين يستعدّ للنّوم. نفتّش في خزائننا عن قبّعة قديمة ونزيّنها مع طفلنا في ورشة مبتكرة!
- تسكن النّعجات في حقل ضِفدعون، مسكن الضّفادع. نتخيّل ماذا سيكون اسم الحقل لو كانت تسكن به أرانب، أو ربّما قطط.
- أثناء محاولتها النّوم، “تخلع” نوسة ثوب الصّوف عنها، فتشعر بالبرد. أيّ الأشياء في بيتنا مصنوعة من الصّوف؟ هذه مناسبة للحديث مع طفلنا عن “رحلة” خيوط الصّوف من النّعجة إلى بيوتنا.
- تعدّ نوسة حتّى السّتة ملايين وعشرة! هيّا نجرّب أن نعدّ معًا: واحد…اثنان…ثلاثة…
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- لماذا لا تستطيع نوسة أن تنام؟ تحادثي مع الأطفال حول صعوبة نوسة في النّوم. هل يستصعبون هم النّوم أيضًا؟ لماذا؟
- استذكري مع الأطفال محاولات نوسة في مساعدة نفسها على النّوم. ماذا يقترحون عليها أيضًا؟
- لماذا مهمّ أن ننام؟ وماذا يحدث لجسمنا إذا لم ينل القسط الوافي من الرّاحة أثناء اللّيل؟
- تحادثي مع الأطفال حول طقوس الاستيقاظ صباحًا. ما الّذي يساعدهم على النّهوض من فراشهم؟ يستصعب العديد من الكبار والصّغار النّهوض من فراشهم في الصّباح لأسباب مختلفة، بعضها مرتبطٌ ببنية أجسامهم وبمزاجهم الشّخصيّ. هذه فرصة للحديث مع الأطفال حول هذا التّنوّع بين النّاس بعيدًا عن استخدام صفاتٍ سلبيّة مثل “كسلان”.
- نتتبّع مع الأطفال الضّفدع المرافق لنوسة في كلّ رسمة. ماذا يفعل؟ وكيف يحاول أن يساعد نوسة في الخلود إلى النّوم؟ هل هناك من يساعدنا نحن أيضًا؟
- “حفلة بيجاما في الرّوضة!” سيستمتع الأطفال بالقدوم إلى روضتهم بملابس النّوم في ساعات المساء وبرفقة أهلهم، وربّما بسماع قصّة “النّعجة نوسة” والقيام ببعض تمارين الاسترخاء مثل اليوغا، والخيال الموجّه.
- نزور مع الأطفال زاوية الاسترخاء في روضتنا. ماذا يمكن أن نغيّر فيها أو نضيف عليها حتّى تصبح مريحة أكثر؟
- هل نعرف فيلمًا أو مسلسلًا للأطفال بطله خروف أو نعجة؟ سيتبادر إلى ذهن الأطفال حتمًا “الخروف شون” الّذي ينقذ القطيع دائمًا من المآزق. هذه مناسبة لأن يجلس الأطفال باسترخاء، ويشاهدوا معًا إحدى حلقات هذا المسلسل المحبوب.
- يضيء لك الفانوس اللغوي (بإمكانك مشاهدة الرابط في صفحة الكتاب) العديد من الأنشطة اللّغوية الممتعة المرتبطة بهذا القصّة، فلا تنسَيْ أن تطّلعي عليها.
الفانوس اللّغويّ
في نظرة:
- تحتوي الرسومات على صورٍ لمشاهد متنوّعة للنعجة نوسة ورفاقها، تتيح حواراتٍ وصفية (مثلًا: مشهد الاستيقاظ صباحًا).
في الكتاب:
- في النصّ مفاهيم مترادفة ومتضادّة، وعلاقات شرطيّة، وأوصافٌ للأغراض/ النصّ بصيغة المؤنث، ويتيح التنبه لصيَغ الجمع/ كون النصّ عن النعجة، يوفّر فرصةً للتنبه إلى الحقل الدلاليّ ومجموعات الحيوانات.
في المنهج:
أطفال جيل 3-4:
“يوسّعون قاموسَهم اللغويَّ المتعلّقَ بمضامين قريبةٍ من عالمهم”، “يستعملون أسماءَ ذاتٍ محسوسةً وشائعةً”، “يستعملون أفعالًا عامّةً”، “يستعملون عددًا كبيرًا من الصفات الأساسيّة”، “يتعرّفون على عدّة كتبٍ حسب الغلاف”.
أطفال 4-5:
“يعرفون الكثيرَ من الأسماء من حقولٍ دلالية مختلفة”، “يستعملون صفاتٍ متنوّعةً ومحدّدةً ويسمّونها”، “يصنّفون مجموعةَ أغراضٍ إلى حقولٍ دلاليّة”، “يصنّفون الكتبَ إلى فئاتٍ حسب موضوعاتٍ”.
حفل الكلمات:
نعجة- حقل- ضفدَعون- ليل/ نهار/ صباح/ عتمة شديدة – نامت/ استيقظت/ صاحية- مرعب/ مخيف- صندوق/ سيارة صدئة/ جذع مجوف- فكّرت/ فكرة – دغدغة/ رجفة- تعرّجت تنهّدت: تذكرت/ نسيَت- أسماء العدد.
- نتعرّف إلى الكلمات الجديدة، نتحدث عنها: مثلًا: متى يصير الغرض صدئًا؟ أية مواد تصدأ؟ (فكرة لتجارب علمية)/ متى نحسّ بالرعب أو الخوف؟ نتعرف إلى الأفعال ونؤدّيها (تنهّدت- تعرّجت- استيقظت).
- لتعزيز اكتساب المفاهيم المترادفة والمتضادّة، نحضّر ألعابَ ملاءمة من صوَرٍ تناسبها، مثلًا: نلائم صورة لليل مقابل النهار/ النعجة نائمة أو صاحية/ الوعاء الفارغ مقابل المليء إلخ. نساعد الأطفال في وصف الصور والانتباه إلى العلاقة العكسية بينها. قد نضيف الكلمات مكتوبةً لينكشف الأطفال إليها.
- نختار عباراتٍ ونتحرّك وفق معناها ونمثّلها، بحيث تذكر المربّية الكلمة ويمثّلها الأطفال: ننام، نستيقظ/ نفكر/ ندخل الصندوق/ نخرج منه. (فرصة لألعابٍ حركية للمفاهيم).
- نتعرّف على كلمة “تعرّجَت” ونراقب صورتها. هي فرصةٌ للعبةٍ مع الخطوط. نسير وفق خطوطٍ متعرّجة أو مستقيمة. يمكن الاستعانة بالمكعبات أو أية أغراضٍ أخرى لرسم الخطّ/ المسار المطلوب.
هيا نتحدّث:
- نتحاور حول النوم وطقوسه والاستيقاظ وطقوسه لدى كلّ منا.
- نتحدّث حول حقل النعاج (الحظيرة)، من يسكن أيضًا في الحظيرة؟
- نتعرّف إلى مجموعة الحيوانات، ونسمّي حيواناتٍ أخرى نعرفها، أين تسكن؟ ما الفرق بينها؟
الكفايات اللغوية:
- يتكرّر استخدام “لكنّ” في النصّ. نختار قالبًا لغويًّا ونذكر أشياء نحبها لكننا لا نستطيع تحقيقها، مثلًا : “أحبّ سياقة السيارة لكني ما زلت صغيرًا”… ماذا يحب الأطفال أن يفعلوا لكنّ سببًا يمنعهم؟
- نتعرّف إلى مجموعة النعاج والخراف، إلى مجموعة الحيوانات وإمكانيات تصنيفها. قد نصنّف مجسّمات الحيوانات المتواجدة في أركان الرّوضة، ونبني لها مساكن في ركن البناء، ونخططه معًا ليلائمها.
الوعي الصّرفيّ:
- تسكن النعجة نوسة في حقل “ضفدَعون”. قد نبتكر صيَغًا تصغيرية أخرى لتطوير الوعي الصرفيّ: “كلب- كلبون” ربما أيضًا بوَزنٍ آخر، مثل “قط- قطقوط”. قد نتعرف إلى أسماء التحبب التي يُنادى بها الأطفال، وهي فرصة لتنمية الوعي الصرفيّ. قد نعدّ لوحةً بأسماء التحبب لأطفال الروضة (عبّودي- حمّودي- ميمي- سوسو- جابي وغيرهم).
- تعدّ النعجة نوسة رفيقاتها “واحدة، اثنتان”. تعالوا نساعد الخروف ليعدّ رفاقه : واحد، اثنان..” نعدّ أغراضًا في الروضة بالصيغة الملائمة. نتذكر ألا نطالب الأطفال بإتقانَ العد بالمذكر والمؤنث، إنما أن نكشفهم لذلك من خلال اللعب.
الوعي الصوتيّ:
- نقطّع الكلمات الواردة في النصّ ونعدّ مقاطعها بالمعياريّة. (ملائمة لأسماء الأعداد).
الإقبال على الكتاب:
- نصنّف الكتبَ ونُشرِك الأطفال في ترتيب ركن المكتبة، نبحث عن قصصٍ في الروضة تتحدث عن الحيوانات. أية مجموعاتٍ أخرى قد نجد في مكتبتنا؟ نفكّر بمعايير أخرى لتصنيف الكتب.
عملًا ممتعًا.
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغويّة في قسم التعليم قبل الابتدائيّ العربيّ والبدويّ.
نشاط مع الأهل
- نسترجع مع طفلنا رحلة الحلزون لزون في بحثه عن الهدوء. مَن صادف في طريقه من الجيران المضّجين؟ وما مصدر ضجّة كلّ منهم؟
- نتحادث مع طفلنا حول الحلّ الّذي وجده لزون لمشكلة ضجّة جيرانه. هل هو حلّ دائم؟ وهل يمكن لحلزون أن يقيم هذه الحفلة لجيرانه كلّ ليلة؟ أيّ حلول أخرى ممكن أن نقترح عليه؟
- نفكّر في جيراننا: لماذا هم مهمّون لنا؟ من هو جارنا المُفضّل، ومن هو الجار الأقل تفضيلًا، ولماذا؟
- نسترجع مع طفلنا مواقف ساعدنا بها جيراننا وساعدونا. نتحادث معه حول سلوكيّات يوميّة بسيطة تساعد في بناء علاقات طيّبة مع جيراننا، كأن نساعد الجار المسنّ في حمل أغراضٍ ثقيلة، أو ربّما أن نشارك جارًا طعامًا لذيذًا صنعناه، وأن نحافظ على الهدوء في ساعات راحة الجيران…
- “حفلة قراءة كتاب مع جيراننا!” قد يتمتّع طفلنا بدعوة أطفال الجيران إلى حفلة كهذه، يُحضر إليها كلّ طفلٍ كتابه المفضّل لقراءته سويًّا. ما رأيكم في قراءة هذا الكتاب لجيرانكم؟
- قد نرغب بالخروج مع طفلنا إلى الطّبيعة للبحث عن الحلزونات وصدفاتها، واستكشاف أنواعها وطرق معيشتها.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- بعد قراءة الصّفحات الأولى من الكتاب، من المرجّح أن يكون الأطفال قد فهموا مشكلة الحلزون لزون. لذا، من الممتع أن تتوقّفي في القراءة الأولى عند ص 14(بعد قراءة النّصّ) وسؤال الأطفال عمّا يمكن أن يكون مزعجًا للحلزون في الحديقة، قبل أن يكشفه النّصّ. يشوّق ذلك الأطفال، ويدفعهم إلى التّخمين.
- يعتمد هذا الكتاب كثيرًا على الأصوات: طنين النّحل، وصوت البطّ، والثّعالب، والبومة، وغيرها. تُضفي الأصوات الحركة على قراءتك، وتشدّ انتباه الأطفال. نقترح عليك أن تتدرّبي على قراءة الكتاب باستخدام الأصوات قبل قراءته مع الأطفال. بعد عدّة قراءات تقومين بها، يمكن أن تكشفي الأطفال على قراءة أخرى مسجّلة، نوفّرها لك وللأهل هذه السّنة عبر مسح الشّريط المربّع الموجود على الغلاف الخلفي للكتاب. لمساعدتك، أنتجنا هذا الفيلم القصير الإرشادي حول استخدام تطبيقات QR لسماع القصص. تجدين الفيلم في صفحة الكتاب على الموقع.
- يجد الحلزون لزون حلًّا إبداعيًّا لمشكلته، يُفرح به جيرانه ويكسب ودّهم من جهة، ويحصل على ما أراده من جهة أخرى. تحادثي مع الأطفال حول هذا الحلّ: هل يمكننا أن نستعين به دائمًا للتّعامل مع ضجّة جيراننا؟ أيّة حلول أخرى نقترحها على الحلزون؟
- تحادثي مع الأطفال حول مواقف مشابهة عاشوها أو يعيشونها في حاراتهم. كيف يتصرّف أهلهم عادةً، وكيف يتصرّفون هم؟ قد يأتي بعض الأطفال بخبرات صعبة، مثل شجار مع الجيران. من المهمّ أن تُصغي إلى ما يقوله الأطفال، وأن تتحادثي معهم حول عواقب الشّجار في مثل هذه المواقف. شجّعيهم على التّفكير في طرق بديلة للتّفاهم مع الجار المضجّ، مثل الطّلب منه بأدب أن يخفّف الضّجة.
- تحادثي مع الأطفال حول أهميّة الجيران، وشجّعيهم على ذكر جوانب إيجابية في الحياة مع جيرانهم: فهم أقران اللّعب في الحارة، وهم مصدر الدّعم للأهل في مناسبات الفرح والتّرح، وكثيرًا ما نستعير منهم أغراضًا وقت الحاجة…
- تحادثي مع الأطفال حول دورهم هم في خلق علاقاتٍ طيّبة مع جيرانهم، مثل: أن يساعدوا الجار في مهامّ صغيرة، وأن يمتنعوا عن اللعب في الخارج في ساعات الرّاحة المتّفق عليها بين الجيران، وأن يتجنّبوا الصّراخ العالي وقت اللّعب، وأن يزوروا جيرانهم ويدعوهم إلى بيوتهم…
- من هم جيراننا في الرّوضة؟ يمكن أن تقترحي على الأطفال دعوة الجيران إلى زيارة الرّوضة، وإعداد نشاطٍ ظريف في استقبالهم، مثل قراءة هذه القصّة أو مسرحتها.
- “جيراننا” هو عنوان لنشاطٍ تشركين به الأهل. يُمكن أن يُعدّ كلّ طفل بمساعدة أهله خريطة لحارته تظهر فيها بيوت جيرانه، ويرسم بجانب كلّ بيت ما يميّز علاقات بيته بهذا الجار أو الجارة (هناك دائمًا الجارّة المزوّدة بالفطائر والكعك، أو الجار صاحب السّيارة القديمة المضجّة، وغيرهما.) من الممتع أن يعرّف كلّ طفلٍ زملاءه بطيف جيرانه.
- الخريف هو فصل الحلزونات! من الممتع أن نخرج إلى الطّبيعة بحثًا عنها. ماذا نحبّ أن نعرف عن الحلزونات؟ نراجع الأغاني والقصص الموجودة في مكتبة الرّوضة لتنعرّف أكثر عليها.
الفانوس اللّغويّ
في الكتاب:
- النصّ غنيّ بعباراتٍ تدلّ على أصواتٍ، ويوفّر إمكانياتٍ للمقارنة بين مفردات الضجة والهدوء، إضافةً إلى تسمية أصوات الحيوانات المختلفة، وفيه اشتقاقاتٌ لأوزانٍ صرفيّة خاصّة.
في المنهج:
الأطفال في جيل 5-6 سنوات
- “يتعرّفون على فونيمات في بداية ونهاية الكلمة”.
- “يُنتجون بشكلٍ حدسيّ كلماتٍ مختلفةً حسب صلتها بالجذر والوزن الصّرفيّ”.
- يتعرّفون على أسماء الحروف وأشكالها المختلفة.
الكفايات اللغوية (القاموس اللغويّ):
حفل الكلمات:
مضجّون/ ضجّة/ صاخبة/ مغنّية/ السّكينة/ هدأت/ يُسكت.
تزقزق/ يثرثر/ يطنّ/ يُبطبط/ تنعق.
حوض/ تحمّس/ ضخمة.
- نختار مفرداتٍ تدلّ على أصواتٍ ونقلّدها، نصنّفها إلى أصواتٍ ضاجّة (صاخبة) وأصواتٍ هادئة (ساكنة). نلعب ألعابًا صوتيّة. نتّفق على إشارةٍ ونتحرّك وفقها، إذا انطلقت إشارة الصخب نرفع أصواتنا، وإذا انطلقت إشارة الهدوء نصمت أو نُخفت الصّوت. يمكننا ممارسة النشاط مع الأغاني التي يحبّها الأطفال، وبسرعاتٍ مختلفةٍ لإضفاء أجواءٍ مرحة. قد نتوزّع في مجموعتَين، وكلّ مجموعةٍ تكمل الأغنية وفق دورها مع الإشارات.
- نحتفي بالمفردات وفق مجموعاتٍ صوتيّة متلائمة، ونبحث عن مفرداتٍ أخرى نعرفها تدلّ على ضجّةٍ أو هدوء (صياح/ صراخ). كيف يمكن أن نعبّر عن الضجة والصخب؟
- نتعرّف على أصوات الحيوانات المذكورة ونقلّدها ونبحث عن أصواتٍ أخرى: العصافير تزقزق والبوم ينعق، ماذا تفعل الكلاب/ القطط: الحمير وغيرها؟
الكفايات اللغويّة (الوعي الصَّرفيّ):
- (البطّ يُبطبط): نلعب ألعابًا لاشتقاق كلماتٍ بنفس الوزن من جذورٍ مختلفة، مثلًا: الرشاش- يرشرش/ القطّ- يقطقط. نشتقّ كلماتٍ بمعنى أو بدون معنى. يستمتع الأطفال باشتقاق كلماتٍ مضحكة ومرحة.
الوعي الصّوتيّ:
- الحلزون لزون: تُتيح لنا التسمية المقارنةَ بين الكلمتين، بماذا تختلفان؟ نتعرّف إلى النغمة (الفونيمة) الأولى من الكلمة. نلعب ألعابًا صوتية لتمييز الفونيمات الأولى من أسماء الأطفال/ من كلماتٍ أخرى نعرفها. نضيف فونيمةً جديدةً في مطلع كلمةٍ على ماذا نحصل؟/ نحذف فونيمةً أولى من كلمة، ماذا يبقى؟
- نعزل الفونيمات أو نضيفها وفق لعبة مثل “حلزون بدون حَ ماذا تصير؟ لَزون وفي أولها حَ ماذا تصير؟ نلعب اللعبة مع كلماتٍ جديدة.
قد نقارن أيضًا مع تسمية “حلزون بلزون” التي يعرفها الأطفال، ونبحث عن مفرداتٍ أخرى تتشابه أو تختلف في الفونيمة الأولى أو الأخيرة.
- ننوّه هنا أنّ معظم الأطفال في بداية العام الدّراسيّ قد يتمكنون من تمييز الفونيمة، ويستصعبون عزلها أو إضافتها، لذا فإنّ مثل هذه اللعبة تكشفهم إلى مهارة عزل وإضافة الفونيمات التي ينبغي تطويرها خلال العام الدراسيّ.
بدايات القراءة والكتابة:
- يبرز في النصّ تكرار حرف “الجيم” و “الطاء”. نتعرّف على الحرف ونقترح كلماتٍ أخرى تحتويه.
- في النصّ تتكرّر إشارات الاستفهام والتعجّب. نتعرّف عليها، ونلعب معها: كيف نقرأ الكلمة مع كلّ إشارة؟
ماذا أيضًا:
نقيم حفلةً في البستان، ويؤدّي كلّ طفلٍ شخصيّةَ حيوانٍ تعرّفنا إلى تسمية صوته، نؤدّي الأصوات المختلفة مرةً بصخبٍ وصوتٍ عالٍ ومرّةً بهدوء. نتعرّف على شكل الكلمات (ضجّة/ هدوء) ونضيفها في بطاقاتٍ ونسلك بناءً على البطاقات.
إضاءة:
- توفّر القصّة فرصةً لحواراتٍ متنوّعةٍ حول حقوق الآخرين وعدم إزعاجهم. تعالوا نفكّر في طرقٍ لنستمتعَ دون أن نزعجَ الآخرين. قد نبتكر ألعابًا جديدةً معًا وننتج كتيّبًا من الاقتراحات وتعليماتها، أو ندوّن الأفكار ونقترح رموزًا تدلّ على كل فكرة.
عملًا ممتعًا
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.
نشاط مع الأهل
- يخاف مالك من العلوّ رغم كونه نسرًا. نشجّع طفلنا على الحديث عن مخاوفه، ونفكّر معًا بطرقٍ لمساعدته في التّعامل معها. قد يساعده أن يعرف بعض مخاوفنا نحن، وكيف طوّرنا طرقًا للتّعامل معها. يساعد هٰذا الحوار في طمأنة الطّفل، وفي إعطاء شرعيّة للخوف كصفةٍ إنسانيّة.
- نتتبّع معًا مظاهر الخوف عند مالك؛ فهو يجمد في مكانه، يعرق، قلبه يخفق بشدّة، ويفكّر أفكارًا سيّئة. ماذا يحدث لنا في لحظات خوفنا، وكيف يمكن أن نخفّف من حدّة شعورنا؟ (قد نأخذ نفسًا عميقًا، أو نفكّر بمن يمكن أن يساعدنا…)
- عُرف الذّهب الصّغير علّم مالك الكبير أمرًا مهمًّا. هل تعلّمنا مرّةً ممّن هو أصغر منّا سنًّا أو حجمًا؟ قد نرغب أيضًا بأن نتأمّل معًا بيئتنا الطّبيعيّة بما فيها من كائناتٍ صغيرة يمكن أن نتعلّم من سلوكها، مثل النّملة، والنّحلة، وغيرها. ماذا تُعَلّمنا؟
- نتأمّل معًا الرّسمة الأولى في الكتاب، والرّسمة الأخيرة. ماذا تغيّر فيهما؟ ولماذا؟
- يتشارك النّسر والعصفور الصّغير كلمة “ذهبٍ” في اسميهما. هذه مناسبة للبحث عن مصدر اسميهما، والتّعرّف على أنواعٍ أخرى من النّسور.
- حدائقنا البيتيّة تعجّ بالطّيور الزّائرة، وهي تُكرّر زيارتها لحديقتنا إذا وفّرنا لها “مطعمًا” صغيرًا من الحبوب والخضار، نعلّقه على إحدى الأشجار. تُرى مَن سيزور حديقتنا هٰذا اليوم؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- تتبّعي مع الأطفال مراحل مساعدة “عرف الذّهب” لمالك، وتحدّثي معهم عن مشاعر مالك في كلّ مرحلة.
- النّصّ مليء بأوصافٍ حسّية لمشاعر الخوف لدى مالك، فهو يجمد في مكانه، ويعرق، وقلبه يخفق بشدّة… ماذا نشعر نحن حين نخاف؟ وكيف يمكن أن نساعد أنفسنا في تخفيف حدّة الشّعور بالخوف؟
- شجّعي الأطفال على تخيّل أماكن أخرى كان يمكن أن يأخذ عرف الذّهب مالك إليها ليتعلّم الطّيران.
- مالك تعلّم من طير أصغر منه. يمكن أن تتحادثي مع الأطفال حول خبرتهم في التّعلّم ممّن هو أصغر منهم، أو خبرتهم في تعليم من هم أكبر منهم (مثل تعليم الأهل على استخدام الأجهزة الإلكترونيّة!)
- قد ترغبين بالتّحدّث مع الأطفال حول خبرة مرّوا بها خلال العام الدّراسي، حين ساعدوا صديقًا لهم واجه صعوبةً معيّنة. يمكن أيضًا أن تشجّعي الأطفال على التّفكير بصعوبة واجهوها في بداية العام وتغلّبوا عليها. من ساعدهم، وكيف؟
- ادعي الأطفال إلى تأملّ الرّسمة الأولى والرّسمة الأخيرة في الكتاب. ماذا تغيّر في الرّسمة الأخيرة، ولماذا؟
- ماذا شاهد مالك من فوق حين طار لأوّل مرّة؟ قد يحفّز هذا النّشاط التّخيّلي الأطفال على الكتابة.
- يتشارك عرف الذّهب والنّسر الذّهبي كلمة “ذهب” في اسميهما. ما سبب تسميتهما؟ قد يكون هذا السّؤال مدخلًا لمشروع تعلّمي عن هذين الطّيرين، وعن طيور أخرى نراها في سماء بلادنا.
- في النّصّ تعابير إنشائية من الجدير التّوقّف عندها أثناء قراءة القصّة، وتشجيع الأطفال على تخمين معناها، مثل: خائر القوى، أغمي عليه، أمعن في التّفكير…
- هذه إحدى النّصوص القصصيّة الّتي يسهل مسرحتها، وذلك لتعدّد الحوارات فيها. يساعد تمثيل الأدوار الأطفال في فهم مشاعر الشّخصيات ودوافع سلوكها.
- قد يرغب الأطفال بنشاطٍ فنّيّ بسيط، مثل بناء مجسّم للنّسر. تجدون اقتراحًا لعمل ذلك في رابط لفيديو نشرناه ضمن “روابط موصى بها” في صفحة الكتاب.
- في الصّفحات الأخيرة من الكتاب، يوجّه عرف الذّهب مالك في طيرانه، فيطلب منه الانحراف يسارًا، والطّيران إلى الأمام، وغيرها. هذه مناسبة للعمل مع الأطفال حول مهارات التّموضع في المكان، وصياغة التّوجيهات المكانيّة للآخرين. يمكن أن تستعيني بنشاط رسم خريطة للمدرسة، وتمثيل أدوارٍ في الصّف، حيث يساعد الأطفال زائرًا إلى المدرسة في الوصول إلى مكانٍ محدّد فيها.
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا تفاصيل غرفة فيني. ما الّذي يميّز غرفة السّاحرة عن غرفتنا؟ نشجّع طفلنا على قراءة السّاعة المعلّقة على الحائط، ونتتبّع حركة عقاربها، والوقت الّذي تشير إليه عبر صفحات الكتاب.
- تحاول فيني أن تحوّل التّفاحة إلى برتقالة بواسطة عصاها السّحريّة المعطّلة فتأتي النّتيجة غير متوقّعة. إلى ماذا يمكن أن تتحوّل تفّاحة فيني إذا أمسكنا بعصاها المعطّلة، وقلنا بصوتٍ عالٍ: أبْرا كَدابرا؟
- القطّ فلّيني يُسرع لمساعدة صديقته السّاحرة، ويبذل جهدًا في البحث عن عصًا سحريّة جديدة. نستذكر معًا موقفًا ساعد به طفلنا أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء حين وقع في ورطة. ماذا شعر؟ هذه مناسبة لنشارك طفلنا خبرتنا نحن أيضًا في مساعدة الآخرين، وما تساهم به من بناء علاقاتٍ جميلة مع من حولنا.
- سأل السّحرة فيني عن مصدر عصاها الغريبة، فلم تقل شيئًا. هل يحدث أحيانًا ألّا نرغب بمشاركة الآخرين بمعلوماتٍ عن غرض جديد نعتزّ به؟ لماذا؟
- مدينة السّحرة مليئة بالمتاجر السّحرية الغريبة؛ فهناك متجرٌ للملابس السّحريّة، والفلافل السّحريّة، وغيرها. نتخيّل أنّنا نمشي في شوارع هذه المدينة، أّيّ متاجر أخرى سنصادف؟ تُرى، كيف يبدو ملعب الأطفال في هذه المدينة؟ ربّما يحبّ طفلنا أن يرسمه.
- نشاطٌ في العائلة: ورشة لصنع قبّعة فيني وعصاها، وقناع القطّ فَلّيني! يمكنكم أن تجدوا نماذج جاهزة للقصّ في صفحة الاقتراحات للأهل حول الكتاب، والموجودة في موقعنا الإلكتروني dev.al-fanoos.org.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- غلاف الكتاب مستدعٍ لحوارٍ غنيّ مع الأطفال: من هي هذه الشّخصيّة الغريبة؟ ماذا تلبس؟ ماذا تمسك في يدها، ولماذا تبدو مصدومة؟ شجّعي الأطفال على تخمين أحداث المشهد المصوّر على الغلاف.
- ما يميّز الكتاب من صفحته الأولى كثرة التّفاصيل في الرّسومات، وهو أمر يجذب الأطفال عادة. ادعي الأطفال إلى تأمّل رسومات بيت فيني: ماذا يدلّنا على أنّه بيت ساحرة؟
- في القراءة الأولى، توقّفي عند صفحة 13، بعد جملة “أبرا كدابرا”، وشجّعي الأطفال على تخمين ما يمكن أن يحدث.
- تحدّثي مع الأطفال حول المشهد الأخير في القصّة: لماذا برأيهم ضحك السّحرة وصفّقوا بإعجاب لفيني، رغم أنّ عصاها كانت عاديّة وليست سحريّة؟
- يمكن أن تتحدّثي مع الأطفال حول “كوارث” صغيرة حدثت معهم في البستان أو في البيت، وكيف تعاملوا معها، وكيف تعامل الكبار من حولهم معها.
- حفلة سحرة في البستان! سيتمتّع كلّ طفلٍ حتمًا بارتداء قطعة ملابس، مثل قبّعة غريبة أو قناعٍ، وتصميم عصًا حريّة خاصّة به، وابتكار جملة سحريّة يستطيع أن “يحوّل” بواسطتها غرضًا مألوفًا في البستان إلى شيء غريب! سيكون جميلًا إذا استرجعت مع الأطفال كتاب “عرض المواهب” الّذي يعرفه الأطفال، وأن تنظّمي عرض مواهب “سحريّة” يمكن أن يشارك بها الأهل. لخدمتك، تجدين في صفحة الكتاب، ضمن الروابط الموصى بها، رابطًا لإرشادات صنع قبّعة فيني وقناع فلّيني.
- في الصّفحتين 20+21 رسومات لمدينة السّحرة. يمكن أن نرسم معًا خريطة لمدينة السّحرة: كيف يبدو ملعب الأطفال فيها مثلًا؟ أو ربّما متجر الطّعام؟
- تتبّعي مع الأطفال السّاعة المعلّقة على حائط بيت فيني والّتي تشير في عدّة صفحات إلى تقدّم الوقت. الفتي نظر الأطفال إلى العلاقة بين الوقت وبين لون السّماء الآخذة بالتّعتيم كما تبدو في خلفية الرّسومات.
- هل يمكننا أن نتذكّر شخصياتٍ سحريّة من كتب نعرفها، أو من أفلام صور متحرّكة نشاهدها؟ قد يرغب الأطفال “باستضافتها” في بستانهم.
- سيكون ممتعًا إذا حضر الأطفال عرضًا سحريًّا حيًّا! يمكن أن ترتّبي مع المكتبة العامّة استضافة ساحر يقدّم للأطفال ألعاب خفّة اليدّ.
- في متحف العلوم للأطفال في حيفا (مداعْتِك) غرفة خاصّة بالحيل السّحريّة، وأخرى خاصّة بالخدع البصريّة باستخدام أنواع مختلفة من المرايا. يمكن أن تخصّصي رحلة نهاية السّنة مع الأطفال والأهل إلى هذا المتحف الغنيّ والمثير للأطفال.
- يمكن أن تعدّي مع الأطفال شرابًا سحريًا، من يشربه يتحوّل إلى شخصيّة يحبّها. تجدين وصفًا لنشاط حول إعداد هذا الشّراب في رابط على صفحة الكتاب في “روابط نوصي بها” بعنوان “وصفة لشراب سحريّ”.
- تجدين في صفحة الفانوس اللّغوي (أنظري “روابط نوصي بها” في صفحة الكتاب) اقتراحاتٍ لأنشطة لغويّة حول الكتاب.
نشاط مع الأهل
- حينما حاول العصفور أن يشارك في اختبارات الأداء، صدّه العازفون في الفرقة، وهزئوا به. يمكن أن نتحادث مع طفلنا حول شعور العصفور. هل يختبر الطّفل هذا الشّعور أحيانًا إذا أراد أن يلعب مع “شلّة” أصدقاء في البستان، أو أن يشارك في نشاطٍ عائليّ؟
- العصفور الصّغير لا ييأس، ويحاول مرّة أخرى أن يُظهر موهبته. نشجّع الطّفل على التّفكير بطرقٍ أخرى كان يمكن للعصفور أن يُظهر فيها موهبته للفرقة.
- نفكّر سويًّا في حدثٍ عائليّ قريب (قد يكون حفلةً أو استضافة أصدقاء، أو رحلة، أو إجراء ترميم في المنزل) بماذا يقدر طفلنا أن يشارك؟ وكيف يمكن أن نسهّل عليه ذلك؟
- نَغَم، إيقاع، فرقة، عزف، طَرَب، أغنية، هي بعض الكلمات الّتي يتضمنّها النّص ذات علاقة بالموسيقى. نستذكر معًا كلماتٍ موسيقيّة أخرى يعرفها طفلنا.
- “عائلتنا لديها مواهب!” عنوان لبرنامج فنّي، يمكن أن يشارك به جميع أفراد العائلة. من الممتع أن تخطّطوا مع طفلكم كتابة الإعلان عن هذا البرنامج في البيت، وتحديد لجنة الحكّام، وإعداد مسرحٍ لعرض المواهب!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- سخر الأصدقاء من العصفور الصّغير مرّتين وصدّوه. يمكن أن تتحادثي مع الأطفال حول شعور العصفور في تلك اللّحظات. كيف تعامل مع صدّ الأصدقاء له؟
- أحيانًا يتعرّض الأطفال لمواقف شبيهة لما تعرّض له العصفور. فقد يسمع عباراتٍ مثل: “شو بفهّمك، بعدك صغير.” أو “إنت صغير وضعيف، ما بتقدر تعمل هالشّغلة.” نشجّع الأطفال على الحديث عن مواقف كهذه يصادفونها في البستان، أو في محيط العائلة. بماذا يشعرون؟ وكيف يمكنهم أن يتصرّفوا في مواقف كهذه؟
- شجّعي الأطفال على التّفكير بأنشطة، يرغب كلّ طفل أن يقوم بها أو يعتقد أنّه يستطيع القيام بها جيّدًا. على سبيل المثال: ضرب الكرة بالقدم، أو الرّسم، أو التّلوين، أو بناء مجسّم من المكعّبات، أو سرد قصّة، وغيرها. أطلبي من كلّ واحدٍ أن يعرض نشاطه في المجموعة، أو أن يتحدّث عنه للمجموعة. هذه فرصة أيضًا ليتعلّم الأطفال الإصغاء إلى زملائهم، واستخدام عبارات التّقدير والثّناء والتّشجيع. قد ترغبين أيضًا بدعوة الأهل لعرض نشاطٍ يتقنه طفلهم، أو يتمتّعون بالقيام به مع طفلهم. هل هناك أنشطة مشتركة بين أهل مختلفين؟
- “بستاننا فيه مواهب!” قد يكون عنوانًا لنشاطٍ كبير ندعو إليه الأهل، أو أطفالًا في بستانٍ مجاور. شجّعي كلّ طفل على التّفكير بمهارة أو بموهبة خاصّة به يمكن أن يعرضها. قد يحتاج بعض الأطفال إلى مساندتك في تعريف هذه المهارة (بناءً على مراقبتك للأطفال خلال نشاطهم اليوميّ.) هناك أطفال يحبّون أن يعرضوا لوحدهم، وآخرون يفضّلون العرض في مجموعة. من المؤكّد أنّ أطفالك سيتمتّعون بتصميم الإعلان، وتحضير التّذاكر، والتّدرّب على العرض. يمكنك دعوة وسائل إعلام محلّية لتوثّق الحدث وتنشره.
- قد يتمتّع أطفالك بتحضير أدواتٍ موسيقيّة بسيطة من خردوات: علب بلاستيكية فارغة، عصيّ خشبيّة، وغيرها. تجدين أفكارًا متنوّعة في العديد من المواقع الإلكترونيّة الخاصّة بالمجال.
- يمكن أيضًا أن تدعي الأهل أو أطفالًا في بستانٍ مجاور لبستانك لعرض مواهبهم. هذه فرصة ليتعلّم أطفالك كيف يمكن أن يكونوا هم جمهورًا مشجّعًا، يصفّق، ويعبّر عن استحسانه للمواهب المعروضة.
- حين أدرك الأصدقاء في القصّة أنّهم أخطأوا في حق العصفور، اعتذروا له. تحادثي مع الأطفال حول أهميّة أن نعتذر حين نخطئ. قد ترغبين بتذكيرهم بمواقف حدثت في البستان، وتشجيعهم على مشاركة خبراتهم الشّخصيّة في العائلة، ومع الأصدقاء.
- النّصّ مليء بالكلمات الّتي ترتبط بالموسيقى وبالغناء، مثل: إيقاع، دقّة، نغم، تعزف، تغني، تنشد، وتطرب. من المُثري أن يختبر الأطفال تمثيل هذه الكلمات ليفهموها: ما الفرق بين الدّقة والإيقاع مثلاً؟ تجدين موارد مفيدة في هذا المجال في صفحة “التّربية الموسيقيّة في الطفولة المبكرة” في موقع وزارة التّربية والتّعليم، وفي رزمة “خرز مغنّى- أغانٍ وأنشطة موسيقيّة للأطفال” من إصدار بيت الموسيقى، شفاعمرو.
- من المُغني أن تقفي عند بعض التّعابير اللّغوية، وأن تستكشفي معناها لدى الأطفال، مثل: شعروا برجفة في ظهورهم (متى يحدث لنا ذلك؟) أو دخلوا دائرة الضّوء.
الفانوس اللّغويّ
المربّية العزيزة،
توفّر الكتب فرصًا لإثراء كافّة المجالات لدى الطفل: المعرفيّ والشعوريّ والحركيّ والإبداعيّ. بالإضافة إلى الأنشطة المقترَحة للأهل مع الكتاب وفي موقع مكتبة الفانوس، وإبداعات المربّيات الفنيّة، نخصّص هذا الرّكنَ لإضاءاتٍ في التربية اللغوية يمكن أن تتيحها القصص المقترَحة ومن شأنها أن تساهم في تنميَة مهاراتٍ لغويّة عبر سياقٍ حيويّ يعني الطفل.
ماذا في الكتاب؟
في نظرة:
- الكتاب زاخرٌ بلوحاتٍ تتيح حواراتٍ من الوصف والتعبير والتحليل.
- الكتابة المائلة مفتاح أنشطةٍ حول مفاهيم هندسية.
- الصور معبّرة عن حركاتٍ وأداءات إضافةً إلى تعبيرات عاطفية وشعورية.
- صور الإعلانات وطريقة عرضها والأسهم والإشارات مفتاحٌ لتنمية مهاراتٍ تنويريّة.
في قراءة:
- اللغة جماليّة زاخرة بالقوافي والمسجوعات والأصوات الموسيقيّة.
- النصّ مليء بالمفرد والجمع وصيَغ تصريف الأفعال.
- مفردات معبّرة عن الحركات، عن الأصوات وعن المشاعر.
- القصّة مترجَمة وتتيح حوارًا حول اللغات.
نقترح:
- استثمار القصّة لتطوير حواراتٍ وتنمية الكفايات اللغوية: إغناء القاموس اللغويّ والوصفيّ، والوعي الصّرفيّ بشكلٍ خاصّ.
- تطوير ألعابٍ لتنمية مهارات الوعي الصّوتيّ: القوافي والسّجع، تمييز نغماتٍ وعزلها، قراءة وكتابة صوتيّة للكلمات.
قبل الانطلاق:
- وفق المنهج اللغويّ لبساتين الأطفال، نسعى أن يتمكّن الأطفال في جيل البستان من تمييز وعزل فونيمات صغيرةٍ، ويُتقنوا الكتابةَ الجزئيّةَ والقراءةَ الجزئيّة.
- من المهمّ أن يطوّر الأطفالُ الكفايات اللغويّة بشكلٍ أعمق بحيث يستعملون جملًا مركبة، جملًا وصفيّة، ظروفَ مكان وزمان، مقارنة وجملًا شرطيّة.
تعالَوا نتحدّث:
- نتحاور حول أحداث القصّة، ألوانها، مشاهدها: ماذا أعجبني أو لم يُعجبني؟
- نتحدّث عن شعور الشخصيات: كيف يشعر العصفور برفضه؟ كيف تشعر الشخصيات عند اكتشاف خطئها؟ لو كنت تقترح على الشخصية من حلولٍ بديلة؟
- نتحدّث عن المواهب: نصِف مواهب من نعرفهم، نتابع مواهب لأطفالٍ أو لأهاليهم في الموسيقى، الرسم، الرياضة، الرقص، إلقاء الشعر وسواها.
- نتعرّف إلى مبدعين من بلدتنا ونتحدّث عن مواهبهم، ونحاورهم حول مسيرة إبداعهم.
- نتحدّث عن برامج المواهب المتلفزة: أجوائها، أبطالها وشروطها…
حفل الكلمات:
موهبة، إيقاع، عزف، طرَب، رنّان، زمجر، تمايَل، نغمة، هُتاف، يضطرب، إعلان، لافتة، جفَلَ، مسرح، دائرة ضوء.
نختار مع الأطفال مفردةً/ عبارة/ مقولةً من القصّة جذبت انتباههم، نخصّص ركنًا للاحتفاء بها، ونطوّر حولها أنشطة لإغناء القاموس اللغويّ للطفل:
- ماذا نعني بالكلمة؟- مرادفات- عكس
- بماذا تذكّرك؟ نحضّر شمسَ التداعيات.
- قصص أخرى ذُكرت فيها/ حكايات ملائمة.
- أناشيد، ترديدات، وأهازيج ملائمة.
- صوَر، رسومات أو لوحات تعبّر عن المعنى.
- ننشئ قاموسًا للبستان: نتعرّف إلى القاموس ونبحث عن معنى الكلمة بعد تخمينات، نوثّق معناها بطريقتنا، ونضيف القاموس إلى مكتبة البستان. (تحضير القاموس فرصةٌ لأنشطةٍ حيويّةٍ لتنمية مهارات الوعي الصّوتيّ ومعرفة الحروف وبدايات القراءة والكتابة).
الوَعي الصوتيّ:
نستثمر فرَصًا ونخصّص وقتًا للألعاب الصوتيّة: (مثل أوقات المعابر والساحة)
- ننصت إلى إيقاعاتٍ ونؤدّيها بحركاتٍ متنوّعة.
- ننتج قوافيَ وكلماتٍ مسجوعة، ومع نغمة القافية نقفز، نصفّق ونلائم حركاتٍ.
- نلعب بالمقاطع والنغمات: نعزلُ مقطعًا من كلمة ونضيفه إلى مقطعٍ آخر ونتحدّث عن الكلمات الناتجة ونقرأها.
- نكتب كتابةً صوتيّةً أسماءَ الحيوانات مع تحضير أقنعتها لنقوم بعرضٍ تمثيليّ.
- نحضّر إعلانًا في ركن الدكان: ماذا نحتاج أن نكتب؟ كيف نكتبها؟ ماذا نضيف؟
الوَعي الصّرفيّ:
نلعب فرادى وجماعاتٍ، نتحرّك في المكان: نصِف بالكلمات حركات الأفراد (الذكور والإناث) وحركات الجماعات.
نحكي القصّة ونتوقّف مرّةً لوصف حيوان ومرّةً لوصف مجموعة من الحيوانات.
ماذا أيضًا:
- نحضّر لحفلٍ مشترك لعرض مواهب أطفال الرّوضة: نكتب معًا دعوةً للأهل، إعلانًا للزملاء، نصوّر النشاط وننتج كتابًا لأنشطة البستان.
- يمكن توثيق صوَر وأنشطةٍ ولقاءاتٍ مع مبدعين، وإضافتها في كتاب إلى ركن “مكتبة بلدي” في البستان.
عملًا ممتعًا..
أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة.
ساعة قصة
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا في الصّفحة الأخيرة من نصّ الكتاب، حيث تجتمع رسومات الحيوانات. نسترجع مع طفلنا اسم كلّ حيوانٍ، ولماذا يصعب تربيته في البيت.
- نشجّع الطّفل على اختيار حيوانٍ واحد ورد ذكره في القصّة، ونضحك معًا حين نتخيّل ما يحتاجه هذا الحيوان حتّى يربى في المنزل (فتحة في سقف بيتنا لتمدّ الزّرافة عنقها…)
- نتحادث مع طفلنا حول حيواناتٍ أخرى غريبة ممكن أن تطلبها الطّفلة، ونفكّر معًا لماذا يستحيل أو يصعب تربيتها في البيت.
- إذا كنّا نربّي كائنًا حيًّا في البيت، يمكن أن نتحادث مع طفلنا حول ما يحبّه في هذا الكائن، ودوره في العناية به.
- نتخيّل أنّ الكلب الصّغير الّذي تربّيه الطّفلة قد وسّخ البيت، وأثار استياء الوالدين، فاقترحا على طفلتهما أن تربّيَ حيواناتٍ منزليّة أخرى. أيّ الحيوانات يمكن أن تربّي؟
- حيوانات الكتاب في ضيافتنا! قد نرغب بتشكيل أقنعة لوجوه الحيوانات المذكورة في الكتاب، وتوزيعها على أفراد العائلة؛ فيقلّد كلٌّ منهم صوت ومشية الحيوان! كلّ ما نحتاجه هو رسمة وجه الحيوان، وعود بوظة، وشريط لاصق.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن البدء مع الأطفال من عنوان الكتاب المثير للاستغراب: أريد فيلًا، ونسمع تخميناتهم: من يريد فيلًا؟ أيّ نوع من الفيلة تريد الطفلة (ربّما دمية فيل…)
- في القراءة الأولى، يمكن أن تتوقّفي في صفحة 8 عند بداية السّطر الثالث (بعد أن قال الأب: هذا لا يمكن أبدًا) وتشجّعي الأطفال على التّفكير بسبب يمنع تربية الأسد في البيت. يمكن تكرار ذلك في صفحة 14 (الحصان)، وفي صفحة 18 و20.
- ادعي الأطفال إلى التّفكير في حيواناتٍ أخرى يمكن أن تقترحها الطّفلة، وشجّعيهم على تخيّل مواقف مضحكة قد تحدث إذا ما دخلت هذه الحيوانات البيت.
- يربّي العديد من الأطفال حيواناتٍ أو طيور أو أسماك في بيوتهم. قد يرغب بعض الأطفال بإحضار حيوانهم الأليف إلى الرّوضة، وتعريف الأطفال على عاداته، وطرق العناية به. من المهمّ أن تحضّري الأطفال لاستقبال الحيوانات الأليفة في الرّوضة، بالاتّفاق معهم على مجموعة “أنظمة” في التّعامل مع الزّائر الأليف (تحضير طعام يحبّه بالتّشاور مع صاحبه، التّعامل معه بلطفٍ وعدم تخويفه…) كذلك يمكنك سؤال الأطفال عمّا يرغبون بمعرفته عن الحيوان، كي يكون صاحبه مستعدًّا لإشباع فضول زملائه!
- ماذا نعرف عن الأسد، والبطريق، والجمل، والحصان، وغيرها من الحيوانات المذكورة في القصّة؟ قد ترغبين بجمع ما يعرفه الأطفال، وعرضه باستخدام الرّسومات في زاوية خاصّة في الرّوضة. ماذا ينقصنا من معلومات عن كلّ حيوان؟ وأين يمكننا الحصول عليها؟ هذا سبب كافٍ ووجيه لزيارة أقرب حديقة حيوان!
- “إحزروا، أيّ حيوان أحبّ أن أكون؟” يتمتّع الأطفال بهذا النّشاط الدّرامي وهم يجلسون في حلقة، ويستخدمون الحركات والأصوات لتمثيل الحيوان الّذي يحبونه.
الفانوس اللّغويّ
في الكتاب:
- النصّ مبنيّ بأسلوب السّجع، وغنيّ بالقوافي في نهاية الجُمَل.
- لغة النصّ توفّر نماذجَ صرفيّةً بضمائر متعددة، وفيها المفرد/ الجمع- المذكر/ المؤنّث- المتكلم/ المخاطَب.
- قاموس الكلمات ثريٌّ ومن مضامين وعوالم متنوّعة.
لنتذكّر:
- وفق منهج اللغة، أطفالُ الرّوضة “يؤلّفون كلماتٍ وجملًا مسجوعةً”.
- يتمكنون من استعمال الضمائر بصيغتها الصحيحة
- يوسعون ويُثرون قاموسهم اللغويّ من أسماء وأفعال وصفات بكلمات متنوّعة ومجرَّدة من عوالم مضامين مختلفة .
نقترح:
- تطوير ألعابٍ صوتية مع القوافي والسّجع.
- تطوير أنشطةٍ في الوعي الصّوتيّ والصّرفيّ، وألعابٍ حركيّة مع المقاطع.
- تطوير أنشطةٍ تمثيليّةٍ توفّر مجالًا لاستخدام الضمائر، وظروف المكان (نرمي القبعة فوق- تحت..).
- إنشاء ألعاب ذاكرة ودومينو للكلمات المتشابهة.
حفل الكلمات:
زركشة/ زركشات- قبّعات- مدُن/ قرى/ حارات- تنهيدة- طمّاع- خداع- حيلة- ذكاء- شقيّة…
- نتحاور حول الكلمات/ الجمل/ العبارات/ المقولات التي جذبت اهتمامَ الأطفال. نُعدّ ركنًا للاحتفاء بها.
- نعدّ ألعابَ ذاكرة/ دومينو/ ملاءمة تجمع الصّور والكلمات اللافتة.
- بماذا تذكّرك هذه الكلمة؟ نتيح حواراتٍ مفتوحة، للحديث عن تداعيات الكلمات لدى الأطفال.
الوعي الصّوتيّ:
- نقرأ مع التشديد على الكلمات المسجوعة، ونبحث عن كلماتٍ أخرى مسجوعة.
- نقترح صفاتٍ أخرى للقرود ونبني لها أوصافًا مسجوعة. مثلًا: لو قالت الخالة زركشات: أنت أيها القرد الجميل؟ ماذا سيجيبها؟ – نُبدع عباراتٍ مسجوعةً، نوثّقها، نربطها بما أنتجناه في كتبٍ سابقة، قد نجمعها وننتج كتابًا من السجع لروضتنا.
- تذكّرنا شخصية “زركشات” بمطاردتها للقرود باللعبة الشعبية “امسكني” الملائمة لتقطيع الكلمات. نلعب مع المقاطع، بحيث يقف الأطفال في خطٍّ مستقيم وكفوفهم مفتوحة، وتقف “زركشات” لتسلّم عليهم مع ذكر مقطعٍ واحد من اسمها “زر كَ شات”. والطفل الذي يقع عليه المقطع الأخير يجري ليلحاق بزركشات ويمسك بها. قد نبحث عن كلماتٍ أخرى من ثلاثة مقاطع لإغناء اللعبة.
- نحذف مقطعًا من الكلمات ونرى على ماذا حصلنا.
الكفايات اللغوية والوعي الصرفيّ:
- نحضّر لعرضٍ مسرحيّ نمثّل فيه أحداث القصّة: هي فرصةٌ لنتحدث عن كلّ قردٍ وصفاته، وملامحه وأدائه. يقترح الأطفال ما يميّز كلّ شخصية. نحضّر بوساطة المربية بطاقاتٍ بأسماء أو صفات الشخصيات. نردّد عباراتهم.
ماذا أيضًا:
- نحضّر ألعابَ ملاءمة وذاكرة للكلمات التي اخترناها في حفل الكلمات، ونضيفها إلى ركن الألعاب التربويّة.
- نجمع ما أنتجنا من جمَلٍ مسجوعةٍ ونضيفه إلى ما أنتجنا سابقًا مع قصصٍ أخرى، لنحصل على كتيّبٍ للسّجع خاصّ بروضتنا، نضيفه إلى ركن المكتبة.
- قد نجعله كتابًا محَوسَبًا أيضًا ليستمتع به الأطفال في كلّ الأوقات.
عملًا ممتعًا.
أنوار الأنوار- مرشدة قطرية ومركّزة التربية اللغوية في رياض الأطفال العربيّة.
نشاط مع الأهل
- تحاول الخالة زركشات أن تقنع القرود بإرجاع قبّعاتها لها، وذلك بأن تغريها بإعطائها حلويّات وأغراضٍ بدل القبّعات. نتخيّل مع طفلنا أغراضًا أو طعامًا كان يمكن أن تقبل به القرود.
- نفكّر معًا: لو أنّ الخالة حاولت جمع القبّعات بالقوّة من القرود، ماذا كان يمكن أن يحدث.
- الخالة زركشات استخدمت عقلها للتّفكير في طريقةٍ ذكيّة لاسترجاع القبّعات. نتحادث مع طفلنا حول خبراتٍ مرّ بها استخدم تفكيره من أجل حلّ مشكلة، أو الخروج من مأزق.
- نسترجع مع طفلنا ما قام به كلّ قردٍ بقبّعته، ونتوقّف عند قبّعة القرد الطّباخ الّذي يحبّ الطّبايخ والصّحون. نفكّر معًا بقبّعاتٍ أخرى يعرفها طفلنا ترتبط بوظائف معيّنة، مثل: قبّعة رجل المطافئ، وغيرها. إذا تواجدت في خزائننا، يمكننا أن نلبسها ونمثّل دور صاحبها، أو قد نرغب بأنّ نتمتّع مع طفلنا بورشة صنع قبّعاتٍ خاصّة.
- يكثر البائعون المتجوّلون في بلداتنا العربيّة، وهم يلوّنون أجواء حاراتنا بنداءاتهم المبتكرة والمسلّية. قد يرغب طفلنا بأن يلعب دور البائع المتجوّل: ماذا يحبّ أن يبيع؟ وكيف ينادي على بضاعته ليجذب الشّارين؟
- “السمسميّة” نوع حلوى معروفة في مطبخنا الشّعبي. ستسعد الجدّة حتمًا حين تساعدنا بتحضير صينيّة سمسميّة لذيذة! نفكّر بإعداد قائمة حلويّاتٍ شعبيّة يسهل تحضيرها مع طفلنا، مثل المهلّبيّة، والرّز بالحليب، وغيرها. ربّما يرغب طفلنا برسمها وتوزيعها على أفراد العائلة!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن أن تبدئي من اسم الخالة في عنوان الكتاب: ماذا يوحي الاسم “زركشات” للأطفال؟ ولماذا برأيهم سمّيت بهذا الاسم؟ الفتي نظر الأطفال إلى السّجع في العنوان، وشجّعيهم على التّفكير بأشياء أخرى تبيعها الخالة، وعلى نفس وزن قبّعات، مثل: الخالة زركشات تبيع التّفّاحات.
- قد يكون مفهوم الحيلة لدى العديد من أطفال الرّوضة ضبابيًّا. من المهمّ أن توضّحي لهم الحيلة الّتي استخدمتها الخالة زركشات في جمع قبّعاتها، وأن تربطي مفهوم الحيلة بخبرات الأطفال في الرّوضة أو البيت، مثل: الفزّاعة المنصوبة في وسط أحواض الزّراعة في حديقة الرّوضة (إذا وجدت). تحادثي مع الأطفال حول مواقف استخدموا فيها الحيلة، ليخلّصوا أنفسهم من مأزق، أو ليحلّوا مشكلة.
- لكلّ قرد شخصيّته وميوله: فهناك القرد الطّبّاخ، والقرد العالِم، والقرد الممثّل. تحادثي مع الأطفال حول ما يدلّ على ميول كلّ قردٍ في النّصّ وفي الرّسومات. شجّعي الأطفال على التّفكير بقرود أخرى لها شخصيّات مختلفة، مثل القرد الرّياضيّ، أو السّاحر وغيرهما. أيّة قبّعات تلبس؟
- استمرارًا للنّشاط السّابق، يمكن أن يلعب الأطفال لعبة التّقليد، فيقلّد كلّ طفلٍ القرد الّذي فكّر فيه.
- تعبّر القرود عن حبّها لألوان قبّعاتها. ما لون القبّعة الّذي يفضّله كلّ طفل؟ قد يكون هذا الحوار مدخلًا لورشة تصميم أو صباغة أو تلوين قبّعات.
- أحد القرود يحبّ السّمسميّة، سيتمتّع الأطفال حتمًا بتذوّق هذا النّوع من الحلوى الشّعبيّة، وقد ترغبين في تنظيم نشاطٍ مع الأهل والأطفال لإعداد أنواع حلوى عربيّة تراثيّة أخرى، مثل المهلّبية، والهريسة، والكنافة، والقطايف، وغيرها.
- تتميّز رسومات الكتاب بأسلوب الكولاج، وهو تلصيق مزق من أوراق ملوّنة لتكوّن شكلًا. ادعي الأطفال إلى تشكيل لوحة كولاج من موادّ مختلفة، قد تشمل أيضًا قطع قماش، وجلد، ومزق جرائد، وغيرها من فضلات الموادّ الموجودة في روضتك.
- هذه مناسبة لتجميع ألعاب التّفكير الموجودة في الرّوضة، وتشجيع الأطفال على إحضار أخرى من بيوتهم، وتخصيص وقتٍ خلال اليوم للّعب فيها.
- أخيرًا، كيف يمكن الحديث عن القبّعات بدون أن نلعب في السّاحة لعبة “طاق طاق طاقيّة” الشّهيرة!
نشاط مع الأهل
- نستعيد مع طفلنا ما غيّر لون حذاء القط ظريف كلّ مرّة: فالتوت حوّله إلى أحمر، والقراصيا إلى أزرق، وغيرهما. نقترح عليه ألوانًا أخرى، مثل البرتقاليّ، والأسود ونشجّعه على التّفكير بما يمكن أن يحوّل الحذاء إلى هذا اللّون.
- نشجّع طفلنا على التّفكير بأكوام أخرى يدوس عليها ظريف في طريقه. بأيّ ألوانٍ سينصبغ حذاؤه؟
- هذه مناسبة لأن نزور معًا دُرج أو خزانة الأحذية في بيتنا، وتفحّص أحذيتنا: أيّ منها مغبّر، ممزّق، مبقّع، مخدوش. تُرًى، على ماذا دُسنا في طريقنا؟
- بالرّغم من اعتزاز ظريف بحذائه الأبيض الجديد، لكنّه يرى الجميل في كلّ لونٍ ينصبغ به حذاؤه. نحاول أن نستذكر مع طفلنا حوادث شبيهة بأغراضٍ شخصيّة لنا: ربّما ثوبٌ تمزّق واستعملناه لغرضٍ آخر، أو قطعة أثاث تلِفت واخترعنا استعمالًا جديدًا لها؟
- ورشة صبغ أقمشة! قد يتمتّع طفلكم باختبار صبغ القماش بألوان مختلفة. يمكن لهذا الغرض استخدام مواد طبيعيّة مختلفة، مثل منقوع الشّمندر، أو مسحوق الكركم المغلي بالماء، وغيرها.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن أن تتتبّعي مع الأطفال مشوار ظريف، وأكوام الموادّ الّتي داس عليها وصبغت حذاءه. شجّعيهم على التّفكير بموادّ أخرى قد يدوس عليها ظريف، والألوان الّتي يمكن أن ينصبغ بها حذاؤه.
- ليس كلّ أطفال الرّابعة كظريف. فبعضهم قد يحزن حين يتّسخ حذاؤه الجديد أو يتلف. اِدعي الأطفال إلى تخيّل ما يمكن أن يحسّه ظريف حين انصبغ حذاؤه. قد يساعدهم أن يستذكروا موقفًا شبيهًا مرّوا به، وما أحسّوا به وقتها.
- لنتخيّل أنّ حذاء ظريف قد انصبغ بلونٍ برتقاليّ، أو أسود، أو أصفر. على أيّ موادّ داس؟
- اِقترحي على الأطفال تغييرًا في الحبكة: ماذا لو لم ينظف حذاء ظريف؟ كيف سيشعر عندها؟
- “عرض أحذيتنا الملوّنة” قد يكون نشاطًا ممتعًا يشارك به الأهل والأطفال. اطلبي من الأطفال أن يُحضروا أحذيةً قماشيّة قديمة، وبمساعدة الأهل يصبغونها بألوانٍ مختلفة. من الجميل أن يستخدموا موادّ طبيعيّة للصّبغ، مثل: منقوع الشّمندر، أو مغلي الكركم، أو مغلي البقدونس، وغيرها. يمكن الاستعاضة عن الأحذية بأقمشة بيضاء يختبر الأطفال صبغها.
- نشاطٌ ممتع آخر يصلح للأيام الدّافئة هو أن يدوس الأطفال بأرجلهم الحافية على أكوام دهان أصابع، ويطبعون كفّات أرجلهم على أوراق كبيرة.
- تجدين في صفحة الفانوس اللّغوي (أنظري “روابط نوصي بها” في صفحة الكتاب) اقتراحاتٍ لأنشطة لغويّة حول الكتاب.
الفانوس اللّغويّ
ماذا في الكتاب؟
في نظرة:
- التصميم يُتيح مجالًا لتنمية المهارات التنويريّة، مثل : فقاعات التفكير، علامات التعجّب، وهي فرصة لحواراتٍ لغويّةٍ وعاطفيّة وذهنيّة ممتعة.
في قراءة:
- النصّ غنيٌّ بعلاقات السّبب والنتيجة (مثل: داس على كومة توت، فصار لونه أحمر).
- علامات التعجّب والاستفهام تفتح إمكانيّاتٍ لقراءاتٍ بنبراتٍ متعدّدةٍ ملائمةٍ لتنمية مهارات الوعي الصّوتيّ.
- في النصّ أفعالٌ وأوصافٌ شعوريّة وحسيّة من المحكيّة والمعياريّة، وهي توفّر فرَصًا للتجسير بين الصيغتَين. (مكيّف- بيجنّن- عظيم…).
نقترح:
- إتاحة حواراتٍ وأنشطةٍ تُثري القاموسَ الشعوريّ والعاطفيّ للطفل.
- إثراء قاموس الوصف والمقارنة والشّرط وتنمية مهارات التداوليّة.
- تطوير أنشطةٍ وألعابٍ للتعرّف على صيَغ الاستفهام والتعجّب (شفهيًّا).
قبل الانطلاق: لنتذكّر ما ينصّ عليه منهج التربية اللغويّة
جيل 3-4 سنوات
- يتمكّن الأطفال من استعمال الأسماء والأفعال والصّفات والضّمائر بصيغتها الصّحيحة حسب اللغة المحكيّة، ويستعملون المبانيَ الصّرفيّة الملائمة. يردّدون أجزاءً من قصّةٍ، ويعبّرون عن مشاعرَ ومواقف.
جيل 4-5 سنوات
- يتمكّنون من استعمال أوزانٍ مختلفةٍ في صيغتها المحكيّة والمعياريّة، يتعرّفون على الكلمات الوظيفيّة ويستعملونها بالطريقة الصحيحة، ومنها كلمات الرّبط التي تدلّ على السّبب (عَشان، لأنّ، بسبب…). يميّزون الانفعالاتِ المختلفةَ، ويتحدّثون عن تجاربَ عاشوها.
تعالَوا نتحدّث:
- نتحدّث حولَ القصّة وحبكتها، وتسلسل الأحداث. نهتمّ بالعلاقة السببيّة بين الأحداث.
- نفكّر بأشياء أخرى يسقط فيها القطّ. ماذا كان سيحدث؟ بأيّ لونٍ يصطبغ؟ ولماذا؟
- أيّة أنواعٍ من الأحذية ينصبغ لونها؟ فرصةٌ للحديث عن أنواع الموادّ المصنوعة منها الأحذية، وتصنيفها حسب أوصافٍ ومعايير.
- نتحاوَر حول شعور القطّ في كلّ مرّة؟ لو كنتَ مكان القطّ بماذا كنتَ ستشعر؟ نبحث عن حلولٍ كان يمكن أن تخفّفَ من شعورٍ سلبيّ.
- نتعرّف إلى فقاعات الأفكار، نرسمها، ويتحدّث كلٌّ منّا عن كلمةٍ تخطر بباله، وتكتبها المربية. قد نبحث أيضًا عن طرقٍ أخرى للتعبير عن الأفكار، مثل شمس التداعيات.
- نختار مفردةً مثل “عظيم” ونبحث عن أوصافٍ مشابهة. لمَن نقولها؟ يبحث كلّ طفلٍ عن زميلٍ يصِف له سلوكَه بها.
حفل الكلمات:
أسماء الألوان (أبيض، أزرق، بنيّ).. أسماء الكَومات (توت، قراصيا، وَحل)، ظريف، مُنحدَر، يسير، داسَ، استمرّ، كَومة، “بِجنّن”، انصبَغَ، عظيم، مَبلول…
- نطوّر أنشطةً حركيّةً مع الأفعال الحركيّة، نجسّدها، ونضيف صوَر الأطفال مع بطاقة الكلمة الملائمة إلى ركن “حفل الكلمات”. (داسَ، سارَ)، نقترح أفعالًا حركيّةً أخرى.
- نطوّر أنشطةً حول المشاعر وطرق التعبير عنها. نلائم بين الكلماتِ الشعوريّة وبين سلوكيّاتٍ تعبّر عنها. ماذا تفعل حين تشعر بشيء ما؟ هي فرصةٌ أيضًا للتذكير بقصّة “ماذا أفعل حين أغضب”.
- نُضيف اقتراحاتِ الأطفال للتّعبير عن المشاعر المذكورة : مثلًا كيف يمكن أن يعبّر القطّ عن أنه “مكيّف”؟ نقترح إمكانيّاتٍ ونمثّلها ونضيفها إلى ركن الكلمات، من المحكيّة والمعياريّة.
الوعي الصّرفيّ والصّوتيّ:
- ماذا لو كانت القطّة ظريفة هي الشخصية؟ نحكي القصّة بصيغة المؤنّث. نختار رمزين: (قطةً وقطًّا)، ونتحدّث مع كلّ مؤشّر بالصيغة الملائمة.
- نقطّع الكلمات بالمذكر والمؤنث ونقارن بين عدد المقاطع (قطّ- قطّة، مبسوط- مبسوطة، أبيض- بيضاء إلخ).
- نتعرّف إلى الحروف التي تكرّرَت (القاف مثلًا)، ونبحث عن كلماتٍ تبدأ بصوتها/ تنتهي بالصوت…
- نلعب مع إشارات الاستفهام والتعجّب المتواجدة في النصّ، نقرأ كلماتٍ مع كلّ إشارةٍ ونلاحظ اختلافَ النبرات والتعابير.
الكفايات اللغويّة:
- نتحدّث عن العلاقة السببيّة: لماذا انصبغَ الحذاء؟ لماذا ظلّ القطّ سعيدًا، ماذا يمكن أن يجعلنا سعداء، نتحدّث عن أمورٍ تُسعدنا. نختار كلماتٍ بالمحكيّة ونجد لها مرادفاتٍ من اللغة المعيارية : مثلاً كيف نقول مكيّف؟ بيجنن؟ نبحث عن مرادفاتٍ ونكتبها معًا. نلعب مع قوالب سببيّة وشرطيّة (أنا بكون مكيّف لمّا/ إذا صار كذا بكيّف ).
- نلعب ألعابًا في القفز بين المحكية والمعيارية. (يمكن أن نسمّيَ المعياريّة لغة الكتاب)، نختار مساحاتٍ ونلوّنها، ونخصّص لونًا للمحكية وآخر للمعيارية. حين نسمع مفردةً نقفز إلى مساحة اللون الذي يلائمها. قد نخصّص أيضًا مساحةً للكلمات الملائمة للصيغتَين.
ماذا أيضًا:
- نحضّر صوَرًا تعبّر عن حركات، مع وجود الكلمات التي تعبّر عنها ونضيفها إلى مركز الرّياضة.
- نبحث عن قصصٍ أخرى في مكتبتنا تتحدّث عن الحيوانات، نرتّبها معًا في رفٍّ خاصّ، ونقارن بينها.
- نجمع أحذيتنا، وأحذيةً من أبناء العائلة والزّملاء، نقيس ونقارنُ بين المقاساتِ. نتعرّف إلى أنواع الموادّ المصنوعة منها الأحذية وخواصّها، نقارن بينها، ونُجري تجاربَ علميّةً مع الموادّ، نقيم يومًا للأحذية في الرّوضة: نعرض صوَرًا ورسوماتٍ، نلعب ونمشي بأحذيةٍ مختلفة، نمشي ونقفزُ حفاةً ( نحضّر المكان والبيئة ونختار الألعابَ الملائمة).
عملًا ممتعًا..
أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة.
نشاط مع الأهل
- • “أين اختفى سمسم؟” نتحادث مع طفلنا حول أسباب اختفائه الممكنة، وقد نستذكر حدثًا شبيهًا حصل في عائلتنا. ماذا شعر الطّفل، وبماذا فكّر؟
- •قلقت الطّفلة لغياب سمسم، فساندها والداها باحتضانها وبالبحث عنه. نتحادث مع طفلنا حول طرقٍ أخرى يقترحها للبحث عن سمسم (مثل الإعلان في مواقع التّواصل الاجتماعي…)
- •ماذا يحبّ طفلنا أن يفعل مع الحيوان أو الطّائر الأليف في بيتنا؟ قد نتمتّع معًا بالبحث عن صورٍ توثّق مشاهد مفضّلة أو مضحكة برفقته، ونرتّبها في ألبوم صور نشاركه مع أفراد العائلة، ومع الأصدقاء في البستان.
- •أيّ حيواناتٍ أليفة أخرى ممكن أن نربّيها في البيت؟ هل نعرفُ عائلاتٍ تربّي حيوانات غريبة في بيتها؟
- • العديد من قصص الأطفال تدور حول شخصيات الحيوانات. قد نرغب بتصفّح الكتب في مكتبتنا البيتية، وقراءة القصص عن الحيوانات الأليفة، أو قد نستمتع معًا بمشاهدة فيلمٍ يختاره طفلنا.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يحبّ أغلب الأطفال الحيوانات المختلفة. شجّعي الأطفال على تسمية الحيوانات التي يرغبون بتربيتها في منزلهم. يمكنك التّحادث معهم حول احتياجات الحيوانات المختلفة، وطرق رعايتها.
- رغم أنّ أفراد العائلة تفاجأوا بوجود سمسم في البيت، لكنّهم لم يرفضوه. اقترحي على الأطفال موقفًا افتراضيّا ترفض فيه العائلة دخول سمسم إلى البيت. كيف يمكن إقناع الأهل بإدخاله؟
- عندما ضاع سمسم، تعاونت الطّفلة مع أمّها على كتابة إعلان ونشره بين الجيران. اقترحي على الأطفال إعداد إعلانٍ للبحث عن سمسم: ماذا نكتب فيه؟ قد يستمتع الأطفال بتعليقه في زاوية كتب المشروع، أو في مدخل الصّف.
- غاب “سمسم” لفترة طويلة، ولا نرى في الكتاب رسومات للأماكن التي تجوّل فيها. شجّعي الأطفال على تخيّل هذه الأماكن. لو ضاع سمسم في حيّ الرّوضة، فأيّ الأماكن يمكن أن يقصدها؟ هذه مناسبة للخروج مع الأطفال إلى الحيّ، وتفقّد هذه الأماكن، ومن ثمّ رسم خريطة لها. للمزيد حول استخدام خريطة الحيّ ندعوك لمشاهدة الفيلم في أسفل هذه الصفحة.
نشاط مع الأهل
- رسوماتُ هذا الكتاب نَصُّهُ الأساسيّ، فهي تصوّر أحداث القصّة المتتالية على نحوٍ واضح، وتخبّر أكثر من النّص اللّغوي. في اللّقاء الأوّل مع الكتاب، نتصفّحه معًا، ونشجّع الطّفل على “قراءة” القصّة كما يراها في رسومات الكتاب لوحدها.
- في الكتاب خمس صفحات ( 14-10) تصوّر سعد ماشيًا تحت المطر إلى أن يقع. نتوقّف عند الرسمة الثانية (ص 11 ) ونتساءل مع الطّفل حول احتمالات أخرى لما قد يحدث: هل تقع الجريدة وتتبلّل بالماء؟ أم ربّما تطير قبّعة سعد؟ يساعد هذا التّخمين في تطوير قدرة الطفل على التّنبؤ بأحداث بناءً على مُعطياتٍ سابقة.
- والدة سعد واسَتْهُ باحتضانه، وبمداواة جُرحه، وتحضير كأس شراب له. كيف نُواسي نحن الآخرين، وكيف نحبّ أن يساندونا حين نشعر بالألم أو بالضّيق؟
- وَقَعَ سعد على الرّصيف وجرح رجله. نتحادث حول الحذر في الطّريق، وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من الأذى.
- في محاولتها إصلاح القبّعة، تقوم والدة سعد “بحماقة” طريفة، كجميع الأهل الّذين يحاولون جهدهم، ولا يملكون دائمًا الحلول السّحريّة لمآزق أطفالهم. نستذكر معًا مواقف كهذه حدثت في العائلة.
- ورشة لتزيين القبّعات! نتمتّع مع الطفّل بإعداد ورشة لتزيين قبّعات مختلفة الأشكال، وربّما نشارك أفراد العائلة والأصدقاء بهذا النّشاط. نستعين بموادّ متنوّعة مثل الرّيش الملوّن، والأزرار، والمُلصقات، وألوان صبغ الأقمشة، وما شابه.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يتمّيز الكتاب برسوماته؛ فهي متراتبة وواضحة على نحوٍ يسهل معه فهم أحداث القصّة، دون الحاجة حتّى إلى قراءة النّص اللّغوي. وفي هذا قوّة الرّسومات وجمالها. يمكنك أن تدْعي الأطفال في لقائهم الأول بالكتاب إلى “قراءة” القصّة من رسوماتها فقط، ثمّ المقارنة بين هذه القراءة وبين قراءة النّص اللّغوي.
- النّص اللّغوي موجزومشوّق، وفي إيجازه وغموضه يحفّز الطفل على تأمّل الرّسمة وصياغة نصّ لغويّ أكثر تفصيلاً. أنظري مثلاً الصفحات 17،23،24. شجّعي الأطفال على أن يعبّروا لغويًّا عمّا يقوله/يسأله النّص.
- “سعد” طفلٌ يتميّز بالاستقلاليّة ويمتلّك عدّة مهاراتٍ حياتيّة: ففي وسعه أن يذهب (مثل الكبار) إلى الحانوت المجاور للبيت لشراء الجريدة لأمّه. لكنّه، ككلّ الأطفال، بحاجة إلى مساندة الأهل وقت الضّائقة. يمكنك الحديث مع الأطفال حول الأمور التي يستطيعون القيام بها لوحدهم، وأخرى يحتاجون فيها إلى مساندة الأهل.
- تُواسي الأمّ سعد بتضميد جرحه وإعداد شرابه المفضّل. كيف نحبّ أن يواسينا أصحابُنا في الرّوضة حين نتألّم؟
- على الرّغم من مهارة سعد في السّير في الشّارع، لكنّه ارتطم بالرصيف ووقع. هذه مناسَبة للحديث مع الأطفال حول خبرة السير في الشّارع، ووسائل الحذر التي يتّبعونها للحفاظ على سلامتهم.
- الأهل أيضًا يرتكبون حماقاتٍ صغيرة في محاولاتهم للمساعدة! يتمتّع الأطفال باستذكار هذا الحوادث، وتساعدهم في رؤية الأهل على نحوٍ واقعيّ. أهلٌ يتعلّمون ويحاولون، ويحتاجون أحيانًا إلى مساندة الصّغار.
- أصدقاء سعد يلعبون ” الحَبْلة” في الحارة. أيّ ألعاب حارة يحبّها الأطفال مع رفاقهم؟
- يألف العديد من الأطفال الجريدة في بيوتهم. جريدة أم سعد مدخلٌ جيّد للحديث مع الأطفال حول عادات قراءة الجريدة في البيت: من يقرأها؟ وما الفرق بين الجريدة والكتاب مثلاً؟
- الجريدة مادّة غنيّة للعديد من الفعاليات الإبداعية. نشاركك بعض الأفكار في هذا الموقع.
- الطّبع على القماش نشاطٌ يتمتّع به الأطفال، وقد ترغبين بإشراك الأهل في ورشة كهذه. تتعدّد الموادّ المعدّة لهذا الغرض في الأسواق، أحدها هو أقلام شمعيّة ملّونة سهلة الاستعمال، يرسم بها الطّفل على ورقة بيضاء، ثمّ تُكوى الرّسمة على قماش أبيض.
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع طفلنا حول الخلاف في القصّة ونحاول فهمه: لماذا اختلف الجيران؟ وماذا كانت عاقبة الخلاف؟ هل كان يمكن أن يسوّي الجيران الخلاف بينهم بطرق أخرى لا يخسرون فيها ثمار الزّيتون؟ هذه فرصة لأن نتحدّث مع الطفل عن خبرته في التّعامل مع مواقف خلاف في البيت أو في البستان.
- “هذا لي!” عبارة نسمعها كثيرًا من أطفالنا. نتحدّث حول مفهوم الملكيّة : ما الذي يجعل الأشياء “لنا”؟ وأي منها نريد ونستطيع أن نشاركها مع الآخرين، وكيف؟
- “إسأل عن الجار قبل الدّار”، يقول مثلنا الشعبي. نستذكر معًا جيراننا، ونتحادث عن علاقتنا بهم: من منهم أصدقاؤنا، وكيف يمكن أن نحافظ معًا على علاقات جيرة طيّبة.
- تحتلّ وجوه الأشخاص مكانًا بارزًا في رسومات الكتاب. يمكننا أن نتصفّحها مع الطفل، وأن نحكي عمّا تعبّره ملامح الوجوه من مشاعر مختلفة.
- الخريف موسم قطاف الزيتون في بلادنا، والعديد من العائلات تنشغل به. يتميّز هذا الموسم في ثقافتنا الشّعبية بطقوس وعادات خاصّة، وبتكاتف النّاس والتّعاون بينهم. نتحادث حول استعداداتنا في العائلة لقطف الزيتون، ربّما من الكروم الواسعة أو من حديقة الدّار.
- الزّيتونة شجرة مباركة تدخل خيراتها إلى بيوتنا. يمكننا أن نستكشف معًا أين “تختبئ” الزّيتونة بأشكالها المختلفة في بيتنا!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- نستذكر مع الأطفال الخلاف في القصّة: ما موضوعه، من شارك به، ماذا كانت ادّعاءات كلّ طرف، كيف عبّر المشاركون عن موقفهم، وماذا كانت نتيجة الخلاف. من الهامّ أن يفهم الأطفال هذا المسار حتى يستطيعوا أن يفكّروا في طرق بديلة كان يمكن أن ينتهجها الكبار من أجل الوصول إلى حلّ يُرضي الطّرفين. نتحادث مع الأطفال حول اقتراحاتهم للحلول.
- نتحدّث مع الأطفال حو تصّرف جاد ورنا: ماذا فعلا؟ ولماذا لم يشاركا في الخلاف؟ نحاول أن نستوضح ردود فعل الأطفال لو كانوا مكان جاد ورنا، ونثير موضوع “الرّبح” و”الخسارة” في مواقف كهذه.
- نشجّع الأطفال على مشاركة مواقف خلاف يختبرونها في حياتهم اليومية: مثل خلافات بين الجيران في داخل العائلة بين إخوتهم، أو في الرّوضة والبستان حول ملكيّة بعض الألعاب والأغراض. نشجّعهم على اقتراح طرق مختلفة لحلّ الخلافات، وعلى رؤية الرّبح والخسارة في كلّ حلّ.
- قطاف الزّيتون موسمٌ مركزيّ في حياة العديد من الأطفال والعائلات العربية. نتحادث مع الأطفال حول استعدادات عائلاتهم لموسم القطاف. ما الذي يحبّه الأطفال في هذا الموسم؟ وما هي الأدوار التي يساهمون بها؟
- يتمتّع الأطفال في قطف الزيتون معًا من شجرة قريبة من مبنى الرّوضة/ البستان، والانشغال بكبسها سويّا مع المربّية، ومشاهدة نقاط الزّيت التي يمكن استخراجها من ثمار الزيتون. يوفّر هذا النّشاط متعةً كبيرة للأطفال إلى جانب الغنى في الفرص التّعلميّة التي يوفّرها، من إكساب مفاهيم علميّة، وثروة لغوية، وتعزيز مهارات العمل في جماعة، وغيرها. العديد من المربّيات يبادرن أيضًا إلى تنظيم زيارة لمعصرة زيتون قريبة. من الهام أن نفسح المجال للأطفال في استذكار ما شاهدوه في المعصرة على نحوٍ ممتع، كأن تعرض المربيّة سلسلة من الصّور الواضحة التي التقطتها لمسار عصر الزيتون، وتأليف قصّة جماعية حولها.
- أوراق الزّيتون وعجمه موادّ ممتازة لإبداعات فنّية. يمكن أن يستخدم الأطفال الأوراق في تزيين قبّعات كرتونية بدل تزيينها بالرّيش، ويمكن أن يرسموا عليها وجوهًا بتعابير مختلفة. صنع قلائد أو أساور من ورق الزيتون المشكوك في خيط متين فعالية ممتعة أيضًا.
- نجمع مع الأطفال أوراق أشجار أخرى قريبة من الروضة/ البستان، ونشجّع الأطفال على تأملها والحديث عن الفوارق بينها في الحجم، والخطوط، واللون، والملمس وغيرها.
- “فاطمة شرف الدّين” كاتبة أطفال معروفة في العالم العربي ولها العديد من الإصدارات التي ترجمت إلى لغات عدّة. يساهم الموقع الإلكتروني التالي الخاص بالكاتبة ( باللغة الإنكليزية) في التعريف بسيرتها وبإصداراتها www.fatimasharafeddine.com
نشاط مع الأهل
- نتتبّع مع الطّفل توصيات العنزة لصغارها (البقاء في البيت، إقفال الأبواب، وعدم الفتح للأغراب). نفكّر معًا في تعليمات أخرى كان يمكن أن تزوّد بها العنزة جداءها للحفاظ على سلامتهم.
- حكت العنزة لأولادها عن علاماتٍ تدلّهم عليها. أّي علاماتٍ أخرى كان يمكن أن تعطيهم؟
- هل كلّ غريب يدقّ بابنا “شرّيرٌ” كالذّئب؟ نتحاور حول طرق التّعامل مع الغرباء الذين يقصدون بيتنا.
- نتحدّث عن خبرة الطفل في البقاء في البيت بدوننا ( ربّما برفقة إخوة أكبر سنًّا أو بالغ آخر). ماذا يشعر؟ وماذا يمكن أن يطمئنه؟
- يصرخ الجدي الصّغير فيلتمّ الجيران وينجدوا الجداء من الذّئب. نتحادث حول مواقف مختلفة قد يشعر فيها الطّفل بالخطر. ماذا يفعل كي يحمي نفسه؟
- نفكّر في جيراننا: من منهم يمكن أن نستعين به وقت الحاجة؟ كيف نصل إليه؟
- أصل القصّة حكايةٌ شعبيّة. هذه مناسبة لسؤال الجدّات والأجداد عن حكايات شعبيّة أخرى ممتعة يقصّونها على مسامع الصّغار.
- ندعوكم لمسرحة القصّة مع أطفالكم. واحد، اثنان، ثلاثة: رفعت السّتارة!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- تطلب الأم من صغارها أن يبقوا في البيت، وألاّ يقفلوا الباب ولايفتحوه للغريب. ماذا يمكن أن تفعل الجداء أيضًا حتّى تحمي نفسها؟
- أصغر الجداء هو الذي هرب وطلب المساعدة من الجيران، فأنقذ إخوته. نتحادث مع الأطفال عن “القوّة” التي قد يمتلكها الصّغار على الرّغم من صغر أجسامهم.
- نتحادث مع الأطفال حول خبرة يمكن أن مرّوا بها في البقاء في البيت بدون والديهم، وربّما برفقة إخوتهم الأكبر سنًّا. ماذا شعروا؟ ماذا يمكن أن يمنحهم الشّعور بالأمان وقت غياب الأهل؟
- توصي العنزة جداءها بألاّ يفتحوا الباب للغريب، وتزوّدهم بعلاماتٍ تدلّ الجداء عليها. نسترجع هذه العلامات مع الأطفال، ونفكّر في علامات أخرى تميّز العنزة عن الذّئب يمكن أن يضيفها الأطفال.
- يأكل الذئب العسل حتى ينعم صوته، ويدهن يده بالأسود حتى تصبح سمراء. نلفت نظر الأطفال إلى العمل ونتيجته، ونشجّعهم على اقتراح أعمال أخرى قد يقوم بها الذّئب ليتشبّه بالعنزة. يمكن أن يقوموا بذلك أثناء عرض مسرحيّ بسيط للقصّة يتدخّل به الأطفال باقتراحاتهم.
- يسرع الجيران لنجدة الجداء عند سماع صراخهم. نتحادث مع الأطفال حول خبرتهم في مساعدة الجيران لهم في مناسبات مختلفة.
- من الممتع دعوة جدّة أو جدّ لسرد احكاية الشّعبية الأصليّة، أو اي حكاية شعبية أخرى ملائمة للأطفال.
نشاط مع الأهل
- يتّهم الفئران الطّيور بأكل الثّمار، فيغضبون ويلعنون. نتحدّث مع الطّفل حول ردّ فعل الفئران الغاضب والمتسرّع. ما أسبابه؟ نسترجع مع طفلنا مواقف قد تحدث في حياتنا اليومية، نردّ فيها بغضبٍ على حدثٍ ما قبل أن نفهم حقيقته. ماذا نشعر؟ وماذا يمكن أن تكون عاقبة ردّ فعلنا المتسرّع؟
- خبرة برزق مع فئران الحقل ومع الطير الكبير الشّرس، أوحت له بأنّ جميع العصافير شرّيرة ؛ إلى أن سكن عشّ الفراخ وصادقها. نتحادث مع طفلنا حول خبرة مرّ بها، ربّما في العائلة أو الحارة أو البستان، غيّرت فكرته عن شخصٍ ما أو مجموعة.
- في خاتمة القصّة تُشارك الطّيور الفئران بثمار الحقل الحمراء النّاضجة. ماذا يمكن أن تشارك الفئران أصدقاءها الجُدُد؟
- الخريف فصل هجرة الطّيور في بلادنا. قد نرغب باصطحاب طفلنا إلى الحديقة أو إلى البريّة لمراقبة أسراب الطّيور المهاجرة والبحث عن أعشاشها المهجورة.
- ماذا تحبّ الطّيور في محيطنا القريب أن تأكل؟ نصمّم معًا “مطعم طيورٍ” نعلّقه على الشجرة، ونضع أنواع أكلٍ مختلفة ( بذور، فواكه، خضار…) ونتعرّف إلى المأكولات المفضّلة لدى زائري حديقتنا!
- يتميّز أسلوب “لِيوني” باستخدام مُزَق الأوراق لتشكيل شخصيات كتبه. قد نرغب باختبار هذه التّقنية مع طفلنا لتشكيل شخصياته المفضّلة في القصّة!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- صيغة التساؤل في العنوان تثير فضول الأطفال. يمكننا أن نسأل: من هو برزق برأيكم؟ بماذا يذكّركم اسمه؟ (اختارت المترجمة أسماء شخصياتٍ من عالم البذور)، وأين يمكن ان يكون قد ذهب؟
- في القراءة الأولى نتوقّف عند لحظة “دراميّة ” في القصّة، حين سقط برزق في العش. ماذا يمكن أن يحدث؟
- نتوقّف ثانيةً عند مشهد برزق يطلب من الفئران أن تصغي له:. نسأل رأي الأطفال فيما يمكن أن يروي برزق لأصدقائه.
- تثير القصّة عادة لدى الأطفال مشاعر متنوّعة. نشجّع الأطفال على تقمّص شخصيات القصّة والحديث عن مشاعرها، ومن ثمّ التعبير عن مشاعرهم “كقرّاءٍ” أو مستمعين. يمكننا أن نعرض موقفين أو ثلاثة: حين قبض الطّائر الكبير على برزق، وحين وافقت العصفورة الأمّ على بقاء برزق في العشّ، وحين أرادت الفئران أن تهجم على الطّيور. يمكن أيضًا أن تؤدّي مجموعات من الأطفال هذه المشاهد، ويعلّق عليها الآخرون.
- تنتهي القصّة بحفلة أكل البذور الحمراء التي أحضرها الطّيور. نناقش مع الأطفال هذا السّلوك: هل سيوفّر حلاً دائمًا لمشكلة الفئران؟ كيف يمكن أن يعيش الفئران والطّيور في ذات الحقل ويتقاسمون الغذاء، كيف؟
- القصة مدخل لمشاريع تعلّميّة مختلفة حول البيئة والكائنات المختلفة. هذه بعض الأفكار:
- التساؤل مع الأطفال حول طيران الفراخ وأمّها من العشّ مدخلٌ لاستكشاف موضوع هجرة الطّيور.
- تصنيف الكائنات في القصّة إلى مجموعتين: الطّيور التي تعيش في الجوّ، والفئران التي تدبّ على الأرض. يمكن للأطفال أن يصنّفوها وفق معايير عديدة، مثل: تطير أم تمشي- لها أربعة أرجل أم اثنتين- تهجع في الشّتاء- تصدر صوتًا عاليًا/منخفضًا- تأكل لحومًا أو بذورًا. إحدى الطّرق التي تساعد الأطفال في تصنيف المعلومات هي استخدام الرّسوم البيانية، وفي هذه الحالة الدّوائر: أيّ صفاتٍ يختصّ بها كلّ صنفٍ في دائرة منفردة، وأيّ منها يشترك بها الصّنفان في تقاطع الدّائرتين؟
- على إثر النّشاط السّابق، يمكن أن يصمّم الطفل كتابين، واحد على هيئة طير، والآخر على هيئة فأر، ويرسم في كلّ صفحة معلومةً عن الكائن: أين يعيش؟ ماذا يأكل؟ هل يبيض أم يلد؟ وغيرها.
- نشاط آخر ممتع يعزّز مهارة طرح الأسئلة وحفظ المعلومات هو لعبة “مَنْ أنا؟”. نهمس لأحد الأطفال باسم شخصية يتقمّصها، وعلى الأطفال الآخرين أن يطرحوا عليه أسئلةً تهديهم إلى الجواب، مثل: هل تطير أم تمشي؟ هل تحبّ أكل ابذور؟ هل حجمك صغير أم كبير؟ وغيرها.
- لنتخيّل أنّنا نوزّع جوائز على شخصيات القصّة: أيّ شخصيات ستفوز بجائزة الشّجاعة، اللّطافة، الذكاء، “النّغاشة”؟ يمكن أن يصمّم الأطفال كأسًا، أو شريطًا أو تاجًا يُمنح للشخصيات المختلفة. يشاهم هذا النّشاط في تطوير قدرة الأطفال على التّقييم، وعلى فهم السّلوكيات التي تميّز الصّفات الخُلُقيّة.
- لتطوير خيال الأطفال، نقترح عليهم ان يفكّروا في مكان آخر تقع فيه أحداث القصّة: حديقة عامّة في مدينة، أو في حارة سكنيّة. ماذا سيكون موضوع الخلاف بين الطيور والفئران؟ وكيف سيحلّونه؟
- من ضمن كتب الفانوس السابقة كتاب “حكاية الفأر سمسم” للمؤلّف نفسه. وهي حكاية عن فأر شاعرٍ يسلّي أصدقاءه في جحرهم أيّام الشّتاء الباردة. يمكن أن نقرأ الكتاب للأطفال، ونقارن بين صفات برزق وسمسم.
- في صندوق بلاستيكيّ، أو في زاوية من زوايا الحديقة، نصمّم مع الأطفال بيئةً الفئران الطّبيعيّة بما فيها من أوراق، وحجارة، وقواقع وغيرها.
- ندعو الأطفال إلى تأمّل رسومات الكتاب وتمييز النماذج المتكرّرة، مثل: أوراق الشّجر، كتل الصّخور. نخرج معهم إلى الحديقة، ونبحث عن نماذج شبيهة في الطّبيعة. يمكن مثلاً أن يجمع الأطفال أوراق الشجر، ويجفّفوها، ثم يلصقونها على كرتون، ونساعدهم على تغليفها بنايلون لتستخدم كمؤشّر كتاب، أو بطاقة إهداء، وما إلى ذلك.
- يتمتّع الأطفال بمسرحة القصّة، مستخدمين تجسيداتٍ مختلفة لشخصيات القصّة يصمّمونها بأنفسهم: قد تكون وجوهًا مرسومة على صحون كرتونيّة، أو دمى أصابع/كفّ/عصيّ مصنوعة من خردة وقطع قماش، وريش وأزرار وغيرها.
- تتميّز رسومات الكتاب بتقنيّة خاصّة، هي بناء كولاج من مُزَق الأوراق. يتمتّع الأطفال باختبارها، لكن نشير على أنّ تمزيق الأوراق بأشكال قد يكةن تحدّيًا لبعض الأطفال الّذين يتردّدون في “خوض مغامرة” تمزيق الورق دون مقصّ أو اتّباع خطوط مرسومة. يمكن التّسهيل على أولئك الأطفال بتحضير نماذج بيضاويّة من الورق الرّمادي ( لصنع الفأر) تساعد الأطفال في الانطلاق، وفي تقدير صحيح لحجم الفئران نسبة للورقة الكبيرة التي يلصقون عليها الأشكال. ذات الأمر ينسحب على قصاصات الورق الطويلة لتشكيل نباتات الحقل.
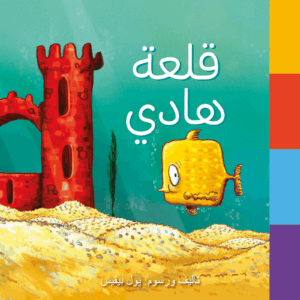 قلعة هادي
قلعة هادي 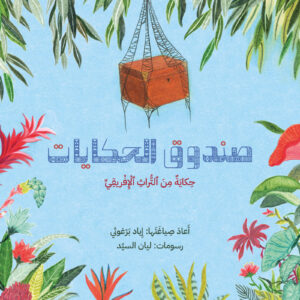 صندوق الحكايات
صندوق الحكايات 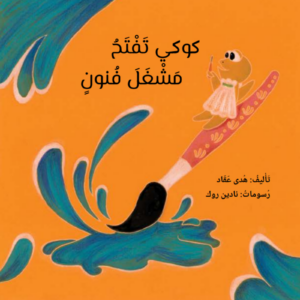 عندما فتحت كوكي مشغل فنون
عندما فتحت كوكي مشغل فنون 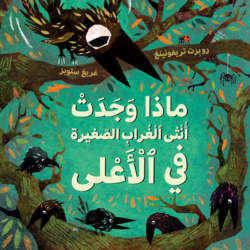 ماذا وجدت أنثى الغراب الصغيرة في الأعلى
ماذا وجدت أنثى الغراب الصغيرة في الأعلى 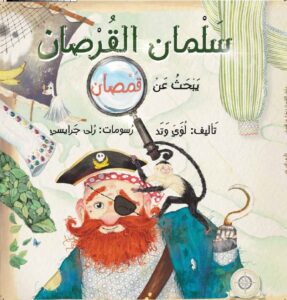 سلمان القرصان يبحث عن قمصان
سلمان القرصان يبحث عن قمصان 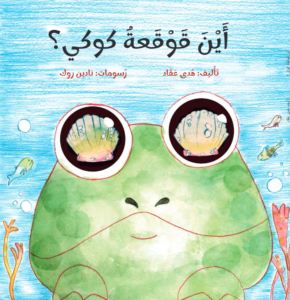 أين قوقعة كوكي؟
أين قوقعة كوكي؟ 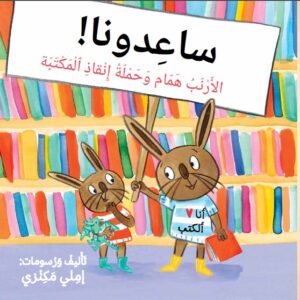 ساعدونا! الأرنب همّام وحملة إنقاذ المكتبة
ساعدونا! الأرنب همّام وحملة إنقاذ المكتبة 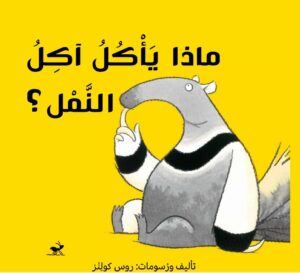 ماذا يأكل آكل النمل؟
ماذا يأكل آكل النمل؟ 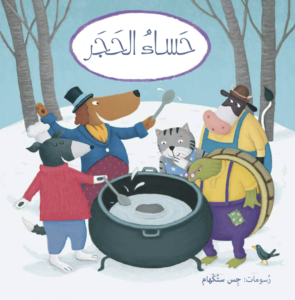 حساء الحجر
حساء الحجر  لا تثق بنمر أبدا
لا تثق بنمر أبدا 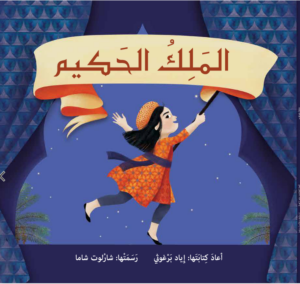 الملك الحكيم
الملك الحكيم 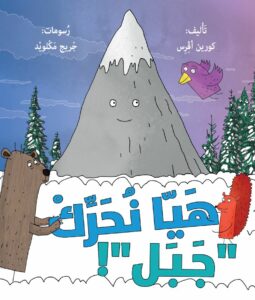 هيّا نحرّك جبل!
هيّا نحرّك جبل! 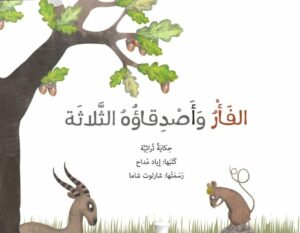 الفأر وأصدقاؤه الثّلاثة
الفأر وأصدقاؤه الثّلاثة 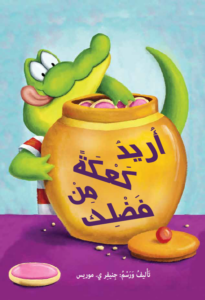 أريد كعكة من فضلك
أريد كعكة من فضلك  أين يجلس الدب البني الكبير؟
أين يجلس الدب البني الكبير؟ 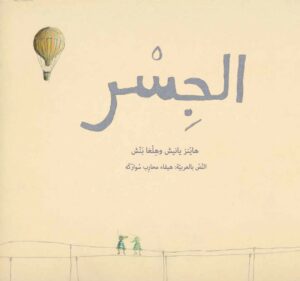 الجسر
الجسر 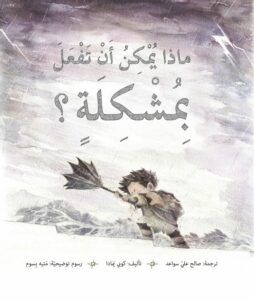 ماذا يمكن أن تفعل بمشكلة
ماذا يمكن أن تفعل بمشكلة 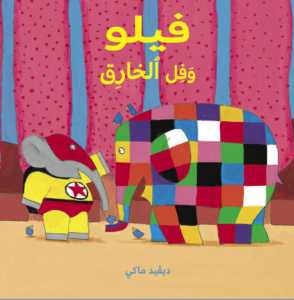 فيلو وفل الخارق
فيلو وفل الخارق 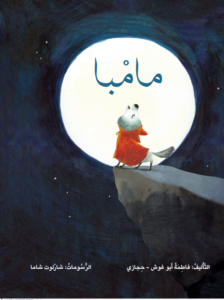 مامبا
مامبا 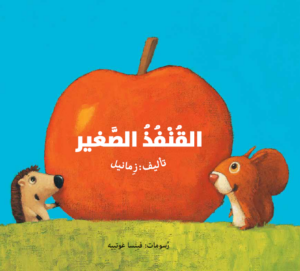 القنفذ الصغير
القنفذ الصغير 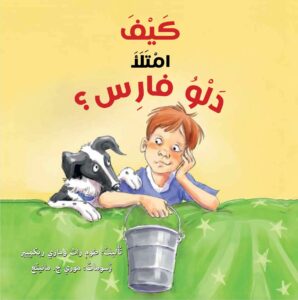 كيف امتلأ دلو فارس؟
كيف امتلأ دلو فارس؟ 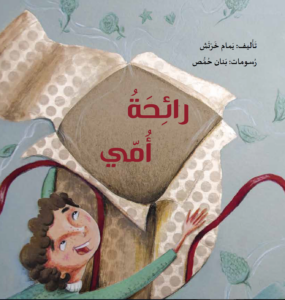 رائحة أمّي
رائحة أمّي 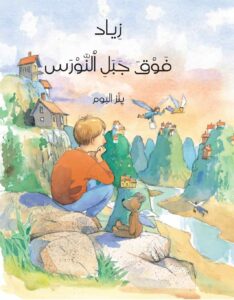 زياد فوق جبل النورس
زياد فوق جبل النورس 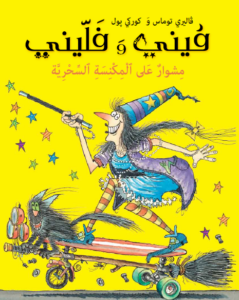 مشوار على المكنسة السحريّة
مشوار على المكنسة السحريّة 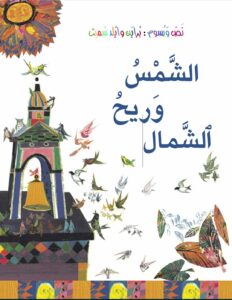 الشمس وريح الشمال
الشمس وريح الشمال 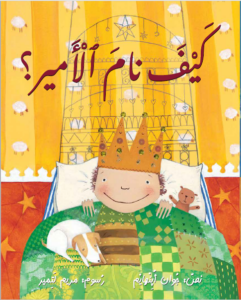 كيف نام الأمير؟
كيف نام الأمير؟ 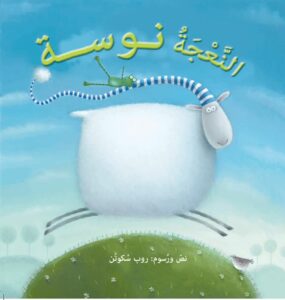 النعجة نوسة
النعجة نوسة 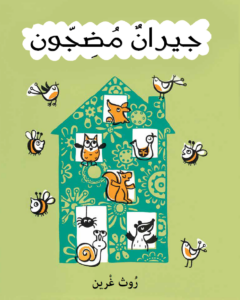 جيران مضجّون
جيران مضجّون 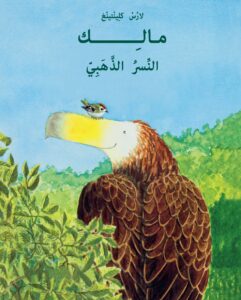 مالك- النسر الذهبّيّ
مالك- النسر الذهبّيّ 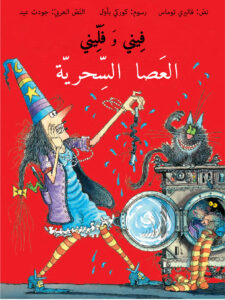 العصا السحريّة
العصا السحريّة 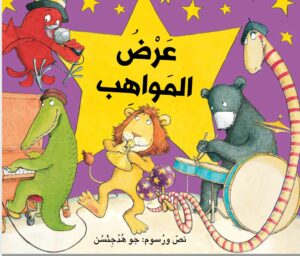 عرض المواهب
عرض المواهب 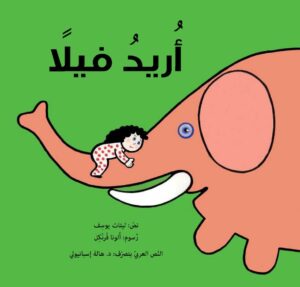 أُريد فيلا
أُريد فيلا 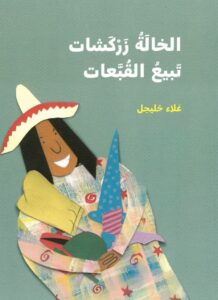 الخالة زركشات تبيع القبّعات
الخالة زركشات تبيع القبّعات 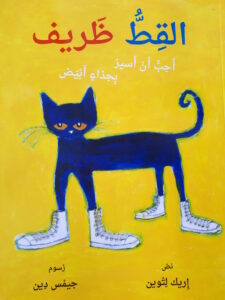 القطّ ظريف – أحبّ أن أسير بحذاء أبيض
القطّ ظريف – أحبّ أن أسير بحذاء أبيض 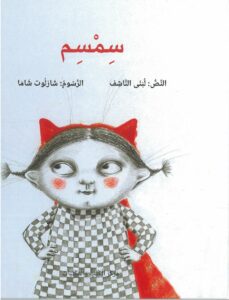 سمسم
سمسم  سعد وقبّعته الجديدة
سعد وقبّعته الجديدة 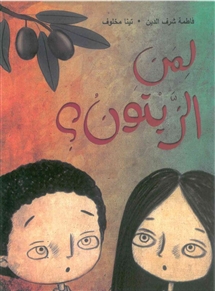 لمن الزيتون؟
لمن الزيتون؟ 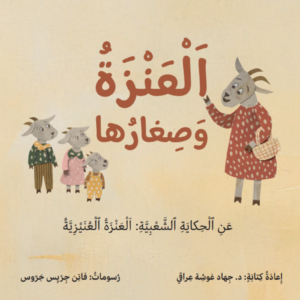 العنزة وصغارها
العنزة وصغارها 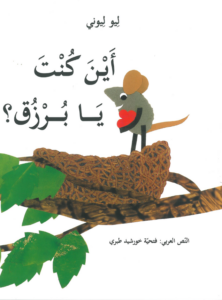 أين كنت يا برزق؟
أين كنت يا برزق؟ 
