نتحادث
حول المشاعر المختلفة: نسأل الطفل: أين الجدّة؟ هل هي موجودة في الحقيقة؟ كيف تشعر الطفلة في القصّة؟ ماذا فعلت كي تتعامل مع اشتياقها؟ هل يمكن أن تكون هناك مشاعر أخرى لدى الطفلة لم تظهر في القصّة؟
حول تجارب مشابهة: نسأل الطفل: هل فقدت مرّة شخصًا أو كائنًا عزيزًا عليك؟ هل تشتاق له؟ ماذا يمكن أن تفعل عندما تشتاق؟ في حال فقدان الجدّ أو الجدّة – نتشارك معًا بذكريات جميلة منه/ها: ماذا كنّا نحبّ أن نفعل سويًّا؟
نتمعَّن
تأخذنا الرسومات إلى العالم الجميل الذي جمع الحفيدة والجدّة. نتمعّن في الرسومات وننتبه إلى الأغراض التي انتقلت من الجدّة إلى الحفيدة، وإلى أغراضٍ أخرى تشبه ما نراه في بيوت أجدادنا.
نبدع
نزور الجدّة أو الجدّ، نخبره/ا كم نحبّه/ا، ونصنع معًا ألبومًا أو صندوقًا مشتركًا من صور وأغراض لذكريات جميلة مع أجدادنا. نذهب سويًّا إلى البحر ونجمع معهم أصدافًا وأحجارًا مختلفة.
نستكشف
نتأمّل الرسومات، ونحاول أن نخمّن في أيّ مدينة يتواجد بيت الجدّة. نستذكر مدنًا ساحليّة أخرى في بلادنا ونتعرّف عليها.
حول الكتاب
تطرق لنا هذه القصّة باب التعامل مع الفقدان عند الأطفال. عندما نتحدّث عن الفقدان، كأن يكون فقدانا صغيرا كضياع لعبة أو الابتعاد عن صديق، ويمكن أن يكون فقدانا كبيرا كوفاة شخص قريب، أو حتّى انفصال الوالدين- هو نوع من أنواع الفقدان- فقدان البيت الواحد الذي كوّن عائلته حتّى الآن.
تركّز هذه القصّة على أحد المشاعر المختلفة، التي نشعر بها في سيرورة الفقدان، وهي الشوق. تشتاق الحفيدة لجدّتها وتستعيد الذكريات الجميلة التي اعتادت أن تفعلها مع جدّتها. لبستْ حليّ ومجوهرات جدّتها وقامت بتذكّر زيارات البحر والطعام في بيت جدّتها، واختتمت برسمة لتخليد ذكراها، قائلة لها إنّها في ذاكرتها وقلبها دومًا. هذه أمثلة لآليّات صحّيّة للتعامل مع الشوق والحنين في سيرورة الفقدان.
يمكن أن نلاحظ مشاعر مختلفة جراء الفقدان مثل الحزن، الألم، الشوق والحنين، الغضب، وحتّى الصمت وغيرها. هذه المشاعر، لا بدّ لنا أن نفهمها ونعطيها الشرعيّة، ونأخذ بيد الطفل لينتج شيئًا منها؛ كعمل فنيّ، مشاركة لذكرى، طقوس دينيّة، وغيرها. علينا ألّا نستعجل الطفل في المبادرة، بل إعطاؤه الإمكانيّة والوقت والصبر ليتقدّم بوتيرته هو، واستعداده للمضيّ قدمًا.
الأطفال كما نحن، بحاجة إلى الوقت والدعم وإيجاد الوسائل التي تساعد على تجاوز صعوبة الفقدان. هذه السيرورة يمكن أن تستمرّ شهورا حتّى سنوات، كي يجد الطفل توازنه من جديد.
عقب القصة، يمكننا أن نستذكر مع الأطفال تجارب مختلفة حول نهايات لمراحل معيّنة من حياتهم، مثل- نهاية الروضة، نهاية البستان، دورة إلخ.. كلّها كانت صعبة آنذاك، لكنّ الأطفال مرّوا بها بسلام. نشدّد أنّ هذه هي سنّة الحياة هناك بداية ونهاية. كما مررنا بهذه المراحل، سنمرّ ونعبر ما نفتقده بسلام. هكذا نزيد من وعيهم وحصانتهم للتعامل مع الفقدان أو النهايات.
نتحادث
حول المشاعر المختلفة في القصّة– كيف برأيك كانت علاقة الطفلة مع جدّتها؟ هل الجدّة موجودة؟ ما هو شعور الطفلة وكيف ساعدت نفسها؟ هل يمكن أن تكون مشاعر أخرى عند الطفلة ولم تتكلّم عنها في القصّة؟ هل أعجبتكم فكرة الطفلة في نهاية القصّة؟
حول تجارب مشابهة– يمكننا أن نطلب من الأطفال تذكُّر شيء أو شخص فقدوه، ولم يعد بحوزتهم أو معهم. نشجّع الأطفال في الصفّ على التعبير عن مشاعرهم المختلفة جراء الفقدان، مثل الحزن، الألم، الشوق والحنين وحتّى الغضب. نشجّع الأطفال على رسم شعورهم أو تجسيده بعمل فنّيّ من المعجون أو أيّ شيء آخر. هل لديكم أفكار أخرى يمكن أن نفعلها، كي نتذكّر شيئا أو شخصا فقدناه؟
نتشارك- كيف نقضي وقتنا عند الأجداد؟ ماذا نحبّ أن نفعل أو نأكل في بيت جدّنا أو جدّتنا؟ لو كان بإمكانك أن تذهب إلى مكان مع جدّتك، أيّ مكان تختار؟
نثري لغتنا
نثري المقدرة على النحو من خلال تعلّم استعمال كلمات السؤال– تحوي القصّة أسئلة متنوّعة، ومنها أسئلة استفهام وأسئلة استنكاريّة، نتعرّف على صيغة السؤال مع الأطفال ونتمرّن معًا– يمكننا أن نقيم حفل الأسئلة ونسأل أصدقاءنا، نشجّع استعمال كلمات مثل- كيف؟ لماذا؟ ماذا؟ من؟ أين؟ متى؟ ما؟ كم؟
نثري قاموسنا اللغويّ- نتعرّف على أسماء لأكلات شعبيّة– تحوي القصّة أسماء لأكلات شعبيّة مثل “البحتة” و”الشيشبرك”. نتعرّف مع الأطفال على أصناف وأسماء لوصفات شعبيّة مختلفة.
نتواصل
يوم للأجداد– ندعو الأجداد ونقضي يومًا ممتعًا معًا في الصفّ. نفكّر بفعاليّات ملائمة مثل- رسم لوحة مشتركة/ طبخة أحبّها من يدي جدّتي/ تقديم فقرة/ قصّة إلخ.
مقابلة الأجداد– نطلب من الأطفال إجراء مقابلة مع جدّهم أو جدتهم، تضمّ أسئلة عن طفولتهم وعن أكلات شعبيّة يحبّونها، وغيرها من الأسئلة اللطيفة.
نستكشف
نتعرّف على المدن الساحليّة في البلاد، وما يميّز كلّ واحدة منها. نقوم بزيارة ميدانيّة لإحداها. نزور الأماكن التاريخيّة والمميّزة في المدينة.
الأهل الأعزّاء
كيف يتعامل طفلنا مع التجارب الجديدة؟ هل يشعر بالتوتّر والخوف؟ وهل يحتاج إلى وقت للتكيّف مع الوضع الجديد؟
يجد الضفدع الصغير نفسه في بيئة مختلفة عن البيئة المألوفة له، فيشعر بالقلق ويرتاب من كلّ صوت جديد ويمرّ في لحظات صعبة؛ إلّا أنّه يستجمع قوّته وشجاعته ليعود إلى مكانه المألوف ويحظى بالطمأنينة إلى جانب والده، فيغطّ في نوم عميق.
تزخر حياة طفلنا بالتجارب الجديدة؛ مثل الذهاب إلى الروضة، تعلّم ركوب الدرّاجة، تبديل ملابسه وحده، والذهاب إلى الدكّان وغيرها. بعضها سهل وبعضها الآخر يشكّل تحدّيًا صعبًا، لكنّها كلّها تجارب مهمّة لطفلنا، إذ تصقل مهاراته المختلفة وتزيد من إدراكه لقدراته وإمكانيّاته. بالمقابل، قد تخلق بعض هذه التجارب مشاعرَ كالقلق والخوف، وتحتاج من الطفل إلى شجاعة ومبادرة في الاستكشاف.
كان الراوي/ الطفل المستمع اليد المسانِدة للضفدع، فبشرحه البسيط والمطمئن وضّح له مصدر الضجيج وخفّف من روعه؛ وبذا تمكّن الضفدع الصغير من أن يعود الي بيته. إنّ المعرفة قوّة، ومن شأنها أن تخفّف حدّة القلق والخوف. لِنُمسكْ بيد طفلنا القلِق، ونشرح له ونساعده على فهم ما يدور من حوله ليطمئن. ولنَكُنْ، نحن الأهل، شاطئ الأمان الذي يحتاجه بعد كلّ هذه التجارب كي يجمع قربنا قواه، ويشحن طاقاته، ويصقل شجاعته استعدادًا لمغامرة جديدة.
نتحادث
حول أحداث القصّة- لماذا قفز الضفدع كلّ مرّة؟ بمَ كان يشعر؟ كيف كان يتصرّف عندما كان قلقا؟ من الذي ساعد الضفدع في إكمال مشواره؟ كيف؟ كيف انتهت القصّة؟ وماذا شعر الضفدع في آخر القصّة ولماذا؟
حول تجارب شبيهة- هل سبق وخضت تجربة جديدة؟ أو هل سبق وضِعْتَ مرّة؟ بمَ شعرت؟ وكيف تصرّفت؟ أحسّ الضفدع بالأمان عندما وصل أخيرا عند أبيه. وأنت ما الذي يجعلك تشعر بالأمان عندما تقلق؟ إلى ما تحتاج كي تتشجّع وتخوض تجربة جديدة؟
نثري لغتنا
- قاموسنا اللغويّ- نتعرّف على كلمات جديدة ونقرّب معناها- ضجّة، انصرفي، شقيّة، أعالي الأشجار.
- وصفنا الشعوريّ- تزخر القصّة بمفردات تصف حالة القلق مثل – متوتّر، قلِق، أرعبت، مخيف.. نبرز هذه الكلمات ونشجّع على استعمالها في البيئة الصفّيّة، وبالحديث مع الأطفال، وخصوصا عندما تعكسين للطفل حالته الشعوريّة.
- قاموسنا الكمّيّ- نعدّ الضفادع في الرسمة الأولى ونعدّ الحيوانات المختلفة، ومن ثمّ نعدّ معًا قفزات الضفدع العشر حتّى وصل قمّة الشجرة.
- معلوماتنا وثروتنا اللغويّة العامّة- في الطريق قابل الضفدع حيوانات عديدة – سلحفاة، خنفساء، قرود، أفعى، نقّار الخشب. نتعرّف عليها وعلى بيئتها. ماذا تأكل وأين تعيش؟ وما هو صوتها؟
- الوعي الصوتيّ- تزخر القصّة بوحدات صوتيّة تعكس أصواتًا مختلفة، طُش طَش، نُق نُق، كِش كِش وغيرها. نختار أمورا مختلفة ونخترع لها صوتا- مثلا – صوت الغسّالة في البيت، صوت الساعة، صوت العصفور، صوت السيّارة، صوت طبخة ماما تغلي على الغاز وغيرها.
نبحث
- ضفدع الشجر هو بطل الكتاب، نتعرّف على أنواع الضفادع المختلفة وألوانها الزاهية من خلال البحث في الإنترنت. نبحث ونتعلّم عن مراحل تطوّر الضفدع ونقوم بعرضها، رسمها أو تمثيلها من قبل أطفال مختلفين أمام الصفّ.
نمرّن قفزاتنا الضفدعيّة– في ساحة الصفّ، نبني مسارا للقفز عليه مثل الضفادع ونحاول ألّا نمسّ الأرض بأقدامنا.
نبدع
- نرسم لوحات مختلفة بفنّ الكولاج – نقصّ ونلزق أشكالا وألوانا مختلفة لنحصل على لوحة من وحي الكتاب.
- نستخدم صندوق أحذية لإنشاء نموذج بيئيّ مصغّر لضفدع الشجر. نقوم بإدخال الأوراق، الفروع، والبرك الصغيرة. يمكن للأطفال وضع لعبة ضفدع صغيرة أو رسم الضفدع داخل الديوراما لعرض المكان الذي قد يعيش وينام فيه. هذه الفعالية يمكن أن تساعدهم على فهم المزيد عن البيئة الطبيعيّة لدى الضفادع.
- للمزيد من الشرح حول فنّ بناء المجسّمات الصغيرة، يمكن الاستعانة بالروابط المرفقة أدناه:
نتحادث
نتحادث
حول المواقف والمشاعر: نسأل طفلنا: لِمَ كان الضفدع يهرب؟ بِمَ كان يشعر؟ بِمَ كان يفكّر؟ ما الذي ساعده؟ وما الذي احتاجه كي يتوقّف عن الهرب؟
حول التجارب والأماكن الجديدة: نسأل طفلنا: هل كنت مرّة في مكان جديد عليك؟ كيف كان شعورك؟ كيف تصرّفت؟ ما الذي يساعدك في التغلّب على القلق ومواجهة التحدّيات؟
نتمعّن ونستمتع
نتمعّن ونستمتع
استخدمت الرسّامة تقنيّة الكولاج في رسومات القصّة. نتمعّن في الرسومات ونحاول أن نميّز مخلوقات أخرى مختبئة في الصورة. نبحث عنها ونسمّيها.
نبحث ونستكشف
نبحث ونَسْتَكْشِف
- ذُكِرَ في القصّة نوعان من الضفادع: ضفدع المستنقع، وضفدع الشجر. ما الفرق بينهما؟ وما مميّزات كلّ نوع منهما؟
- نستكشف المراحل المختلفة لتطوّر الضفدع.
- يمكننا، أيضًا أن نزور الغابة أو الوادي، أو الحديقة العامّة القريبة منّا، ونراقب الكائنات الحيّة المختلفة ونحاول أن نقلّد أصواتها.
نلعب معًا
نلعبُ معًا
نمرّن قفزاتنا الضفدعيّة، فنتخيّل أنّ أرضيّة البيت هي المستنقع، ثمّ نبني مسارًا في البيت مستخدمين المخدّات والبُسُط كمحطّات، ونتنقّل بينها كما تفعل الضفادع في المستنقع.
حول الكتاب
هل رأيتِ طفلًا مستاءً! كيف تتعاملين معه؟ وكيف يؤثّر ذلك على الآخرين؟
يسلّط الكتاب الضوء على حالة شعوريّة طبيعيّة؛ يمكن أن يمرّ بها الطفل وتدعوه للتصرّف بشكل غير مألوف، بل حتّى عدوانيّ أحيانًا، إنّها حالة الاستياء. هناك أسباب عديدة يمكنها أن تخلّ بالتوازن العاطفيّ عند الطفل وتجعله يشعر بالاستياء، قد تكون واضحة أحيانًا وغير واضحة في أحيان أخرى. من المهمّ لنا كبالغين أن نعطي حيّزًا للمشاعر السلبيّة، ونحاول فهمها والتعامل معها، وأن نولِيَ أهمّيّة لمشاركة المشاعر مع الآخرين، مثل الأصدقاء، والتي من شأنها أن تنمّي المهارات الاجتماعيّة المختلفة؛ كالشعور بالآخر، طلب المساعدة وغيرها. مهارة الشعور بالآخر وقيمة المساعدة تُعتَبَران من الخصال المهمّة في بناء الحصانة النفسيّة عند الطفل؛ فكلّما ساعد الطفل الآخرين تعزّز شعوره بأنّه إنسان مهمّ وقويّ.
أبرز الكتابُ أهمّيّة المرافقة المعنويّة والعمليّة للطفل الذي يشعر بالاستياء، تمامًا كما رافقت الحيوانات صديقها العصفور كلّ الطريق، شعرت بحالته واقترحت عليه المساعدة في تخفيف هذه المشاعر كالمشي بالطبيعة واللعب.
كذلك في الصفّ، عندما يشعر الطفل بالاستياء يكون بحاجة لنا ولمرافقتنا، لنفهم شعوره ونمرّر له رسالة مفادها: “نحن معًا”، ثمّ نقترح عليه مساعدة- كاللعب، أو القيام بفعاليّة مشتركة، أو أن نوفّر له مرافقة صامتة ومُحبِّة، ومزيدًا من الوقت ليهدأ.
نتحدّث عن المواقف المختلفة بشكل متسلسل
نتحاور
- حول الرسومات: نتتبّع العصفور وننظر إلى التعابير العاطفيّة. نوجّه اهتمام الأطفال لاستعمال الألوان المختلفة للتعبير عن مشاعرهم؟ ونتحدّث عن المواقف المختلفة بشكل متسلسل.
- حول الشعور بالاستياء: نسأل الأطفال، مثلًا، ما الذي يسبِّب لنا شعورًا بالاستياء؟
لتوضيح المعنى، نستعمل مرادفات للكلمة حتّى يفهمها الطفل الصغير- مثل غير راضٍ، متضايق، يشعر بالامتعاض، منرفز، زعلان، حردان، مقلوب المزاج..
- ما الذي أشعره بجسمي وقت الاستياء؟ كيف تكون تعابير وجهي؟ كيف أتصرّف؟
- ما هي الأمور التي تساعدني كي أهدأ؟ ومن هم الأشخاص الذين يساعدونني على ذلك؟
مثلًا: الانتظار قليلًا، العناق، اللّعب، التحدّث مع صديق، الرسم، إلخ.
نوسّع القاموس اللغويّ الشعوريّ للأطفال
نثري لغتنا
نوسّع القاموس اللغويّ الشعوريّ للأطفال. مثلًا: نتساءل ما مع معنى كلمة مُستَاء؟ يمكننا أن نقترح كلمات قريبة في معناها لإثراء القاموس اللغويّ وتيسير استعمالها – مُستَاء، غير راضٍ، متضايق، يشعر بالامتعاض، زعلان، مُعكّر المزاج…
تشجيع الأطفال على استعمال السؤالونذوّت القِيَم
نتواصل ونذوّت القِيَم
“هيّا نساعد صديقًا!”
نكرّس فقرة يوميّة كي يشاركنا الأطفال إجاباتهم حول السؤال: كيف قدّمت المساعدة اليوم؟ ونشجّعهم على استعمال سؤال: هل تريد المساعدة؟ ونقترح طُرُقًا لذلك: كتقديم وعاء ماء للحيوانات، مساعدة صديق في الصفّ، مساعدة أحد الوالدين.
نلعب "حلقة تقليد الحيوانات"
نلعب
“حلقة تقليد الحيوانات”- نقف في حلقة، يمكن لكلّ طفل أن يختار حيوانًا ويؤدّي حركة مميّزة في تقليد هذا الحيوان، ومن ثمّ يقوم الأطفال الآخرون بتقليده. يقفز كالضفدع، يطير كالعصفور، يتثاءب كالكسلان، يزأر كالأسد، يزحف كالأفعى وغيرها.
نكتشف أنواع وأشكال الطيور
نكتشف
أنواع وأشكال الطيور: نبحث في الموسوعات الصفّيّة عن الطيور، نتعرّف على أعشاشها، أنواعها وطرائق معيشتها. نستكشف الطيور التي تعيش في الجوار، نصوّرها ونبحث في مرشد الطيور عن أسمائها ومعلومات عنها.
تقمّص الشخصيّات المختلفة وتقسيم المهامّ والأدوار اليوميّة
نبدع
- محطّة استجلاب الطيور: نخطّط ونحدّد معًا منطقة معيّنة في الساحة. نقسّم المهامّ والأدوار اليوميّة بيننا؛ كسكب المياه في الوعاء المخّصص، وتجميع بقايا الطعام من وجبتنا الصباحيّة، ثمّ نحدّد منطقة بعيدة لمراقبة الطّيور الوافدة إلينا. نستعين بمرشد الطّيور للتّعرف إلى أسمائها وصفاتها المختلفة.
- الدراما هي وسيلة ممتازة لتذويت المضامين والقيم، ولتحفيز مهارات مختلفة كالقدرة على الإبداع وتقمّص الشخصيات وتعزيز الثقة بالنفس وغيرها. يمكننا أن نقوم بتمثيل القصّة وتقمّص الشخصيّات المختلفة فيها وتأدية المشاعر المختلفة.
نشارك أطفالنا خبرتنا، ونشجّعهم على مشاركة خبراتهم
- ما الذي يسبِّب لنا شعورًا بالاستياء؟ لتوضيح المعنى، نستعمل مرادفات للكلمة حتّى يفهمها الطفل الصغير، مثل: غير راضٍ، متضايق، يشعر بالامتعاض، منرفز، زعلان، حردان، مقلوب المزاج…
- كيف أشعر بجسمي عندنا أستاء؟ كيف تكون تعابير وجهي؟ من الجميل أن نشارك أطفالنا خبرتنا، ونشجّعهم على مشاركة خبراتهم.
- ما هي الأمور التي تساعدني لكي أهدأ؟ مثلًا: الانتظار قليلًا، العناق، اللّعب، التحدّث مع صديق، الرسم، وما شابه.
نتأمّل الرسومات ونستدلّ منها مشاعر العصفور من الألوان
نتأمّل الرسومات، ونبحث عمّا يدلّنا فيها عن مشاعر العصفور. ننتبه إلى استخدام الألوان المختلفة للتعبير عنها.
نلعب لعبة "قلَّد حركتي"
نتواصل
- نلعب لعبة “قلَّد حركتي”: في كلّ مرّة يؤدّي الطفل فيها حركة يقوم أفراد العائلة بتقليدها، ثمّ نضيف حركة جديدة عليها، ثمّ نتبادل الأدوار، وهكذا.
- نساعد صديقًا: نحفّز أطفالنا على تقديم المساعدة للغير، ونشجّعهم على استخدام جملٍ، مثل: هل تريد المساعدة؟ أو هل أستطيع أن أساعد؟ يمكن تشجيعهم على الاعتناء بحيوانات الحيّ عن طريق وضع علبة ماء أو طعامٍ لها.
نتحاور
نتحاوَر حول:
المَشاعر: نتحدّث عن مَشاعر الفيل في مشكلته، وفي المَواقف المختلفة، ونلاحظها بعد مساعدة القرد له. نتحدّث عن مشاعر الحيوانات التي أربكَها سلوك الفيل. نتحدّث عن مشاعرنا المتوتّرة أو الغاضبة وسبُل التعامل معها دون تخريب.
ردود الأفعال: نلاحظ سلوك الفيل، وردود أفعال الشخصيّات. ننتبه لاستجابة الفيل لمساعدة القرد، وكيف ساهمت في حلّ المشكلة. نربطها بمواقف من حياتنا وخبراتنا الشخصيّة. كيف نعبّر عن مشاعرنا المؤلمة في الأزمات؟ كيف نساعد شخصًا في أزمةٍ أو ضائقة؟
الأزمات: ضائقة/ مشكلة/ أزمة- ماذا نعني بها؟ هل مررنا بمواقف مشابهة؟ نصفها ونستذكر مشاعرنا فيها. مَن ساعدَنا وكيف؟ هل ساعدنا شخصًا في أزمة أو مشكلة؟
خطوات مساندة: “أهدأ/ قف أرجوك أنا هنا لأساعدك”. هكذا منَح القرد الفيلَ أمانًا ليساعده في الحلّ. نتحدّث عن الخطوات التي تساعدنا في مواقف مربكة. قد نتنفّس ببطء/ نطلب المساعدة/ نجلس في ركنٍ هادئ/ نعبّر عن شعورنا ونسمّيه. ماذا أيضًا؟
البيئة: شكّل الكيس خطرًا على الفيل. نتحدّث عن مساهمتنا في المحافظة على البيئة والأحياء.
نُثري لغتنا
المفردات: نقرأ النصّ ونوضح معاني المفردات. نتعرّف على تسمية المشاعر المختلفة وكيفيّة التعبير عنها.
الأفعال:
نميّز الأفعال الحركيّة: ركض/ اندفع/ هزّ/ طارت/ تقدّم/ داس/ قفز.. نؤدّيها حركيًّا ونلاحظ أثرها. نقترح أفعالًا حركيّةً أخرى ونلاحظ الفرق بينها.
نميّز الأفعال الكلاميّة: صرخ/ تجادل/ تناقش/ تساءل.. نلاحظ الفرق بينها ونقترح ما يلائمنا للتعبير.
نميّز الأفعال الشعوريّة: شعر بالاختناق/ خاف/ ضايق/ غضب. نتحدّث عن المشاعر وإشاراتها في الجسد وتعابيرها في ملامحنا، وطرق التعبير عنها.
الصّفات: نلاحظ صفات فيلون في النصّ، مَن يشبه ممّن نعرف؟ نقارن بين لطفه مع أصدقائه وسلوكه مع المشكلة. نلاحظ صفات القرد وبقية الحيوانات. ماذا نستنتج عن كلّ منها؟
أسماء التحبّب: فيلون صيغة تصغير للفيل. ما هي الصّيَغ التي يحبّها أطفالنا لمناداتهم؟ نلاحظ الصيغ الصرفية الممكنة. قد نضيف للاسم مقطعًا أو نغيّر وزنه.
نلعب
ماذا في الصّورة: نجمع مجموعة صوَرٍ لمواقف حياتيّة، نتمعّن ونتعرّف على المشكلة فيها، ونقترح حلولًا ملائمة. (مثلًا: طفلٌ يبكي/ طفلان يتشاجران على لعبة/ طفلٌ سقط عن الزلاجة).
مَن أنا؟: تتّفق المربّية مع أحد الأطفال على أداء شخصيّة حيوانٍ ما. يقلّد الطفل الحيوان، ويكون على بقيّة الأطفال أن يعرفوه. نوجّه الأطفال إلى التعبير عن الحيوان بالجسد، ثمّ بالحركة، ثمّ بالصّوت.
نستكشف
نستكشف:
الغابة والحيوانات: في النصّ كثيرٌ من محتويات الغابة، ومختلف مواقعها وسكّانها. نبحث عن صوَرٍ ومعلوماتٍ عنها في الموسوعات والمَواقع. نستمتع بالتعرّف عليها وعلى بيئاتها وظروف معيشتها. قد نعدّ موسوعةً خاصّةً نضيفها إلى مكتبتنا، وقد نستعين بها لإنتاج غابتنا في ركن البناء.
نبدع
في بستاننا مسرح: نؤدّي مَشاهد من القصّة. كيف تتحرّك الشخصيّة؟ نلاحظ نبرة صوتها وطريقة تعبيرها. كيف يتحرّك الفيل والكيس في خرطومه؟ كيف تتساءل الزرافة عن حلّ؟ إلخ.
بستاننا أخضر: تسبّب الكيس بمشكلةٍ لفيلون. ماذا يقترح أطفالنا لاستحداث موادّ ومهملات بدلًا من رَميها؟ هل نقيم ورشةً للاستحداث ونُعيد إنتاج الموادّ بطرقٍ إبداعيّة؟ قد ننتج أيضًا مجسّماتٍ للحيوانات من الموادّ المستحدثة.
صندوق الأدوات للأزمات: نخصّص ركنًا صغيرًا في البستان، ونعدّ فيه صندوقًا لمساعدتنا في المواقف المزعجة. نفكّر معًا في أمورٍ من شأنها مساعدتنا في الأزمات، قد تكون جملةً نكرّرها عند الضيق :”أنا منزعج / غاضب/ مرتبك، لكن سأحاول أن أهدأ”. أو مقولةً داعمةً منّا نساند بها بعضنا، مثل: “أنا أحبّك/ أنا معك/ لا تقلق سأساعدك/ تعال نفكّر معًا”. نصغي إلى اقتراحات الأطفال ونضيفها في صندوق أدواتنا، ليلجأ إليها الأطفال عند الحاجة. (مثل: قراءة قصّة/ سماع موسيقى هادئة/ تأمّل صورة لمنظر طبيعيّ).
نتواصل
نتواصل:
نحافظ على البيئة: نفكّر معًا في طرق حماية البيئة والمحافظة عليها. قد نقترح مبادرةً لتنظيف مدخل البستان، أو تزيين البيئة بالنباتات. قد ندعو الأهل والأجداد لمشاركتنا في ورشةٍ خاصّة.
نساند بعضنا: نستضيف أخصّائيًّا في لقاءٍ مع الأهل، ونكتسب طرقًا وآليّاتٍ جديدةً للتعبير عن مشاعرنا، ولمدّ يد العون لمَن هم في ضائقة. قد نبادر أيضًا لمشروعٍ خيريٍّ لدعم المحتاجين في بلدتنا.
نتحاور
نتحاوَر حول…
المَشاعر: نتحدّث عن مَشاعر الفيل في المَواقف المختلفة. نستكشف مشاعر الحيوانات التي أربكَها سلوك الفيل، ونتحادث عن مشاعرنا المتوتّرة أو الغاضبة وسبُل التعامل معها دون تخريب.
ردود الأفعال: نلاحظ سلوك الفيل، وردود أفعال الشخصيّات. ننتبه لاستجابة الفيل لمساعدة القرد، وكيف ساهمت في حلّ المشكلة، ونربطها بمواقف من حياتنا العائليّة.
ضائقة/ مشكلة/ أزمة- ماذا نعني به، وهل مررنا بها؟ نصفها ونستذكر مشاعرنا فيها: مَن ساعدَنا وكيف؟ هل ساعدْنا شخصًا في مشكلة؟
خطوات مساندة: “اهدأ أرجوك، أنا هنا لأساعدك”، طمأن القرد الفيل. نتحدّث عن الخطوات التي تساعدنا في مواقف ضاغطة.
البيئة: شكّل الكيس خطرًا على الفيل. نتحدّث عن مساهمتنا في المحافظة على البيئة والأحياء.
نثري لغتنا
نُثري لغتنا
نقرأ النصّ ونوضح معاني المفردات. نتعرّف على تسمية المشاعر المختلفة وكيفيّة التعبير عنها. نتعرّف على الأفعال في النصّ، معانيها، أصواتها وحروفها. نلاحظها مع المذكّر والمؤنّث.
نتعرّف على الصّفات: نلاحظ صفات فيلون في النصّ، مَن يشبه ممّن نعرف؟ ما هي صفات كلّ فردٍ في عائلتنا؟
نستكشف
نستكشف
في النصّ كثيرٌ من محتويات الغابة، ومختلف مواقعها وسكّانها. نبحث عن صوَرٍ ومعلوماتٍ عنها في الموسوعات والمَواقع. نتعرّف على البلاد التي فيها غابات، وقد نزور حديقة حيوان.
نبدع
نبدع
الصّندوق السحريّ: نفكّر معًا في أمورٍ من شأنها مساعدة الطفل في الأزمات، قد تكون مقولةً منّا مثل :”أنا معك وتعال نفكّر معًا”، أو غرضًا يحبّه، أو صورةً لعناقٍ يجمع عائلتنا. قد نضيف جملًا مطمئنة، مثل: “أنا أحبّك” أو جملًا يكرّرها الطفل لنفسه: “أنا منزعج /غاضب، لكن سأحاول أن أهدأ”، أو صورةً لمكانٍ طبيعيّ/ لشخصٍ يتنفّس بهدوء.
نجمع الأدوات في صندوقٍ، نزيّنه ونجهّزه للمَواقف المربكة. قد نتّفق أيضًا على ركن صغيرٍ في بيتنا يلجأ إليه الطفل عند الحاجة، نضع فيه الصّندوق، ليكون مخصَّصًا لتخفيف التوتّر وإعلان طلب المساعدة.
نتواصل
نتواصل
نفكّر معًا في طرق حماية البيئة والمحافظة عليها. كيف يمكن أن نجعل من بيتنا وحارتنا مكانًا آمنًا؟ قد نقترح مبادرةً لطيفةً لتنظيف السّاحة أو الحديقة، أو لتزيين مدخل الحيّ مع الجيران.
نتحادث
نتحادث حول:
الحبكة: نراقب تفاصيل الرّسومات، ونشجّع طفلنا على وصفها، نتتبّع مسار الأحداث، ونربط بينها. نلاحظ تغيّر مشهد البحر، والطفلة والطيور، ونصِف مشاعر الطفلة في كلّ مرّة.
خبراتنا الذاتيّة: هل اختبرنا شعورًا مشابهًا؟ كيف ومتى؟ نستذكر رحلاتنا ومغامراتنا ولحظاتنا وتجاربنا المختلفة.
البحار والطبيعة: بماذا يذكّرنا البحر؟ أيّة بحار قد زرنا؟ أية أماكن طبيعيّة أخرى نعرف؟ نقارن بينها: بماذا تتشابه أو تختلف؟
كتب الرّسومات: يمثّل الكتاب لونًا أدبيًّا خاصًّا، يعرض الحكاية من خلال الرّسومات، ويترك لنا مهمّة الوصف بالكلمات. نتحاور حول هذا “الجانر”، نتحدّث عن خبرتنا معه، كيف شعرنا في غياب الكلمات؟ كيف أتاح لنا الكتاب وصفَ المَشاهد بحريّة. نتعرّف على كتبٍ أخرى مشابهة. نختار لوحةً من الكتاب ونتعمّق في تفاصيل وصفها.
التعامل مع الخبرات الجديدة: تتجلّى في الرّسومات مَشاهد احتفاء الطفلة بالبحر، ونلاحظ مَشاعرها المختلفة في كلّ مشهد. نتحدّث عن مشاعرنا في خبراتنا الجديدة كدخول البستان أو زيارة مكانٍ جديد. كيف شعرنا؟ ماذا فعلنا؟
نثري لغتنا
نتحادث حول:
الحبكة: نراقب تفاصيل الرّسومات، ونشجّع طفلنا على وصفها، نتتبّع مسار الأحداث، ونربط بينها. نلاحظ تغيّر مشهد البحر، والطفلة والطيور، ونصِف مشاعر الطفلة في كلّ مرّة.
خبراتنا الذاتيّة: هل اختبرنا شعورًا مشابهًا؟ كيف ومتى؟ نستذكر رحلاتنا ومغامراتنا ولحظاتنا وتجاربنا المختلفة.
البحار والطبيعة: بماذا يذكّرنا البحر؟ أيّة بحار قد زرنا؟ أية أماكن طبيعيّة أخرى نعرف؟ نقارن بينها: بماذا تتشابه أو تختلف؟
كتب الرّسومات: يمثّل الكتاب لونًا أدبيًّا خاصًّا، يعرض الحكاية من خلال الرّسومات، ويترك لنا مهمّة الوصف بالكلمات. نتحاور حول هذا “الجانر”، نتحدّث عن خبرتنا معه، كيف شعرنا في غياب الكلمات؟ كيف أتاح لنا الكتاب وصفَ المَشاهد بحريّة. نتعرّف على كتبٍ أخرى مشابهة. نختار لوحةً من الكتاب ونتعمّق في تفاصيل وصفها.
التعامل مع الخبرات الجديدة: تتجلّى في الرّسومات مَشاهد احتفاء الطفلة بالبحر، ونلاحظ مَشاعرها المختلفة في كلّ مشهد. نتحدّث عن مشاعرنا في خبراتنا الجديدة كدخول البستان أو زيارة مكانٍ جديد. كيف شعرنا؟ ماذا فعلنا؟
نلعب
برّ- بحر: نقسم المساحة إلى قسمَين (برّ وبحر). يوجّه أحد الأطفال رفاقه ويكون عليهم التركيز والانتقال إلى المساحة المطلوبة. يمكن استثمار اللعبة مع مفرداتٍ أخرى نختارها، مثل: صيف- شتاء/ موجة- شاطئ وغيرها.
بدون كلام: نتوزّع في فريقَين، ونتّفق على إشاراتٍ تدلّ على الأشياء، ونحزّر بعضنا عنها من خلال الحركات. يشرح كلّ مندوبٍ لفريقه عن كلمة حتى يعرفوها. قد نختار كلماتٍ من بستاننا، مثل: مساحة الإنتاج/ مساحة البناء/ السّاحة.
مسرح الطّبيعة: نؤدّي مَشاهد القصّة، ونضيف مشاهد متخيّلة وفقًا لرغبة الأطفال. مَن يكون المَوج/ البحر/ الطفلة/ الريح؟ نصِف كلّ عنصرٍ ونعبّر عنه بالحركات والأصوات الملائمة. قد نحزّر الأطفال أيضًا فيتحرّك أحدهم بالاتّفاق مع المربّية ويكون على البقيّة تخمين ما يعبّر عنه. كما يمكن أن نطوّر مساحةً في البستان للأنشطة المسرحيّة، نرتّب المسرح ومَقاعد الجمهور. نُعدّ التذاكر، أو نحضّر إعلانًا للعرض.
يوغا البحر: نختار مقطعًا صوتيًّا لهدير أمواج البحر. نتّفق مع الأطفال على حركات اليوغا الملائمة. نصغي ونتحرّك كما لو كنّا أمواجًا/ زائرين/ طيورًا/ أحياءً بحريّة.
نبدع
لوحات من الطبيعة: نجمع موادّ من الطبيعة في نزهتنا، وننتج منها لوحاتٍ، أو مندالا نرتّبها في التسلسل الذي نختاره (أكواز صنوبر/ حجارة/ أوراق شجر).
كتاب رحلاتنا: نجمع صوَرًا من زيارات الأطفال وعائلاتهم إلى أماكن طبيعيّة. نحضّر كتابًا يصِف فيه كلّ طفلٍ رحلته ومشاعره. قد نعدّ الكتاب إلكترونيًّأ، ويشاركنا الأهل بإضافة الصّوَر والأوصاف في ملفّ تشاركيّ.
لوحات من رملٍ أو صدف: يمكننا تحضير لوحاتٍ من أصدافٍ أو زجاجات رملٍ نلوّنه بالطباشير المسحوقة، ونرتّبه وفقًا لرغبتنا.
نستكشف
البحار: نبحث عن معلومات علميّة: كيف يتكوّن الموج؟ أيّة أحياء تعيش في البحر وبماذا تتميّز؟ قد نكتب نصًّا علميًّأ ونقارن بينه وبين نصّنا للقصّة.
الطبيعة القريبة: نزور مكانًا طبيعيًّا قريبًا من البستان. نتمعّن، في تفاصيله، نصغي إلى الأصوات، نتعرّف إلى الكائنات الحيّة فيه، نصِف ونلعب ونستمتع معًا. نقارن بين الموادّ الموجودة وطبيعتها. يلائم هذا النّشاط ركيزة التعلم في مجالات الحياة في البستان المستقبليّ. يمكن استثمار النّشاط للتحضير مع الأطفال: ماذا نحتاج للخروج في جولة؟ أيّة موادّ نحضّر؟ ما هي قواعد الأمان التي نتّفق عليها؟ قد نتدرّب على أنشطةٍ تأمّليّة للتمعّن في الطبيعة والاسترخاء معها. ثمّ نوثّق رحلتنا في صوَرٍ وموادّ نجمعها، نضيفها إلى ركن العلوم أو الفنون.
الطّيور: نحضّر ركنًا لاستدعاء الطّيور في ساحة بستاننا. نصوّرها، ونتعرّف على أسمائها وصِفاتها ونقارن بينها. نستكشف معلوماتٍ عنها في الموسوعات، وقد نعدّ معًا موسوعة طيور بلدتنا ونضيفها إلى مكتبة البستان.
نتحادث حول…
الحبكة: نراقب تفاصيل الرّسومات، ونشجّع طفلنا على وصفها. نتتبّع مسار الأحداث، ونربط بينها. نلاحظ تغيّر مشهد البحر، والطفلة والطيور، ونصف مشاعر الطفلة في كلّ مرّة.
خبراتنا الذاتيّة: هل اختبرنا شعورًا مشابهًا؟ كيف ومتى؟ نستذكر رحلاتنا ومغامراتنا ولحظاتنا وتجاربنا المختلفة.
البحار والطبيعة: بماذا يذكّرنا البحر؟ أيّة بحار زرنا؟ أية أماكن طبيعيّة أخرى نعرف؟ نقارن بينها: بماذا تتشابه أو تختلف؟
نثري لغتنا
نثري لغتنا
الوصف والمقارنة: نصِف ملامح الطفلة، وما تعبّر عنه من مشاعر. نقارن بينها في كلّ مشهد.
الطيور: ننتبه للطيور في الرسومات. نفكّر في علاقتها مع الطفلة. نتعرّف على صفاتها ومزاياها.
الأسماء: نقترح اسمًا للطفلة، ونفكّر في اسمنا، من أطلقه علينا؟ نتذكّر حكايات أسمائنا، ومعانيها.
الأفعال: نراقب حركات الطفلة، ونسمّيها. نؤدّي حركاتٍ مشابهة.
نستكشف
نستكشف
البحار: نزور بحرًا قريبًا، نتأمّل الغروب أو الشّروق فيه. نراقب الموج، نستمتع برمل الشاطئ. نبحث عن معلومات علميّة: كيف يتكوّن الموج؟ أيّة أحياء تعيش في البحر وبماذا تتميّز؟
الطبيعة: نختار مكانًا طبيعيًّا لنزهةٍ مشتركة. نزوره، نتمعّن، في تفاصيله، نصغي إلى الأصوات، ونتعرّف إلى الكائنات.
نتحاور
- البدايات الجديدة: نتحدّث مع أطفالنا عن المشاعر التي راودتهم عندما مرّوا بتجارب جديدة، مثل: يومهم الأوّل في المدرسة أو في دورة ، أو عيد ميلاد صديق جديد. نبحث معًا عن الطرق التي ساعدتهم على التأقلم.
- الخبرات المتنوّعة: صوّرت لنا الكرتونة طقوسًا وخبرات عائليّة، كترتيب ملابس الشتاء وتخزينها، واللعب في الساحة والاستمتاع بالبوظة، وتحضير مناقيش الزعتر، اللعب بالكرتونة. نتساءل مع طفلنا: أيّ طقوسٍ تشبه طقوسًا في بيتنا، وأيّها تختلف؟ نصِفُها.
نلعب
- هيا نتخيّل ونحزر! نجلس في مجموعة، وعلى كلّ فردٍ أن يقوم بدَوْره بالتمثيل الصامت لغرضٍ ما (مثل: كأس؛ قطّة؛ أسد؛ مطرقة)، وعلى الآخرين أن يحزروا ما هو هذا الغرض، وهكذا دوالَيْك (يمكن تحديد الوقت)
- سِحر الخيال: نحضّر أغراضًا متنوعّة (مثل: قبّعة، طنجرة، وِشاحًا…) ونبحث عن استعمالات متنوّعة للغرض، أو نتخيّله أغراضًا أخرى.
نُبدع
إعادة التدوير: يضيء الكتاب على موضوع إعادة التدوير. يمكننا نحن أيضًا أن نعدّ حقيبة من بنطال قديم مثلًا، أو أصيصًا للورود من علب المخلّلات، وما شابه.
نُثري لغتنا
نختار غرضًا بطلًا آخر للقصّة؛ كالحقيبة، أو الملابس، ونبدع في تأليف قصّة عنها ومن وجهة نظرها.
نتحاوَر حول:
الخبرات الذاتيّة: مواقف من حياة الأطفال مع البدايات الجديدة، كالانتقال إلى سكن جديد، مدرسة، صفّ، نشاط أو رحلة وغيرها. بماذا شعرنا وما الذي ساعدنا في تلك المواقف؟
رحلة رشيد والكرتونة: نتتبّع مسار النصّ والأحداث. بماذا شعر رشيد؟ كيف تعامل مع الكرتونة؟ ما هي الأدوار التي استطاع أن يقوم بها؟ بماذا شعرت الكرتونة؟
الطقوس والأجواء البيتيّة: نتابع المواقف والطقوس المذكورة في النصّ ونتحدّث حول مواقف من حياتنا في البيوت. أيّة أنشطة بيتيّة نحبّ ولماذا؟
الخيال: استثمر رشيد خياله الإبداعيّ وأنتج استعمالاتٍ متجدّدةً للكرتونة. نتحدّث عن مواقف استثمرنا فيها خيالنا. ماذا طوّرنا وكيف؟
إعادة التّدوير، كيف يمكن أن تساهم في المحافظة على البيئة؟ نتحدّث عن بيئتنا المحيطة والأفعال التي يمكننا بها المساهمة في جعل بيئتنا أفضل.
نُثري لغتنا
نُثري لغتنا:
فهم النصّ: نتعرّف على مفردات النصّ ونوضح معانيها وسياقات استعمالها.
الوعي الصّرفيّ: نلاحظ الضّمائر واستخدامها في النصّ ونستبدلها بالاسم الذي تدلّ عليه
(أين ستضعني/ لا تقلقوا/ سأصل عندكم).
العلاقات السببيّة: لماذا شعرت الكرتونة بالحرّ/ بالبرد/ بالاختناق؟ نربط بين السبب
والنتيجة لتطوير التفكير المنطقيّ والاستدلاليّ. نستذكر مواقف وسياقات مشابهةً.
الكتابة: نعدّ رسالةً إلى الجهات المختصّة أو لافتةً تدعو للمحافظة على البيئة. نقترح
وننتج النصّ الملائم.
أغراض تتحدّث: نختار غرضًا ونتحدّث من منظوره ونصِف خبراته المتخيَّلة، ماذا
يشاهد؟ يشعر؟ يفكّر؟ يختبر؟ (أنا السيّارة التي تأخذ العائلة في رحلة/ أنا الطبق الذي
يأكل فيه الطفل/ أنا المقلمة التي في حقيبة الطفل إلخ).
من زاويةٍ أخرى: قرأنا القصّة من وجهة نظر الكرتونة، فماذا لو تحدّث إلينا رشيد؟
نسرد الأحداث من منظور رشيد ونقارن بينها وبين حكاية الكرتونة. يساهم هذا النشاط
في تنمية التفكير النقديّ وإدراك الأبعاد لدى الطفل، إضافةً لتطوير القدرة على التعبير
اللغويّ.
الابتكار: نجيب على تساؤل الكرتونة الأخير ونتخيّل خبرةً جديدةً لها. ماذا سيحدث؟ إلى
أين سيأخذها رشيد؟ نتخيّل أحداثًا جديدةً ونطوّر قدرتنا على التعبير.
نستكشف
نستكشف:
الوَعي البيئيّ: نتعرّف على أنواع الموادّ المختلفة، وأثر كلٍّ منها على البيئة. نعدّ قوائم
من المعلومات ونحدّد ما يجدر إعادة تدويره، ونستكشف طرقًا مختلفةً لذلك.
الفنون: نتعرّف على فنون ملائمة كورشات تجسيد التماثيل من النفايات الحديديّة/
معارض إبداعيّة من زجاجاتٍ أو أدواتٍ قديمة، وغيرها. قد نجمع صوَرًا ومقاطع فيديو،
ونتابعها، أو نرتّب لقاءً مع فنّانٍ ما.
نبدع ونبادر:
نبدع ونبادر:
ورشات وإبداعات: نجمع أغراضًا مستعمَلةً، ونبدع في ورشةٍ لإعادة التدوير. قد نجهّز ركنًا في
ساحتنا من دواليب السيّارات، أو مساحةً للزرع من خرداوات. قد نستضيف فنّانًا أو نوجّه دعوةً
للأهل لمشاركتنا في مشروعٍ بيئيّ نتّفق عليه، ويزيّن مدرستنا أو حارتنا.
نلعب ونستمتع
نلعب ونستمتع:
مَن أنا؟ نختار غرضًا دون البوح باسمه. نصِفه ونتحدّث بلسانه عن استعمالاته، وخبراته ليحزر
الآخرون ما هو الغرض المقصود.
نتحاور
- الخبرات: نتتبّع رحلة الديناصور وصديقه جوجو، ونتحاور مع الأطفال عن الأماكن التي زارها، سلوكه، مشاعره والمخاطر التي تعرّض لها. هذه فرصة لأن نرافقهم في رحلتهم ونتعلّم من تجربتهم.
- الرغبات: نتحادث حول الأماكن التي قد يرغب الديناصور بزيارتها، وعن أمور قد يرغب بفعلها. نشجّع طفلنا على اقتراح أماكن أخرى من تجربته، ونسأله عن الأماكن التي يرغب بزيارتها، وعن الأمور التي يرغب بالقيام بها.
- تمكين الطفل وحسّه بالمقدرة وتعزيز استقلاليّته: نتحادث في الأمور التي يستطيع طفلنا أن يفعلها وحده، والأمور التي يحتاج إلى مساندتنا فيها، وما يرافق ذلك من مشاعر. نحدّد مع طفلنا مهامًّا أو مهارة يرغب بتعلّمها، مثل: انتعال الحذاء، أو ترتيب السّرير، ونسانده في تحقيقها.
نستمتع ونلعب معًا
أين اختبأت الأغراض؟: نلعب معًا لعبة “حامي بارد”: نخبّئ الأغراض وندعه يبحث عنها، ونوجّهه بكلمة “حامي” عند الاقتراب منها، وبارد عند الابتعاد عنها.
نُثري لغتنا
نُغني لغة طفلنا ونشجّعه على وصف ما فعله الديناصور في زيارته للأماكن المختلفة. نستعمل أفعالًا وأسماءَ دقيقة، ونضيف صفات جديدة، كأن نقول: ديناصور ضخم، مبانٍ عالية…
نُبدع
نحضّر سلّم النموّ: نختار حائطًا في البيت، ونتابع تسجيل طول الطّفل عليه. يمكننا أن نختار صورًا لطفلنا في مراحل عمريّة مختلفة، نلصقها في ألبوم طويل كمسطرة، نحضّره من الكرتون المقوّى ونزيّنه. نتحادث حول قدرات طفلنا في كلّ مرحلة، بدءًا من الولادة حتّى هذا اليوم، وحول أمور يرغب بأن يطوّرها.
نتحاوَر حول
نتحاوَر حول:
الحبكة: نوضّح مسار الأحداث مع الأطفال، ونتتبّع الأحداث بين غياب دينو وأفكار
جوجو المتخيّلة حول ذلك.
ألعابنا: نتحدّث عن ألعابنا الشخصيّة، هل لديك لعبةٌ مفضّلة؟ ما هي ولماذا؟ ماذا تحبّ أن
تلعب معها؟
الخروج دون إذن: نتحدّث عن خبراتنا وأهميّة وجود البالغ في بعض الأماكن والمواقف
لتجنّب الأخطار. نوضح القواعد الآمنة لعبور الشوارع والتنقّل بأمان. كما نستذكر
الأفعال التي نستطيع القيام بها وحدنا بشكلٍ مستقلّ، لتعزيز الإحساس بالمقدرة.
التفضيلات: يستعرض جوجو الأطعمة المفضّلة للديناصور. ترى ماذا يفضّل أطفالنا من
أطعمة/ أماكن تنزّه/ أنشطة وغيرها؟
المشاعر: بماذا شعر جوجو عندما افتقد دينو؟ هل حدث واختبرت هذا الشعور؟ كيف
تعاملت معه وماذا حدث؟
الخيال: يتخيّل جوجو أحداثًا ومواقف في خروج الديناصور. ماذا يقترح أطفالنا وأيّة
أحداث يمكن أن تحدث؟ ماذا لو مشت حقيبتنا/ لو زارتنا الغيمة/ لو تحدّث إلينا عصفور؟
نستمع إلى اقتراحات الأطفال ونتخيّل المشاهد الممكنة.
السّلوك في الأماكن العامّة: كيف نسلك في السّينما/ المجمّع التجاريّ؟ نقترح أماكن
أخرى ونتحدّث عمّا يخصّها من سلوكات.
نُثري لغتنا
نُثري لغتنا:
أسماء الدّلع والتحبّب: دينو هو اسم تحبّب للديناصور، فماذا يمكن أن يكون اسم جوجو؟
نتعرّف على أسماء الدّلع للأطفال. هي فرصةٌ لتعزيز التعبير الشخصيّ، وتطوير
مهارات الوعي الصرفيّ؟ قد نقترح أسماء تحبّب جديدة، ونعدّ قائمةً بأسمائنا المرغوبة.
أفعال وحركات: نتعرّف على الأفعال الحركيّة في النصّ (يتسلّق/ يتزحلق/ يصعد). نمثّلها
ونقترح أفعالًا أخرى تدلّ على حركة. قد نستذكر مواقف وخبراتٍ نمارس فيها هذه
الأفعال، ونلعب لعبةً ينفّذها فيها الأطفال في أماكن متخيلة (مثلًا: نتسلق سلالم أو أدراجًا/
نتدحرج على العشب الأخضر).
نبدع
نبدع:
قصّة جديدة: نكمل القصّة ونتخيّل ما يمكن أن يحدث للتنّينية لولو إذا خرجت إلى
الشارع. نقترح أماكن جديدةً تتجوّل فيها ونسرد الأحداث. قد نكتبها أو نرسمها معًا
ونضيف كتيّبًا إلى مكتبتنا. ماذا نرسم؟ وأيّ عنوانٍ نقترح؟
مخابئ: نقترح ألعابًا لتخبئة غرض أو طفل والبحث عنه، مثل "حامي- بارد" أو
الغمّيضة. قد نتّفق على إشاراتٍ أخرى ونبحث عن الكنز.
نُبادر ونتعلّم بمتعة
نُبادر ونتعلّم بمتعة:
سينما في الرّوضة: نعدّ روضتنا لتكون قاعة سينما. نتّفق على تنظيم البيئة، ونقترح
أفكارًا لملاءمتها. كيف نعتّم الأضواء؟ نحضّر تذاكر للدّخول، نصوّت لنختار فيلمًا
(قد يكون عن الدّيناصورات)، ونشاهده معًا وفقًا للقواعد التي اتّفقنا عليها.
يومٌ لألعابنا: نتّفق على يومٍ يُحضر فيه كلّ طفلٍ لعبته المفضّلة، ويعرّفها على
الأصدقاء ومساحات الرّوضة. قد نخصّص لقاءات المجموعات للتعرّف عليها، لنتيح
فرصةً للأطفال للتعبير. ربّما نحضّر لها مساحةً، ونتخيّل ما يحدث بينها أيضًا.
مساحات جديدة: قد نجهّز مطعمًا في الرّوضة، أو دكّانًا لبيع البوظة، ونطوّر مساحة
اللعب التمثيليّ. نستمع إلى اقتراحات الأطفال. نتّفق على المساحة الملائمة. ما الموادّ
التي نحتاجها؟ نحضّر لائحة أسعارٍ/ بطاقةً للبائع/ إعلاناتٍ للزبائن، ونوفّر فرصةً
لتعزيز المسؤوليّة والاستقلاليّة لأطفالنا.
نستكشف
نستكشف:
الدّيناصورات: يحبّ الأطفال عالمَ الدّيناصورات، فماذا لو بحثنا عن معلوماتٍ عنه، وتعرّفنا
إلى مزايا كلّ منها؟ قد نحضّر معرضًا للصّور أيضًا، أو نجمع صوَرًا ونضيفها إلى ركن
الإنتا
نتحادث
• حول الشعور بالبلبلة: نتحاور مع طفلنا حول المشاعر المختلطة للغولة. نسأله: لماذا، حسب رأيك، استيقظت غولة الألوان مشوّشة ومنفعلة؟ هل شعرتَ بمثل هذا الشعور في السابق؟
• حول الألوان والمشاعر: اختارت الغولة، كلّ مرّة، لونًا يجسّد مشاعرها. نتحاور مع طفلنا حول الألوان والمشاعر ونسأله: أيّ الألوان يمثّل لديه الشعور بالفرح؟ الغضب؟ الحزن؟ وماذا يفعل عندما يشعر بمثل هذا الشعور؟
• حول علاقة المشاعر بالسلوك: نتحاور مع طفلنا ونسأله: ماذا يتغيّر في جسدك عندما تشعر بالسعادة؟ بالغضب؟ بالتوتر؟ بالخوف؟ وماذا تفعل عندما تشعر بهذه المشاعر؟
• حول الشعور بالحبّ: نبحث في رسومات الصفحة الأخيرة عن تجسيد لمعنى الحب. نتحاور مع طفلنا ونسأله: كيف نشعر بأنّنا محبوبون؟
نُثري لغتنا
• الكتاب غنيّ بالمفردات الشعوريّة، التي قد لا نستعملها في سياق لغتنا المحكيّة، ممّا يحدّ عمومًا من قدرتنا على التعبير عن مشاعرنا وحتى الوعي لها. ندرج استعمال المفردات الشعوريّة في الحياة اليوميّة لنُثري قدرة طفلنا على الوعي والتعبير عن المشاعر.
نُبدع
• نحضّر برفقة الأطفال مرطبان المشاعر، وندرج طقسًا في برنامجنا اليوميّ، بحيث نختار كلّ يوم قصاصات ملوّنة تجسّد مشاعرنا خلال اليوم: شعرت بالسعادة عندما…شعرت بالغضب عندما… شعرت بالتوتر عندما…ثمّ نتحاور حول المشاعر.
• اعتمدت تقنيّة الكولاج في رسومات الكتاب. بواسطة استعمال قصاصات الورق والجرائد، نحضّر برفقة أطفالنا وجوهًا ولوحات متعدّدة؛ مُضحكة، سعيدة، حزينة، غاضبة.
نتواصل
• نختار مع طفلنا طقس “تأمّل” يوميّ يساعدنا على الاسترخاء، وعلى الوعي والإصغاء لمشاعرنا، وتخفيف التوتر عند الغضب أو الخوف.
نتحادث حول:
- التفضيلات الشخصيّة: تبرز الألوان بشكل مركزيّ في الكتاب وهي تحمل معاني شعوريّة-عاطفيّة عديدة. نتحدّث حول الألوان التي نحبّها والتّي نختارها لملابسنا وأغراضنا المختلفة. نسأل الأطفال أسئلة حولها نحو: ما هو لونك المفضّل؟ ولماذا؟أيّ الألوان كنتم تلبسون بصغركم، هل كنتم تختارونها بأنفسكم؟ هل لديكم اليوم تفضيلات خاصّة لألوان معيّنة؟ أيّها ولماذا؟
- الرّسومات: ندعو تلاميذنا الصّغار لتتبّع و”قراءة” الرّسومات ونسألهم: أيّ الألوان أعجبتك؟ لماذا؟ ماذا شعرت الغولة عندما ظهرت باللون الأصفر أو الأحمر وباقي الألوان؟ أيّ من بين رسومات في القصة شعرت بأنّها أخافتك، أسعدتك أو فاجأتك؟ هل كانت لديك مشاعر أخرى؟ ما هي؟أي لون كنت ستختاره ليصف مشاعرك؟ لماذا؟
- الوعي الذّاتي للحالات الشّعوريّة: يُعتبر الوعي الذّاتي للأحاسيس والمشاعر من الأسس الهامّة في التّطور العاطفيّ لدى الطّفل. نطلب من الأطفال مشاركتنا لمواقف شعروا خلالها باختلاط مشاعرهم، ثمّ نسألهم: لو تكرّر الموقف، ماذا كنتم ستفعلون؟
- القدرة على إدارة الذات: يعزّز الوعي العاطفيّ مهارة تنظيم وإدارة الذات بشكل أفضل. نسأل الأطفال: لماذا، بحسب رأيكم، استيقظت غولة الألوان “مخربطة” ومتضايقة؟ ماذا حدث معها؟ هل تفضّلون الفوضى أم التّرتيب؟ لماذا؟ ماذا شعرت الغولة بالفوضى والبلبلة؟ حسب رأيك، ماذا شعرت في النّهاية؟
نستكشف
- للألوان معاني متنوعة في الثّقافات المختلفة، حيث تعتمد شعوب كثيرة حول العالم على الألوان للتّعبير عن مشاعرها. يشير اللون الأسود، مثلًا، إلى الحزن والأبيض إلى الفرح (ثوب العروس). نبحث عبر المصادر المعلوماتيّة عن هذه المعاني بين شعوب العالم ونتعرّف معًا عليها. مثلًا في الشعر العربي نجد:
بيض صنائعنا، سود وقائعنا
خُضر مرابعنا حُمرٌ مواضينا.
نتواصل
- نحضّر بطاقات أو مناديل بألوان مختلفة، نجري حديثًا معمّقًا مع التّلاميذ الصّغار ونربط هذه الألوان بالمشاعر والأحاسيس وبالحالة النّفسية والانفعاليّة كما يرونها. في كلّ مرّة، يختار التّلاميذ لونًا أو مجموعة ألوان ليعبّروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم.
- يختار كلّ تلميذ بدوره لونًا، ويحاول التلاميذ تخمين شعورهم وطرح أسئلة ليعرفوا سبب هذا الشعور. نتشارك معًا بسلوكيّات مقترحة للتّعامل مع هذه المشاعر.
نثري لغتنا
- لغتنا العربيّة ثريّة جدًا بالمعاني العاطفيّة والشعوريّة. نُنمّي قاموسنا العاطفيّ ونكتب رسالة لصديق أو لأحد أفراد العائلة، نُعبّر فيها عن مشاعرنا حول تجربة معيّنة عشناها معه أو معها.
نكرّر قراءة القصّة ونحاول أن نصيغَ عنوانًا آخر أو نهاية أخرى لها.
نكرّر قراءة القصّة ونحاول أن نصيغَ عنوانًا آخر أو نهاية أخرى لها.
نتحادث حول
● التصرُّفات والسلوك: نتتبّع المواقف المختلفة في النصّ، ونتحدّث عن تصرُّفات كلّ من الأهل والطفل. نسأل أطفالنا: لماذا برأيكم تصرَّفَ الطفل على هذا النحو؟ ما المقصود بكلمة “هكذا”؟ ماذا كانت ردّة فعل الأهل في بداية القصّة؟ وكيف تَغيَّرَ سلوكهم في نهايتها؟ كيف تغيّرت تصرُّفات الطفل، ولماذا؟
● المشاعر: نتتبّع المواقف المختلفة في النصّ والرسومات، ونتحدّث عن مشاعر كلّ من الأهل والطفل. نسأل أطفالنا: بِـمَ شعَرَ الطفل في المواقف المختلفة؟ ما هو شعور الأهل؟ لماذا برأيهم شَعَرَ الأهل على هذا النحو؟ كيف تغيّرت مشاعر الطفل في نهاية القصّة، وكيف تغيّرت مشاعر الأهل، ولماذا؟
● مواقف من الحياة: كرّر الأهل السؤال “لماذا” في كثير من المواقف الحياتيّة، وتكرّرت إجابات نديم بكلمة “هكذا”. نتحاور مع طفلنا عن مواقف شبيهة حدثت بيننا. نسأله: كيف شعرت؟ نقترح معًا طُرُقًا بديلة للتوجُّه والتواصل
نستكشف
- ● اُستعملت في الكتاب كلمة “لماذا” كثيرًا. نبحث برفقة أطفالنا عن معلومات مختلفة ومتنوّعة عبْر الشبكة العنكبوتيّة، وذلك بكتابة أسئلة متنوّعة تبدأ بكلمة السؤال “لماذا”.
- ● استُعمِلت كلمة “لماذا” لتعبّر عن الاحتجاج. نصوغ برفقة أطفالنا أسئلة تهدف إلى إثارة حبّ الاستطلاع وزيادة المعرفة لديهم، نحو: لماذا لون السماء أزرق؟ لماذا نأكل؟ لماذا ننام؟ لماذا خُلِقت الألوان في الطبيعة؟ ونبحث في الشبكة العنكبوتيّة وفي الموسوعات عن إجابات لها.
نتحادث حول
- ترميزات فنيّة في النص المرسوم: ندعو التّلاميذ الصغار “لقراءة” الرّسومات من خلال تقليب صفحات الكتاب من البداية حتى النهاية. ونسألهم: ما الذي لفت انتباهكم في الرسومات؟ حسب رأيكم، لماذا لم يستعمل الرسّام ألوانًا مختلفة؟ نتحدّث عن الألوان التي استعملها الرسّام ونطلب منهم وصف مشاعر الأهل ومشاعر الطفل في كلّ صفحة.
- دلالات عاطفيّة: للون الأحمر حضور وظيفيّ بارز في كلّ صفحة من صفحات الكتاب. نحاول معًا استدلال معنى اللون الأحمر في كلّ رسمة من منظور عاطفيّ، فنسأل مثلًا: على ماذا تدلّ تعابير الطفل عندما يكون اللون الأحمر على شكل نقط؟ وعلى ماذا تدلّ عندما يكون على شكل بقع، وهكذا. حسب رأيكم، لماذا اختار الرسّام اللون الأحمر تحديدًا ليعبّر عن هذه المشاعر؟ هل كنت ستختار لونًا آخر؟ أيّ لون ولماذا؟
- حول مواقف الشّخصيّات ومشاعرها: نسأل التلاميذ ونتحاور معهم حول أسئلة مثل: هل سبق ومررت بمثل هذا الموقف مع أهلك؟ كيف شعرت حينها؟ ما رأيك بتصرّف الأهل؟ لو كنت مكان الأهل كيف كنت ستتصرّف؟ حسب رأيك، كيف كانت مشاعر الولد الصغير بعد أن غيّر أهله أسلوبهم معه؟ كيف شعر الأهل حسب رأيك؟ هل كنت ستختار نهاية أخرى للقصّة؟ ما هي؟
نستكشف
- هيّا نسأل! نفسح المجال أمام التّلاميذ الصغار ليسألوا أسئلة تثير فضولهم ويودون أن يعرفوا المزيد عنها. توثّق المعلّمة الأسئلة على بطاقات مع اسم التلميذ. نبحث عن الأجوبة من خلال الموسوعات، أو عبر الإنترنت.
يمكن للتّلاميذ أن يستعرضوا الأسئلة وأن يتشاركوا الأجوبة والمعارف الجديدة فيما بينهم، بشكل جماعيّ وممتع.
- منصّتنا الصفيّة: نطلق مشروعًا صفيًّا يوسّع مدارك التلاميذ الصغار. يقوم كلّ طفل بعرض سؤال يهمّه وبالبحث عن الإجابة عنه، وعرضها أمام الصفّ في مشروع يُدعى “منصتنا الصفيّة”.
نثري لغتنا
نلعب ونتعلّم: تكرّر استخدام أداة الاستفهام “لماذا” في الكتاب. نوسّع خبرات ومعرفة التلاميذ حول أدوات الاستفهام في لغتنا العربيّة، فنجرّب استعمالاتها ونتدرّب عليها. يمكننا أن نبتكر ألعابًا تعليميّة جماعيّة ومسليّة نحو: “دولاب أدوات الاستفهام”؛ نقصّ الكرتون على شكل دولاب ونقسّمه بالرسم بالتّساوي، ثمّ نكتب على كلّ قسم أداة من أدوات الاستفهام: لماذا، كيف، متى، أين، من، هل، كم. يلّف التّلاميذ كلّ في دوره الدولاب، ونطلب منهم أن يصيغوا سؤالًا يبدأ بأداة الاستفهام التي أشار إليها السهم عند توقّف الدولاب، ويحاول التّلاميذ معًا، الإجابة عليه.
نبدع
نلعب معًا “لعبة سؤال جواب”.
-
-
- نحضّر مجموعة بطاقات مكتوب عليها فقط كلمة “لماذا”، ومجموعة بطاقات ثانية مكتوب عليها فقط كلمة “لأنّ”.
-
نخلط البطاقات معًا. يقوم كلّ لاعب بدوره بسحب بطاقة، ويلعب حسب نوع البطاقة؛ إمّا أن يسأل سؤالًا للّاعب الثاني يبدأ ب “لماذا” والثاني يعطيه إجابة عليه، وإمّا أن يقول إجابة تبدأ ب”لأنّ” وعلى الثاني أن يتوقّع السؤال المناسب لهذه الإجابة.
نتحادث
- حول المشاعر: كانت تالا سعيدة في بداية القصّة، وفجأة شعرتْ بالضيق والقلق، وانعكست مشاعرها في الرسومات. نتتبّع الرسومات ونسأل طفلنا: بماذا تشعر تالا؟ لماذا تَغيّرَ شعورها؟ كيف انعكس شعورها في الرسومات؟ هل شعرْت ذات مرّة بالضيق؟ كيف كان شعورك؟ من ساندك؟
- حول موارد القوّة: شعرت تالا بالسعادة في بداية القصّة. نسأل طفلنا: ما هي الأمور التي سبّبت لتالا السعادة؟ وما هي الأمور التي تسعدك أنت؟ نشارك طفلنا خبرات حياتيّة شعرنا خلالها بالفشل واليأس. نتحدّث عن الأمور التي ساندتنا للتغلّب عليها، كالحديث إلى أشخاصٍ مهمّين لنا، والاستناد إلى مخزون الخبرات الممتعة في حياتنا.
- حول التعامل مع التحدّيات: نتحادث مع طفلنا عن موقف استخدم فيه طريقة المحاولات المتكرّرة. هل نجح في الوصول إلى نتيجة يريدها؟ ماذا كان شعوره وقتذاك؟ كيف نجح في التغلّب على تلك التحدّيات وتخطّي الصعوبات؟ مَن ساعده؟
نحاول وننجز
نحاول فننجز أكثر: نحدّد برفقة طفلنا عددًا من الأهداف أو التحدّيات التي يرغب في تحقيقها مع تحديد الفترة الزمنيّة. من ذلك -على سبيل المثال- أهدافٌ في المَهَمّات البيتيّة، نحو: ترتيب السرير أو الخزانة بسرعة قياسيّة؛ الالتزام برمي كيس النفايات؛ تنظيف المائدة -وأهداف أخرى يريدها.
نُثْري لغتنا
- نُثري قاموس أطفالنا العاطفيّ بكلمات تحفيزيّة نعتمدها في حِواراتنا معهم، نحو:
كوني قويّة؛ استمِرّ هكذا؛ أحسنت؛ رائعة؛ مبارَكةٌ جهودك؛ كُن كما تحبّ أن تكون؛ كوني كما شئتِ؛ أنتَ شُجاع؛ أنتِ عظيمة.
نستكشف
تعلّمت تالا درسًا من الدعسوقة الصغيرة. نتأمّل مع طفلنا أحد الكائنات الحيّة من حولنا. من أيّها نستطيع أن نتعلّم مهارات أو صفات معيّنة تُحفّزنا على الاستمرار في المحاولة؟
نُبدع
نحضّر برفقة أطفالنا بطاقات نكتب عليها كلمات تشجيعيّة، أو نسجّل فيها الأمور التي يستطيع أطفالنا أن يقوموا بها وتُشعرهم بالقدرة والسعادة، ونضعها في مرطبان. يقرأ الأطفال كلّ يوم بطاقة، لنذوّت عندهم الإحساس بالمقدرة ونعزّز حصانتهم النفسيّة.
نتحادث
- حول المشاعر: كانت تيلدا سعيدة في بداية القصّة، وفجأة شعرتْ بالضيق والقلق، وانعكست مشاعرها في الرسمات. نتتبّع الرسمات ونسألهم: بماذا تشعر تيلدا؟ لماذا تَغيّرَ شعورها؟ كيف انعكس شعورها في الرسمات؟ هل شعرْت ذات مرّة بالضيق؟ كيف كان شعورك؟ من ساندك؟ من كنتم تختارون لتقولوا له أعد المحاولة؟ أو، جرّب من جديد؟ لماذا؟
- نخمّن الأسباب: نفكّر معًا ماذا يمكن أن تكون المشكلة التي حدثت مع تيلدا وجعلتها تتغيّر على هذا النّحو؟
- حول موارد القوّة: شعرت تيلدا بالسعادة في بداية القصّة. نسأل التلاميذ الصغار: ما هي الأمور التي سبّبت لها السعادة؟ وما هي الأمور التي تسعدك؟ نشارك التلاميذ الصغار بخبرات حياتيّة شعرنا خلالها بالفشل واليأس. نتحدّث عن الأمور التي ساندتنا للتغلّب عليها، كالأشخاص من حولنا ومشاركتهم مشاعرنا، والاستناد إلى الخبرات الممتعة في حياتنا.
- حول الشّخصيات: نقرأ القصة ونتوقّف عند شخصيّة تيلدا والدّعسوقة. نتحدّث عن سماتها وعن التغيير الذي حصل لها. نطلب من التلاميذ مشاركتنا بمواقف صعبة سبق أن واجهتهم، ونسألهم كيف تعاملوا معها؟ كيف نجحوا في التغلّب على تلك التحدّيات وتخطّي تلك الصعوبات؟ من ساعدهم؟ وهل بذلوا مجهودًا كبيرًا في سبيل تحقيق شيء ما؟ نفكّر معًا كيف يمكن أن نحلّ مشكلة بالاعتماد على طريقة شاهدنا الآخرين يقومون بها.
نُثْري لغتنا
نُثري قاموسنا العاطفيّ بكلمات تحفيزيّة نعتمدها خلال حِواراتنا مع التلاميذ الصغار، نحو:
كوني قويّة /كُنْ قويًّا؛ استمِر/يّ هكذا؛ أحسنت؛ رائع/ة؛ مبارَكةٌ جهودك؛ كُن /كوني كما تحبّ/ين أن تكون/ي؛ كوني /كُنْ كما شئت /اخترت؛ أنت شُجاع/ة؛ أنت عظيم/ة.
نستكشف
التكيّف: كما الكائنات الحيّة، غيّرت الدعسوقة من سلوكها لتُحدث توازنًا في علاقتها مع محيطها. نبحث في الموسوعات وفي الشّبكة العنكبوتيّة عن أنواع التكيّف عند الكائنات في بيئتها الحياتيّة. نجمع المعلومات ونحضرها إلى الصفّ ونتشارك المعلومات والمعرفة مع زملائنا عمّا تعلّمناه منها.
نلعب ونستمتع
نذكر في ثلاث دقائق أكبر عدد من الجمل التي تبدأ بـ: “أنا أستطيع أن…” من الرائع أن تشارك المعلّمة هذه اللّعبة مع طلابّها!
نبدع
- نعزّز قدرتنا على حلّ المشكلات: صندوق التحديات والحلول؛ نتحادث مع التلاميذ الصّغار حول تحدّيات وجدوا صعوبة في حلّها في الصفّ، أو في البيت. نحضّر معًا بطاقات توثّق هذه التحديات بالرسم أو بالكلمات. نستعرض معًا كلّ واحدة من البطاقات، ونقترح لها حلًّا. نوثّق الحلّ في الجهة الأخرى من كلّ بطاقة، ثمّ ندخل جميع البطاقات في صندوق ونقترح له اسمًا.
- نحفّز أنفسنا على التقدّم والنّجاح: نحضِّر معًا سجلًا ونخصّصه لتدوين إنجازاتنا اليوميّة نحو: مساعدة صديق، سرعة في القراءة، وهكذا. نبيّن للتلاميذ الصّغار بأنّ التّحدي هو بين التّلميذ وذاته لرفع الدّافعية والإنجاز.
نمثّل
نختار من الصندوق بطاقة/موقفًا من بين المواقف أو التّحديات التي تحادثنا عنها وجمعناها. نتبادل الأدوار ونمثّل الموقف وطرق التّعامل التي اقترحناها. بعدها، نتحاور ونبيّن أنّ المحاولات المتكرّرة للنجاح ومشاركة الصعوبات مع من حولنا، ومع من يهتمون لأمرنا، سيساندنا حتمًا في تجاوز الصعوبات.
ساعة قصة
نتحاور
حول مشاعر الطفلة: نقرأ القصّة مع أطفالنا عدّة مرّات. نتتبّع الرسومات ونتناول الرسومات كلوحة تعبيريّة ونتحدّث عن مشاعر الطفلة، في المراحل المختلفة: عند الاستعداد للخروج للنزهة مع والدها؛ عندما كانت برفقة الدبدوب؛ عندما كانت برفقة حيوانات الغابة؛ عند حوض السمك برفقة والدها.
حول العلاقات مع العائلة: تحدّثت الطفلة عن خبرات وأوقات ممتعة قضتها مع والدها ودميتها في فصل الشتاء. نتحدّث مع أطفالنا حول المغامرات والأنشطة المشتركة التي قمنا بها، والتي يرغبون في القيام بها معنا ومع الإخوة.
المساندة والعلاقة التبادليّة: تحدّثت الطفلة أنّ الأب والدمية يقفان معها في الأوقات الصعبة ويشجّعانها، وأنّهما يحتاجانها. نتحاور مع أطفالنا عن معنى الأوقات الصعبة، ونسألهم: كيف احتاج الأب والدبدوب للطفلة؟ كيف نشجّع الآخر في الأوقات الصعبة؟ هل مررت بوقت صعب؟ كيف تعاملت معه؟ مَن ساندك وساعدك؟
الدمية والغرض المفضّل: نتحدّث مع طفلنا حول غرضه المفضّل. لعبت الطفلة مع الدبدوب فساعدها باكتشاف أمور جديدة وبناء صداقات جديدة فأبدعت بخيالها ولعبها. نسأل أطفالنا: ما هي الأمور التي يحبّونها في غرضهم /دميتهم؟ وكيف يلعبون بها؟
نُثْري لغتنا
نُغْني القاموس اللغويّ الشعوريّ: ذُكِرت في الكتاب مفردات عديدة تصف حاجات مختلفة، وأوضاعًا شعوريّة مختلفة. نتحدّث مع طفلنا: ما المقصود بها؟ ما معناها؟
مثلًا: ما المقصود بالمفردة “يحميني”؟ متى تكون الأمور صعبة، وما المقصود بذلك؟ تشجّعني؟ هل يحتاج إليّ؟ متى نشعر بالحاجة إلى التشجيع؟ من المهمّ ربط المفردات بالسياق والخبرة المعيشة -كأنْ يتحدّث الطفل عن نماذج من حياته، على سبيل المثال.
نُبدع
نصنع القبّعات: أوحت لنا الرسومات والنصّ أنّ الدبّ الكبير هو فعلًا دبّ بسبب القبّعة، وتفاجأنا عندما اكتشفنا غير ذلك. نُحْضر برفقة أطفالنا قبّعات مختلفة كقبّعة تشبه الأرنب، والديك، وحيوانات أخرى. ونطلق العِنان لخيالنا ونمثّل أدوارًا مختلفة مرتدِين تلك القبّعات.
نُحاكي ونكتشف ونتواصل مع الطبيعة
حمل الأب طفلته على كتفيه، وخرج في نزهة في المحيط القريب. نخرج مع أطفالنا في نزهة في المحيط القريب. نكتشف، ونلعب معهم، ونستمتع!
نتحاور
حول العنوان قبل القراءة: نقرأ العنوان، نصِف الرسومات على الغلاف، ونتنبّأ من تكون هذه الشخصيّة.
حول الرسومات: نقرأ القصّة ونتتبّع الرسومات بتفاصيلها الصغيرة. نَصِفها برفقة الأطفال.
حول مشاعر الطفلة: نقرأ القصّة مع الأطفال عدّة مرّات. نتتبّع الرسومات ونتناول الرسومات كلوحة تعبيريّة ونتحدّث عن مشاعر الطفلة ونسمّيها، في المراحل المختلفة: عند الاستعداد للخروج في نزهة مع والدها؛ عندما كانت برفقة الدبدوب؛ عندما كانت برفقة حيوانات الغابة؛ عند حوض السمك برفقة والدها.
حول العلاقات مع العائلة: تحدّثت الطفلة عن خبرات وأوقات ممتعة قضتها مع والدها ودميتها في فصل الشتاء. نتحدّث مع الأطفال حول المغامرات والأنشطة المشتركة التي يقومون بها في إطار العائلة، أو تلك التي يرغبون في القيام بها.
المسانَدة والعلاقة التبادليّة: تحدّثت الطفلة أنّ الأب والدمية يقفان معها في الأوقات الصعبة ويشجّعانها، وأنّهما يحتاجانها. نسأل الأطفال: ما معنى الأوقات الصعبة؟ كيف يشجّع أحدنا الآخر في الأوقات الصعبة؟ هل مَرَرْت في وقت صعب؟ كيف تعاملت معه؟ مَن ساندك وساعدك؟
الدمية والغرض المفضّل: نتحدّث مع الطفل حول غرضه المفضّل. لعبت الطفلة مع الدبدوب فساعدها في اكتشاف أمور جديدة وبناء صداقات جديدة، فأبدعت بخيالها ولعبها. نسأل الأطفال: ما هي الأمور التي يحبّونها في غرضهم /دميتهم؟ وكيف يلعبون بها؟ قد نخصّص يومًا لأغراضنا المفضَّلة، فيُحضر كلّ طفلٍ غرضًا يحبّه، ويعرّف رفاقَه عليه.
نُثري لغتنا
في القصّة ثروة لغويّة: عملاق؛ مدهشة؛ الاستمرار؛ كسب الأصدقاء. نبيّن معنى المفردات ونُغْني قاموس الطفل اللغويّ. نسأل الأطفال ما المقصود “كسب الأصدقاء” وكيف يمكننا أن نقوم بذلك؟
في القصّة أوصافٌ متضادّة (الكبير والصّغير) وهي فرصةٌ لتنمية مهارات الوصف والمقارنة. نبحث عن أشياء متضادّة من حولنا. يقترح أحدنا صفة لغرض ويفكّر الرّفاق في الصّفات المضادّة. قد نلعب على نمط لعبة برّ- بحر ونخصّص مساحات للقفز وفقًا للصّفات التي يقترحها الأطفال. (واسع- ضيّق/ طويل قصير/ كثير- قليل).
نُبدع ونمثّل
نصنع القبّعات والأقنعة: أوحت لنا الرسومات والنصّ أنّ الدبّ الكبير هو فعلًا دبّ بسبب القبّعة، وتفاجأنا عندما اكتشفنا غير ذلك. نُحْضِر برفقة أطفالنا قبّعاتٍ مختلفةً كقبّعة تشبه الأرنب والديك وحيوانات أخرى. ونُطْلق العِنان لخيالنا، ونمثّل أدوارًا مختلفة مرتدِين تلك القبعات.
نستكشف
اكتشفت الطفلة حشرات وحيوانات عديدة أثناء النزهة كالدعسوقة الغزال والثعلب. نبحث عن معلومات حول تلك الحيوانات برفقة الأطفال.
رسومات القصّة تشير إلى بيئة مثلجة في فصل الشتاء يختلف عن مُناخ بلادنا. نستكشف برفقة الأطفال مُناخ حيوانات وطيور بلادنا. يمكننا الاستعانة بمعرِّف الحشرات والطيور والحيوانات والـﭬيديوهات المتنوّعة. نتعرّف بين الأحياء المتواجدة في بيئتنا القريبة وبَين تلك التي في القصّة.
نتواصل مع الطبيعة
حمل الأب طفلته على كتفيه، وخرج في نزهة في الغابة. نخرج مع الأطفال إلى نزهة في المحيط القريب نكتشف جمال بلادنا، نلعب معهم ونستمتع.
كتاكيت -الفانوس في الحضانات
عن القصّة:
يخطو نوبي خطواتٍ واسعة نحو الاستقلاليّة، لكنّه ما زال بحاجةٍ إلى دعم والدَيه في القيام ببعض الأمور، ممّا يشعره أحيانًا بالإحباط. لكنّ أمّه، بوساطتها الجميلة، تعزّز ثقة نوبي بنفسه وحسّه بالمقدرة، وتذكّره بأنّها موجودة إلى جانبه.
تتيح القصّة حوارًا مع الأطفال عن خبرة استقبال أخٍ جديد أو أختٍ جديدة، وعمّا يشعرونه من غيرة، ولهفة، وغضب، وحزن وحبّ.
على فكرة:
• الاستقلاليّة مهارة اجتماعيّة مكتسَبة، تتطوّر من خلال إتاحة الفرص لاكتسابها، وملاءمة البيئة لاحتياجات وقدرات الطفل الشخصيّة، وإيمان البالغ بقدرة الطفل على القيام بأموره لوحده.
بعد القراءة
في الحضانة:
● نُشرك الأهل: نطلب من الأهل أن يصوّروا طفلهم وهو يقوم بعملٍ لوحده. نشجّع الأطفال على عرض صورهم والحديث عنها.
● نبادر: نزور مع الأطفال حضانة الأطفال الرضّع، ونلاحظ الاختلافات في القدرات بيننا وبينهم. نشجّع أطفالنا على تولّي مهامّ في الحضانة، مثل: ترتيب الألعاب، تحضير طاولة الطعام.
● نتحادث: مع الأطفال الّذينَ وُلِدَ لهم أخ جديد أو أخت جديدة: ما اسمه/ا؟ كيف يتصرّف؟ ماذا نحبّ أن نفعل معه/معها؟ ماذا يضايقنا؟ كيف نساعد في الاهتمام به/ها؟
● نثري لغتنا: نشجّع الطفل على استخدام كلمات من القصّة في حياته اليوميّة، مثل: شعرتُ؛ استطعتُ؛ احتجتُ؛ غضبتُ.
مع العائلة:
• نتحادث: نتصفّح معًا ألبوم صور طفلنا في سنته الأولى، ونتحادث عن الفرق بين قدراته حينها والآن.
· نلعب: نلعب معًا ألعابًا فيها تَحَدٍّ لقدرات طفلنا، مثل التسلّق، ونشجّعه على اكتشاف قدراته، ونثني على إنجازاته.
· نتعاون: نُشرك طفلنا في أداء مهامّ منزلية بسيطة، مثل ريّ النباتات، أو تعليق الغسيل.
• سلّم النموّ: نحوّل جزءًا من حائطٍ في البيت إلى “سلّم نموّ”، فنقيس طول طفلنا في فتراتٍ متباعدة ونشير إليه على الحائط. سيفخر طفلنا كثيرًا بما وصل إليه من طول!
نتحاور
حول تمكين الطفل وإحساسه بالمقدرة: نتحادث في الأمور التي يستطيع نوبي أن يفعلها، والأمور التي يجد صعوبة في فعلها، وما يرافق ذلك من مشاعر. نتحدّث مع الأطفال حول الأمور التي يستطيعون فعلها، والتي لم يكونوا قادرين على فعلها لكنّهم أصبحوا كذلك.
حول المشاعر المرافِقة لولادة أخ: تحمل ولادة طفل صغير في العائلة في جعبتها مشاعر مختلطة من الفرح والغَيْرة لدى الأخ الذي أصبح كبيرًا. نتحدّث عن مشاعر نوبي، ونسأل الأطفال عن مشاعرهم عند ولادة أخ لهم وأسبابها.
حول الاستقلاليّة والمسانَدة: نتتبّع نظرات وتواصُل الأمّ مع نوبي، التي تتيح له أن يكون مستقلًّا من جهة، وتسانده من جهة أخرى. نتحاور مع طفلنا حول الأمور التي تُشعره أنّه قد أصبح كبيرًا، ونسأله أيضًا عمّا إذا كانت هنالك أمور تُشعره بأنّه صغير، وكيف يرغب بأن نقوم بمساندته.
نُثْري لغتنا
قاموس ذهنيّ وشعوريّ: تحتوي القصّة على مفردات ذهنيّة، نحو: فكّرت؛ اعتقدت. وتحتوي على مفردات شعوريّة، نحو: شعرت؛ استطعت؛ احتجت؛ غضبت. من المهمّ إكساب الطفل هذه المفاهيم، واستعمالها في الحياة اليوميّة لوصف الحالات الشعوريّة، وإفساح المجال ليعبّر الطّفل عن مشاعره وأفكاره، وتيسير استخدامها أثناء الحِوار.
نبدع
نحضّر سلّم النموّ ونسمّيه “مسطرة الوقت”: نختار حائطًا أو مكانًا في البيت، ونتابع تسجيل طول الطّفل عليه. يمكن أن نختار صورًا لطفلنا في مراحل عمْريّة مختلفة نلصقها معًا في ألْبوم طويل كمسطرة نحضّره من الكرتون المقوّى ونزيّنه. نتحاور حول قدرات طفلنا في كلّ مرحلة عمْريّة، بدءًا من الولادة حتّى هذا اليوم.
نتحاور
العنوان قبل القراءة: نقرأ العنوان. نَصِفُ الرسومات على الغلاف، ونسأل الأطفال: ما المقصود بـِ “نوبي ولد كبير”؟ ما معنى أن تكون كبيرًا؟
حول الحبكة: نقرأ القصّة، ونسأل الأطفال عن الأحداث. نتمرّس في ترتيب أحداث القصّة من خلال صور نحضّرها مسبقًا.
حول المشاعر والأفكار والرغبات: نتتبّع الرسومات ونتحاور حول مشاعر، أفكار ورغبات نوبي. نسمّي المشاعر بدقّة، ونَقارن بين المشاعر والسلوكيّات فنتعرّف على علاقات السبب والنتيجة. نسأل الأطفال أيضًا عن مواقف شبيهة حدثت لهم وعن مشاعرهم تجاهها.
حول تمكين الطفل وإحساسه بالمقدرة: نتتبّع الفيل في الرسومات برفقة الأطفال، ونصف الأمور التي يستطيع الفيل أن يفعلها، والأمور التي يجد صعوبة في فعلها، وما يرافقها من مشاعر. نتحدّث مع الأطفال حول الأمور التي يستطيعون فعلها، والتي لم يكونوا قادرين على فعلها لكنّهم أصبحوا كذلك.
حول المشاعر المرافِقة لولادة أخ: تحمل ولادة طفل صغير في العائلة في جعبتها مشاعر مختلطة من الفرح والغَيْرة عند الأخ الذي أصبح كبيرًا. نتحدّث عن مشاعر الفيل، ونسأل الأطفال عن مشاعرهم عند ولادة أخ لهم، وعن أسبابها.
حول الاستقلاليّة والمسانَدة: نتحدّث مع الأطفال عن الأمور التي يستطيعون فعلها بمفردهم في الروضة، والتي تشعرهم بأنّهم “كبار”. نتحدّث أيضًا عن المهامّ التي يستطيعون القيام بها في العائلة بمفردهم، والتي تُشعِرهم أنّهم كبار، وعن المواقف التي يحبّون أن يكونوا فيها صغارًا.
نلعب معًا
من الممكن تحضير بطاقات من حياة الأطفال تصف مهارات من المهمّ تعزيزُها لدى الأطفال، ونتيح فرصة التعبير للأطفال عن مهاراتهم وقدراتهم. نستطيع تحضيرها كلعبة ذاكرة نلعبها مع الأطفال، أو كألبوم صورٍ متسلسلة
نُبدع ونتواصل
سلّم النموّ: نُحْضِر برفقة الأطفال والعائلة مسطرة النموّ بواسطة كرتون. نتواصل مع العائلة، ونضيف صورًا للطفل. تستطيع كلّ عائلة أن ترسم وتلوّن معًا المسطرة في البيت.
معرض: نعدّ كتابًا شخصيًاّ للطفل بمشاركة العائلة يتضمّن صورًا ورسومات للطفل في مراحله العُمْريّة المختلفة. نقيم معرضًا للنواتج، ويقوم كلّ طفل بالحديث عن كتابه.
نحاكي
نختار “الأشياء الصعبة” التي لم يستطع أن يقوم بها نوبي وحده، كتزرير القميص أو انتعال الجزمة. نفكّر في أمور أخرى صعبة، ونتدرّب على القيام بها برفقة الأطفال من خلال اللعب والتمثيل. على سبيل المثال: نُحْضر قميصًا مع أزرار؛ نحْضر لوحة على شكل نعل. يتدرّب الأطفال على ربط الحبل.
نتجوّل مع الأطفال في روضتنا، ونرى أيّ المساحات يمكن أن يديروها وحدهم. قد نخصّص مساحةً متغيّرة لاقتراحاتهم. نفكّر بالطرق التي من شأنها مساعدتهم على تنظيم المساحة بشكلٍ مستقلّ. نفكّر بالقواعد التي يمكنهم اتّباعها. هي فرصةٌ لتنمية مبادرات الأطفال وتعزيز قيمة التعاون بينهم.
نُثري لغتنا
في القصّة ثروة لغويّة: يستطيع؛ النقارش؛ شيء صعب؛ لوحدي؛ أضع؛ ينتعل؛ اضطرّ؛ فردتين معكوستين؛ سروال؛ انطلق؛ يشرق بدموعه. نفسّر الكلمات للأطفال، ونيسّر استعمالها في السياقات الحياتيّة المَعيشة لتصبح جزءًا من قاموسهم اللغويّ. قد نحضّر ركنًا خاصًّا للاحتفال بالمفردات الجديدة وإضافة ما يمكن أن يجسّد المعنى.
يرِد في القصّة الكثير من صيَغ المذكّر والمؤنّث. ماذا لو كان نوبي فيلةً لا فيلًا؟ نقرأ القصة مع الأطفال بصيغة المؤنث. قد نستبدل اسم سوسن باسم لولد أيضًا، ونتتبّع الفروق في تصريف الكلمات.
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع طفلنا حول غرضٍ يحتفظ به منذ سنوات. كيف حصل عليه؟ وما الخاصّ به؟ نتحادث أيضًا عن غرضٍ عزيزٍ فقده. ماذا يذكر عنه؟
- قد نرغب أيضًا بالحديث مع طفلنا عن غرض تناقلته أجيال العائلة، مثل ثوبٍ، أو قطعة حليّ، أو أداة في البيت. ماذا يعني لنا؟
- هذه فرصة للحديث مع الطّفل عن خبرة فقدان مرّ بها. كيف شعر/يشعر؟ وماذا يمكن أن يساعده حتّى يتغلّب على مشاعر الحزن والاشتياق؟
- قضت صوفِيا أوقاتًا جميلة مع صديقها دبدوب. نتحادث عن أصدقائنا، وعمّا نحبّ أن نفعل معهم.
- نشجّع طفلنا على أن يتخيّل ما مرّ به دبدوب في رحلته الطّويلة. قد يرغب بأن يروي لنا، فنساعده في الكتابة، ويقوم هو بالرّسم. يمهّد هذا النّشاط لفكرة كتابة المذكّرات في مرحلة لاحقة.
- نزور مع العائلة شاطئ البحر. قد نفتّش معًا عن أغراضٍ نجدها، فنتخيّل أصحابها، وقد يرغب طفلنا بكتابة رسالة يضعها في زجاجة ويرميها في البحر. مَن يعرف؟ ربّما وجدها أحدهم يومًا ما.
- طوّر هذه الاقتراحات فريق عمل في مكتبة الفانوس من وزارة التّربية والتّعليم وصندوق غرنسبون.
نتحادث
- عنوان الكتاب: ماذا رأى البحر؟ هل يستطيع البحر أن يرى؟
- مساعدة البحر لدبدوب ولصوفيا. لماذا ساعدهما؟ مَن يساعدنا حين نواجه مشكلة، وكيف؟
- اللّعبة المفضّلة لدى كلّ تلميذ، وقد يرغب بإحضارها إلى الصّف والحديث عنها.
- خبرة مشابهة مررنا بها. ماذا أضعنا؟ من ساعدنا في البحث عن الغرض المفقود؟
- “ماذا نفعل لو…” نستعرض مع التّلاميذ أحداثًا افتراضيّة مثل: أضعتَ لعبتك المفضّلة، أحدهم كسر أو خرّب لعبتك المفضّلة، تلقّيت هديّة لم تُعجبك، وجدت غرضًا أضاعه أحدٌ. نتحادث عن المشاعر الّتي قد يثيرها فينا هذا الحدث، وكيف نتصرّف.
نستكشف
- مسار رحلة دبدوب رجوعًا إلى صوفيا. نحدّد محطّاته ونرسمها على هيئة متاهة يتمتّع التّلاميذ بالسّير فيها.
- دلائل وإشارات في الرّسومات تدلّنا على أنّ الجدّة في نهاية القصّة هي نفسها صوفيا.
- العلاقة بين مضمون النّصّ وملامح الرّسمة: استخدام الألوان للدلالة على مشاعر الحزن والوحدة والفرح
- أنواع مجمّعات المياه المذكورة في القصّة (محيط، بحر، جدول…) ونوسّع معلوماتنا عنها.
- وسائل النّقل البرّية والبحريّة في القصّة. ماذا يمكننا أن نضيف إلى كلّ مجموعة؟
- نسترجع قصصًا نعرفها تتحدّث عن البحر.
نُثري لغتنا
- نتخيّل ما مرّ به دبدوب أثناء رحلته. نتساعد مع أهلنا في كتابة “مذكّرات دبدوب” وقد نرغب برسمها في كتابٍ صغير.
- نكتب رسالة شكرٍ للبحر لأنّه حافظ على دبدوب وأعاده لصوفيا.
- نقرأ عناوين الجريدة الّتي يحملها الأب في صفحة 5. نُحضر جريدة اليوم إلى الصّف، ونتأمّل معًا الصّفحة الأولى والأخيرة من الجريدة. على ماذا يدلّنا اختلاف حجم الخطّ في العناوين؟ ماذا تحوي الجريدة غير الأخبار؟
نتحرّك ونلعب
- نلعب لعبة “التّخباية” أو “حامي-بارد”. يخرج أحد التّلاميذ من الصّف ونخبّئ غرضًا، وعليه أن يحزر مكانه بمساعدة باقي التّلاميذ الّذين يقولون “حامي” إذا اقترب من الغرض، و”بارد” إذا ابتعد عنه.
- في الإنترنت تسجيلاتٌ متنوّعة لصوت الأمواج في بحرٍ هائج، وخرير الماء في جداول، وهدير الماء في الشّلال. يمكن أن نستخدم شالاتٍ نحرّكها بسرعة وببطء على وقع صوت الماء.
نشاط مع الأهل
- “هذا الأرنوب الضّائع يبدو حزينًا” يقول الكاتب. نتحادث مع طفلنا عن مظاهر حزن الأرنوب. كيف نبدو نحن حين نحزن؟
- نسترجع خبرةً فقدان غرضٍ نحبّه. كيف شعرنا؟ وماذا فعلنا؟
- نُعطي من ألعابنا: قد نرغب بأن نتفحّصّ مع طفلنا ألعابًا أو أغراضًا له يرغب بأن يعطيها لأطفالٍ آخرين.
- ماذا نفعل لو: نتحادث مع طفلنا حول ما يُمكن أن نفعله إذا وجدنا نقودًا في الشّارع، أو لعبة متروكة في المتنزّه.
- الجوارب الضّائعة: في كلّ بيتٍ سلّة أو جارور لفردات الجوارب! ننطلق مع طفلنا في مهمّة البحث في البيت عن الفردات الثّانية الضّائعة. سيتمتّع طفلنا في البحث، وفي ملاءمة أزواج الجوارب!
- إعلانٌ عن غرضٍ مفقود: نصمّم معًا إعلانًا عن غرضٍ مفقود في البيت، ونعلّقه في مكانٍ يراه أفراد العائلة.
- نقرأ الإعلانات في الكتاب عن الأشياء المفقودة. أيّها أحبّ طفلنا؟ من المُثري أن نقوم مع طفلنا بقراءة الإعلانات المعلّقة في الشّوارع، فانكشاف الطّفل على الرّموز الغرافيّة المطبوعة يسهّل عليه تعلّم كتابة وقراءة الحروف فيما بعد.
- طوّر هذه الاقتراحات فريق عمل في مكتبة الفانوس من وزارة التّربيّة والتّعليم ومن مؤسّسة غرنسبون
نتحادث
- قبل القراءة الأولى نتأمّل معًا رسمة الغلاف مفتوحًا على جهتيه: مَنْ وجد ماذا؟ ماذا يشعر دبدوب، ولماذا؟ أين وجد دبدوب الأرنب؟ ماذا يمكن أن يكون مكتوبًا في الورقة المعلّقة على الشّجرة؟
- فكّر دبدوب أنّ الأرنوب حزينٌ. لماذا فكّر ذلك؟ ما هي الأمور الّتي تجعلنا نحزن؟ كيف نعبّر عن حزننا؟
- نتوقّف عند صفحة 33، ونتخيّل ما يُمكن أن يحدث بعدها.
- علّق دبدوب إعلاناتٍ على الأشجار حتّى يجد صاحب أرنوب. ماذا كان يُمكن أيضًا أن يفعل؟
- هل أضعنا مرّة لعبة أو غرضًا نحبّه؟ ماذا فعلنا؟
- أعطى كرموش أرنوبه لدبدوب. لماذا؟ هل أعطينا مرّة أغراضًا نحبّها لآخرين؟
نشاط مع الأهل
- يمكن أن نتوقّف عند عنوان الكتاب، ونتحدث عن اسم اللّعبة بلهجتنا المحلّية (هناك تسميات عديدة لها في لهجاتنا المحلّيّة، مثل: غمّيضة، طُمّاية، طُمّاميّة، غُمّاية). كيف نلعبها؟ هل نعرف ألعابًا ثانية يختبئ فيها اللّاعبون؟
- تختبئ هدى بطريقتها الخاصّة والمميّزة. نتحادث عن الفرق بين الاختباء بطريقتها، وبين الاختباء بالطّريقة الّتي يعرفها طفلنا.
- نتأمّل الرّسومات معًا ونحاول أن نجد هدى في كلّ رسمة. كيف اختبأت؟
- تفرض هدى على أصدقائها أن يلعبوا الغمّيضة، وتفوز دائمًا. بماذا يمكن أن يشعر أصدقاؤها؟
- نتحادث مع طفلنا حول لعبةٍ يحبّ أن يلعبها مع أصدقائه في الرّوضة ويبرع بها. أيّ الألعاب يبرع بها أصدقاؤه؟
- وماذا يحدث في عائلتنا؟ من الممتع أن نقضي يوم عطلة بلعب ألعابٍ يحبّها أفراد العائلة.
- الكتاب مميّز من ناحية فنّية، فالرّسامة تستخدم عدّة تقنيات رسمٍ منها الطّبع. هذه مناسبة ليختبر طفلنا الطّبع بالدّهان باستخدام أدوات مختلفة. كلّ ما نحتاجه هو: * قطعة من الورق المقوّى * صحن بلاستيكيّ * دهان ملوّن كثيف (مثل دهان الأصابع) * أدوات للطّبع، مثل: مقطع من كوز ذرة أو حبّة بطاطا، إسفنجة مقصوصة بأشكال مختلفة، أدوات طبع جاهزة.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- قبل القراءة الأولى، افتحي الغلاف من جهتيه (الغلاف الأمامي والخلفي) ليرى الأطفال اللّوحة كلّها. تحادثي معهم حول ما يفعله الأطفال، وما تفعله الطّفلة. هل يمكن أن يخمّنوا ما عنوان الكتاب؟
- تختلف تسميات لعبة الغمّيضة في مجتمعنا، فهناك الطُّمّاية، والغُمّاية، والطُّماميّة. تحادثي مع الأطفال حول التّسمية الشّائعة في منطقتهم، وحول التّسميات الأخرى. راجعي معهم طريقة لعب الغمّيضة.
- تختبئ هدى في رسومات الكتاب بين الصّفحات 3-14. أثناء قراءة القصّة، ادعي الأطفال إلى البحث عنها في كلّ رسمة.
- تحادثي مع الأطفال حول ما يمكن أن يشعر به أصدقاء هدى في كلّ مرّة تفوز بها هدى بلعبة الغمّيضة. استرجعي معهم مواقف يوميّة تحدث في داخل الرّوضة، يفرض فيها أحد الأطفال ميوله وطرقه في اللّعب على مجموعة أصدقائه. بماذا يمكن أن يشعر الأصدقاء؟
- توقّفي عند نهاية النّصّ في صفحة 21 (فكّرت هدى، وفكّرت وفكّرت) شجّعي الأطفال على تخمين ما يمكن أن يحدث.
- شاركت هدى أصدقاءها اللّعب بألعابٍ أخرى دون أن تتنازل عن تفضيلها للعبة الغمّيضة، كما تظهر لنا الرّسومات في الصّفحتين 31،32. تحادثي مع الأطفال حول طرقٍ يمكن أن يلعبوا معًا بألعابٍ يحبّونها، مثل أن يتّفقوا على الأدوار في الألعاب.
- شجّعي الأطفال على أخذ دورٍ في إشراك أصدقائهم في الرّوضة بألعابٍ يحبّونها. استكشفي معهم ألعابًا جماعيّة يمكن لعبها في الصّفّ أو السّاحة، مثل الغمّيضة، والزّقيطة، وبحر بر وغيرها.
الفانوس اللّغويّ
في الكتاب:
النصّ غنيّ بصيَغ التصريف بين المذكّر والمؤنث والمفرد والجمع، ويوفّر أوصافًا للأطفال ومهاراتهم وتميّزهم، وفرَصا لحواراتٍ حول مواهبهم وألعابهم وسياقاتهم الحياتية.
في نظرة:
الرسومات غنيّة بالَمشاهد الحركية وتفاصيل الألعاب التي تُتيح حواراتٍ حول الألعاب المختلفة.
في المنهج:
الأطفال في جيل 3-4 سنوات: “يستعملون المبانيَ بشكلٍ منتظم: الأسماء والأفعال والصفات والظروف مع تصريفها من حيث الجنس والعدد/ يتعرّفون على الكلمات الوظيفيّة (حروف جرّ وظروف مكان)، ويستعملونها بشكلٍ صحيح”.
الأطفال في جيل 4-5 سنوات: “ يستعملون أفعالًا من نفس الجذر وفي الأوزان المختلفة/ يوسّعون الجمل بإضافاتٍ وصفيّة/ يستعملون ظروف المكان وكلمات الربط والعلاقات السببية بشكلٍ صحيح”.
- حفل الكلمات:
موهبة/ موهوبة/ مميّزة/ تحزر/ تتمالك نفسها/ ينضمّ/ كرات نطاطة/ زلاجات/ مجسمات تسلّق/ تسلّق/ غمّيضة/ في الأعلى/ في الأسفل/ ماهر/ ماهرة/ رائع/ بخفّة/ مضطرّون.
- نتعرّف إلى المفردات الجديدة، نوضّح معناها، ونذكر سياقاتٍ متعدّدةً لاستعمالها.
- نتعرّف إلى كلمة “موهبة/ موهوب/ موهوبة”. نتحدّث عن مواهبنا ومهاراتنا. هي فرصةٌ لتعزيز الوعي للذات. يتحدث كلّ طفلٍ عن هواياته ومهاراته، قد نتحدث عن برامج المواهب المتلفزة، وعن مواهب أشخاصٍ نعرفهم.
- نؤدّي الحركات التي تعبّر عنها المفردات مثل تزلج وتسلّق.
- نتعرّف إلى الأوصاف الحركية في الرسومات والنصّ، قد نضيف إلى ركن الرياضة صوَرًا للأطفال بحركاتهم المختلفة مع بطاقاتٍ تعبّر عنها.
Nous devons mentionner que Vardenafil est fabriqué par une société pharmaceutique réputée. Au fur et à mesure que les vaisseaux sanguins du pénis se dilatent ou par des médicaments Contenant Viagra et contrairement aux appels d’urgence, se concentrer sur ce que vous faites.
تعالوا نتحدّث:
- نتعرّف إلى المواهب المتعدّدة ونتحدّث عنها، ونتحدّث عن صفاتنا وتميّز كلٍّ منّا.
- نتحدّث عن الألعاب مع الأصدقاء: أية ألعاب نحبّ أن نلعب معًا؟ أية ألعاب نرغب في إضافتها لساحة روضتنا؟
- نتحدّث عن مشاعرنا حين يتميّز أصدقاؤنا عنا بمواهبهم، عن التعاون والدّعم وإيجاد الألعاب الملائمة للجميع، نتحدّث عن صعوبة فوزنا ببعض الألعاب، نتيح إمكانيةً للأطفال للتعبير عن المشاعر السلبية في الخسارة.
- نتحدّث عن التسميات المختلفة للعبة “الغميضة” في اللهجات المحكية، ونقارن بين التسمية المحكية والمعيارية. هي فرصةٌ لألعابٍ بسيطةٍ ومقارناتٍ بين الصيغتين.
- الغميضة لعبةٌ شعبية، ماذا لو تعرفنا إلى ألعابٍ شعبيةٍ أخرى واخترنا ما يلائم الأطفال منها في الروضة؟
- هدى لا تتمالك نفسها. لنفكّر بأمورٍ لا نتمالك أنفسنا فيها. ماذا يمكن أن نفعل معها؟
(في آخر الكتاب مقترَحاتٌ لحواراتٍ حيويّةٍ أخرى).
التداوليّة والكفايات اللغوية:
- التزلّج والتسلّق مفرداتٌ تصف أفعالًا حركيّةً. ماذا لو نُعدّ في الساحة ألعابًا للتزلّج والتسلق ونقارن بينها؟ أية موادّ تلائمنا للتحضير؟ ننحدر إلى الأسفل أو نصعد إلى أعلى. قد نعدّ ألبومًا من صوَر الأطفال في كلّ لعبةٍ أو قاموسًا للروضة من صور الألعاب.
- في الأعلى وفي الأسفل: فرصةٌ للتمكن من ظروف المكان. قد نحضّر صورًا لأطفال واغراضٍ ونصِف موقع كلّ منها. نلعب ألعابًا حركيةً ملائمةً ونتحرّك وفق التعليمات.
- نتعرّف إلى مفردات الاختباء (اختفى/ اختبأ/ لم يظهر/ تغطى). يستمتع الأطفال بتخبئة الأغراض. قد نلعب لعبة “حامي- بارد” ونوجّه بتعليماتنا الطفلَ الباحثَ عن الغرض المختبئ.
الوعي الصرفيّ:
- في النصّ صيَغٌ للضمائر والتصريف (هي/ هم)، تعالوا نلعب في مجموعاتٍ مع المفرد والجمع، مع المذكر والمؤنث. نخصّص مساحتين للحركة، ونصف أفعال الأطفال فيها (مريم تتسلق/ أحمد وخالد وجورج يتسلّقون/ منى ترقص/ هم يرقصون).
- ماذا لو كان البطل في القصة هادي بدل هدى؟ لنقرأ القصة بصيغةٍ ملائمة.
الوعي الصّوتيّ ومعرفة الحروف:
- نقطع الكلمات ونقارن بين عدد المقاطع مع اختلاف الفعل. نلعب لعبة الصندوق السحريّ، نخبّئ في الصندوق ما أعددنا من صور الأطفال في الألعاب، يسحب كلّ طفلٍ بطاقةً، نصِفها ونقطّع الكلمة، ننبّه الأطفال إلى الصوت الأول منها (تتزلّج/ يتزلّج، نعدّ المقاطع وننتبه إلى الصوت الأول. نتعرّف إلى حرفَي الياء والتاء في بداية الأفعال).
ماذا أيضًا:
- لتعزيز المجتمعيّة قد نستقبل أفرادًا موهوبين من الأهل والمجتمع المحليّ (فنانين/ خطاطين/ مصممين/ أدباء) ونتعرّف إلى مواهبهم. هي فرصةٌ لإقامة ورشاتٍ إبداعيّة وأنشطةٍ جماهيريّةٍ متنوعة وفق اهتمامات الأطفال.
عملًا ممتعًا
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.
نشاط مع الأهل
- نتوقّف عند رسمة الطّفل بعد أن انهار برجه. نتحادث حول شعور الطّفل في تلك اللّحظة. ما الّذي يدلّنا في الرّسومات على شعوره؟
- نسترجع ردود فعل الحيوانات. كيف حاول كلّ حيوان أن يساعد الطّفل؟ لو كنّا مكان الطّفل، هل نقبل مساعدة أحد الحيوانات؟ أيّ منها؟
- ساعد الأرنب الطّفل بإصغائه له، وهو يعبّر عن غضبه، وحزنه، وإحباطه، ورغبته في أن يبني من جديد. نتأمّل مع طفلنا رسومات الأرنب في كلّ حالة: كيف عبّر الأرنب بجسده عن إصغائه للطّفل؟ (التصق به، أمسك بيديه، نظر إليه، بحث عنه تحت الصّندوق…)
- نتحادث مع طفلنا حول موقفٍ شبيه مرّ به، شعر فيه بالحزن أو بالغضب. نستذكر معه ما الّذي ساعده على أن يهدأ وأن يبدأ من جديد. قد نلاحظ أنّ طفلنا يلجأ إلى دميته، خاصّة القماشيّة النّاعمة، ليبثّها مشاعره- وهذا طبيعيّ لدى أطفال الرّوضة- لكنّه لا يُغني عن حضورنا إلى جانب طفلنا، وتعاطفنا معه.
- نستذكر مع طفلنا خبرةً عاشها في الرّوضة أو في العائلة، حين ساند صديقًا أو قريبًا حزينًا. هذه مناسبة لنوضّح لطفلنا أهمّيّة أن نتعاطف وأن نساند غيرنا بالإمكانات المُتاحة لنا. قد نرغب بأن نشاركه خبرةً شخصيّة لنا في نطاق العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل.
- في بيتنا مكعّباتٌ خشبيّة، أو علب بلاستيكيّة فارغة؟ هيّا نتمتّع مع طفلنا ببناء مجسّم ما. إذا انهار، لا بأس، يمكن دائمًا بناء مجسّم جديد، وحتمًا سيكون رائعًا!
- ندعوكم لقراءة المقالة حول أهميّة الإصغاء، هنا: https://goo.gl/sX72xA ومقالة حول مهارات الإصغاء الفعّال، هنا: https://goo.gl/vPHjCC
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- في القراءة الأولى، توقّفي عند الغلاف، وتحادثي مع الأطفال حول الرّسمة. ماذا تقول لنا الرّسمة عن العلاقة بين سامر والأرنب؟ ربّما من الجدير التّوقف عند كلمة يصغي (يستمع باهتمام وبوجدانه) والفرق بينها وبين يسمع.
- استرجعي مع الأطفال ما قام به كلّ حيوان. تحادثي معهم حول الحيوان الّذي يمكن أن يختاروه ليساعدهم، لو كانوا مكان سامر.
- شجّعي الأطفال على تأمّل الرّسومات في الصّفحات 29-37. كيف ساعد الأرنب سامر، مع أنّه لم يتكلّم أو يقوم بعملٍ بارز؟
- يوفّر هذا الكتاب فرصةً للحديث مع الأطفال حول مشاعرهم في المواقف المختلفة. نقترح عليك الفعاليّة التّالية: 1. صوّري وجوه بعض الأطفال في روضتك وهم يعبّرون عن مشاعر مثل: الفرح، والغضب، والحزن، والتّعب، والضّجر، والألم. حوّلي الصّور إلى بطاقاتٍ واضحة يمكن أن يراها جميع الأطفال. ضعي البطاقات في علبة أو سلّة، وأخرجيها تِباعًا، وتحادثي مع الأطفال حول الشعور الظّاهر في تعابير الوجه، ثمّ أطلبي منهم أن يعبّروا عن هذا الشّعور بطريقتهم. 2. بعد ذلك علّقي البطاقات على الحائط أو اللّوح. أعدّي بطاقاتٍ تعرض صور أطفال في مواقف مثل: طفل ينفصل عن أهله في الصّباح، طفل وقع وجرح رجله، طفل انهار برج الليغو الّذي بناه…وغيرها. اعرضي البطاقات على الأطفال تِباعًا واطلبي منهم أن يشيروا إلى بطاقات المشاعر المعلّقة الّتي تناسب هذا الموقف. يسهّل هذا الأمر على الأطفال الصّغار أن يعبّروا عن المشاعر التي يختبرونها في مواقف مشابهة، لأنّ قدرتهم على التّعبير عمّا يشعرون ما زالت محدودة.
- تحادثي مع الأطفال عمّا يفعلون إذا أحسّوا بالحزن. قد يلجأ الأطفال الصّغار إلى شخصٍ يحبّونه، أو إلى حَضْن دمًى قماشيّة أو أغراض يرتبطون بها، أو إلى الاختباء في مكان في البيت (تحت السّرير مثلًا، أو في خزانة). من المهمّ أن يعرف الأطفال أنّ لكلّ إنسانٍ، صغيرًا كان أم كبيرًا، طقوسه الخاصّة في التّعامل مع المشاعر الصّعبة.
- نذكّرك بكتب أخرى أصدرناها في مكتبة الفانوس عن التّعامل مع مشاعر مختلفة: أين أذهب حين أغضب، عندما اشعر بالخوف، أرنوبيّة، يرقة يرقانة على شجرة التّوت.
- ندعوك لقراءة المقالة حول أهميّة الإصغاء، هنا: https://goo.gl/sX72xA ومقالة حول مهارات الإصغاء الفعّال، هنا: https://goo.gl/vPHjCC
الفانوس اللّغويّ
في الكتاب:
النصّ قصصيّ، غنيّ بالأوصاف وبالعلاقات السببية وظروف الزمان، والأفعال بصيَغ الماضي والحاضر.
في المنهج:
الأطفال في جيل 3-4 سنوات: “يتعرّفون على كلماتٍ وجملٍ من كتب ويكررون قراءتها باستمتاع”/ “يستعملون أسماء ذات محددة مستمدّة من عوالمهم”.
الأطفال في جيل 4-5 سنوات: ” يستعملون جملًا وصفيّةً من نوع السبب والنتيجة وجملًا زمنيّة”/ “يعرفون صفاتٍ محددةً ويستعملون صفاتٍ لوصف مشاعرهم”/”يتعرّفون على الكلمات الوظيفية ويستعملونها: قبل/ بعد: بسبب/ لأنّ”/ “يميّزون الانفعالات المختلفة في النصوص المسموعة”.
حفل الكلمات:
مميّز/ رائع/ فخور/ غادر/ جرى/ يا للخسارة/ يا للفظاعة/ يا للفوضى/ وحيد/ أصغى/ دب/ كنغر/ ضبع/ نعامة.
• نتعرّف إلى المفردات الجديدة، نوضح معناها، ونذكر سياقاتٍ متعدّدةً لاستعمالها. من المحبّذ أن تستعمل المربية المفردات في حديثها كي يذوّتها الأطفال (مثلًا: أنا فخورة بتعاونك مع زملائك/ رسمك مميّز).
• نتعرّف إلى صيغة المبالغة (يا للخسارة/ يا للفظاعة)، نبتكر صيَغًا شبيهة. مثلًا: كيف نقول إنّ الشيء جميلٌ جدًّا؟- يا للجمال/ مُفرح جدًّا- يا للفرح.
• نتعرّف إلى أسماء الحيوانات المذكورة/ صفاتها/ أين تعيش/ نصِف ما فعلته مع سامر.
تعالوا نتحدّث:
• تعرّفنا في كتاب “الدبّ يقول شكرًا” إلى مجموعةٍ من الحيوانات. هنا مجموعةٌ أخرى. قد نصنّف الحيوانات بطرقٍ جديدةٍ. بماذا يتشابه الفيل والكنغر؟ بماذا تختلف الأفعى عن الدجاجة. قد نبحث عن حيوانٍ شاذّ في مجموعةٍ وفق معيارٍ معيّن.
• في القصة السابقة لعب الحيوانات دور الأصدقاء، وهنا شاهدنا طريقةً أخرى. نتحدث عن الصداقة ونقارن بين ما فعله كلّ منهم.
• أصغى/ يصغي: نتذكّر الأنشطة التي نصغي فيها، (لقاء/ نشاط موسيقيّ). نتحدث عن أهمية الإصغاء. نصغي إلى زملائنا وأفكارهم. نتحدث عن شعورنا حين لا يصغي إلينا أحدهم.
• كان سامر وحيدًا. بماذا يشعر حين يكون وحيدًا/ حين يكون مع الأصدقاء؟ قد نذكر كلماتٍ أخرى تشبه وحيدًا (وحدة/ واحد/ واحدة) بماذا تتشابه؟
• (في نشرة الفانوس أفكارٌ لحواراتٍ شعورية حول الخبرات).
التدواليّة:
• تتكرّر في النصّ علاقاتٌ سببيّة (لذلك غادر): ننبّه الأطفال إلى العلاقة ونسأل أسئلةً عن السبب وعن النتيجة. نبني قوالب لغويّةً لعلاقات سببية بأكثر من صيغة: صارت الدنيا ليل لذلك (عشان هيك) نمت. استمتعت لأني قرأت القصة.
• نحضّر مع الأطفال لعبة ملاءمة بين بطاقاتٍ لأسباب وأخرى لنتائج (مثلًا: ليل مقابل طفل نائم، طفل يتلقى هدية مقابل طفل مبتسم وفرحان). يمكن تمثيل المشهد ووصف العلاقة السببية.
الوعي الصرفيّ:
• نقارن بين الأفعال الماضية والحاضرة: متى نقول أصغى/ يُصغي؟ غادر/ يُغادر.
ننتبه للأفعال مع المذكر والمؤنث: غادرَ/ غادرت.
قد نلعب على نمط “بر/ بحر” لعبة للانتقال بين الماضي والحاضر : نحدّد مساحةً للأفعال التي انتهت وأخرى للتي تحدث الآن، ونتحرّك وفق ما نسمع. قد نلعب على نفس النمط مع المذكر والمؤنث.
الوعي الصّوتيّ ومعرفة الحروف:
• نتعرف إلى أسماء الحيوانات، نقطّعها، ونعزل المقاطع (في يدي اليمنى “أر” وفي يدي اليسرى “نَب”، لو خبأت “أر” ماذا يبقى؟ نميّز الصّوت الأول من اسم كل حيوان.
• نتعرّف على مقاطع متشابهة في كلمات. (جا موجودة في دجاجة، أين نجدها أيضًا)؟
• تحضّر المربية كلماتٍ تتكرّر فيها مقاطع متشابهة وكلمات أخرى (مثلًا: سامر- ساهر- سالي تتكرّر فيها سا). نتّفق على مقطعٍ ما، تتحرّك مجموعةٌ من الأطفال في الحيّز المتاح، بينما المجموعة الثانية تقطّع الكلمات. عندما نسمع المقطع المتفق عليه نتوقّف أو نؤدّي حركةً خاصّة. (النشاط ملائمٌ أيضًا لتنمية الإصغاء). في النهاية نتذكر الكلمات التي سمعنا فيها المقطع.
الإقبال على الكتاب:
• قد نصنّف الكتب في مكتبة روضتنا وفق معايير مختلفة، مثلًا: كتب تتحدث عن حيوانات، كتب عن الصداقة. قد نقارن بين “الأرنب ظريف” و”الأرنب يصغي”، بماذا يتشابهان أو يختلفان؟ من أحببنا أكثر ولماذا؟
عملًا ممتعًا
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا الرّسومات في صفحة 5. كيف تستعدّ نوسة وعائلتها للنّوم؟ وكيف نستعدّ نحن في عائلتنا للنّوم؟ نتأمّل معًا الصفحة قبل الأخيرة في القصّة حين تستيقظ النّعجات صباحًا. كيف تبدأ كلّ نعجة نهارها؟ وكيف يبدأ النّهار في عائلتنا؟
- نتحادث مع طفلنا حول أهميّة النّوم. ماذا يحدث إذا لم يحصل جسمنا على قسطٍ وافٍ من الرّاحة؟
- أحيانًا يستصعب طفلنا، وأيضًا نحن الكبار، الخلود إلى النّوم. ماذا يمكن أن يساعدنا؟ (ربّما أن نقرأ كتابًا، أو أن نسمع قصّة، أو أن نتناول شرابًا دافئًا…)
- هل يمكننا أن نرى الضّفدع الظّريف المختبئ في كلّ رسمة؟
- لنوسة قبّعة ظريفة خاصّة ترتديها للنّوم. قد نرغب بأن نصمّم مع طفلنا قبّعة خاصّة له يرتديها حين يستعدّ للنّوم. نفتّش في خزائننا عن قبّعة قديمة ونزيّنها مع طفلنا في ورشة مبتكرة!
- تسكن النّعجات في حقل ضِفدعون، مسكن الضّفادع. نتخيّل ماذا سيكون اسم الحقل لو كانت تسكن به أرانب، أو ربّما قطط.
- أثناء محاولتها النّوم، “تخلع” نوسة ثوب الصّوف عنها، فتشعر بالبرد. أيّ الأشياء في بيتنا مصنوعة من الصّوف؟ هذه مناسبة للحديث مع طفلنا عن “رحلة” خيوط الصّوف من النّعجة إلى بيوتنا.
- تعدّ نوسة حتّى السّتة ملايين وعشرة! هيّا نجرّب أن نعدّ معًا: واحد…اثنان…ثلاثة…
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- لماذا لا تستطيع نوسة أن تنام؟ تحادثي مع الأطفال حول صعوبة نوسة في النّوم. هل يستصعبون هم النّوم أيضًا؟ لماذا؟
- استذكري مع الأطفال محاولات نوسة في مساعدة نفسها على النّوم. ماذا يقترحون عليها أيضًا؟
- لماذا مهمّ أن ننام؟ وماذا يحدث لجسمنا إذا لم ينل القسط الوافي من الرّاحة أثناء اللّيل؟
- تحادثي مع الأطفال حول طقوس الاستيقاظ صباحًا. ما الّذي يساعدهم على النّهوض من فراشهم؟ يستصعب العديد من الكبار والصّغار النّهوض من فراشهم في الصّباح لأسباب مختلفة، بعضها مرتبطٌ ببنية أجسامهم وبمزاجهم الشّخصيّ. هذه فرصة للحديث مع الأطفال حول هذا التّنوّع بين النّاس بعيدًا عن استخدام صفاتٍ سلبيّة مثل “كسلان”.
- نتتبّع مع الأطفال الضّفدع المرافق لنوسة في كلّ رسمة. ماذا يفعل؟ وكيف يحاول أن يساعد نوسة في الخلود إلى النّوم؟ هل هناك من يساعدنا نحن أيضًا؟
- “حفلة بيجاما في الرّوضة!” سيستمتع الأطفال بالقدوم إلى روضتهم بملابس النّوم في ساعات المساء وبرفقة أهلهم، وربّما بسماع قصّة “النّعجة نوسة” والقيام ببعض تمارين الاسترخاء مثل اليوغا، والخيال الموجّه.
- نزور مع الأطفال زاوية الاسترخاء في روضتنا. ماذا يمكن أن نغيّر فيها أو نضيف عليها حتّى تصبح مريحة أكثر؟
- هل نعرف فيلمًا أو مسلسلًا للأطفال بطله خروف أو نعجة؟ سيتبادر إلى ذهن الأطفال حتمًا “الخروف شون” الّذي ينقذ القطيع دائمًا من المآزق. هذه مناسبة لأن يجلس الأطفال باسترخاء، ويشاهدوا معًا إحدى حلقات هذا المسلسل المحبوب.
- يضيء لك الفانوس اللغوي (بإمكانك مشاهدة الرابط في صفحة الكتاب) العديد من الأنشطة اللّغوية الممتعة المرتبطة بهذا القصّة، فلا تنسَيْ أن تطّلعي عليها.
الفانوس اللّغويّ
في نظرة:
- تحتوي الرسومات على صورٍ لمشاهد متنوّعة للنعجة نوسة ورفاقها، تتيح حواراتٍ وصفية (مثلًا: مشهد الاستيقاظ صباحًا).
في الكتاب:
- في النصّ مفاهيم مترادفة ومتضادّة، وعلاقات شرطيّة، وأوصافٌ للأغراض/ النصّ بصيغة المؤنث، ويتيح التنبه لصيَغ الجمع/ كون النصّ عن النعجة، يوفّر فرصةً للتنبه إلى الحقل الدلاليّ ومجموعات الحيوانات.
في المنهج:
أطفال جيل 3-4:
“يوسّعون قاموسَهم اللغويَّ المتعلّقَ بمضامين قريبةٍ من عالمهم”، “يستعملون أسماءَ ذاتٍ محسوسةً وشائعةً”، “يستعملون أفعالًا عامّةً”، “يستعملون عددًا كبيرًا من الصفات الأساسيّة”، “يتعرّفون على عدّة كتبٍ حسب الغلاف”.
أطفال 4-5:
“يعرفون الكثيرَ من الأسماء من حقولٍ دلالية مختلفة”، “يستعملون صفاتٍ متنوّعةً ومحدّدةً ويسمّونها”، “يصنّفون مجموعةَ أغراضٍ إلى حقولٍ دلاليّة”، “يصنّفون الكتبَ إلى فئاتٍ حسب موضوعاتٍ”.
حفل الكلمات:
نعجة- حقل- ضفدَعون- ليل/ نهار/ صباح/ عتمة شديدة – نامت/ استيقظت/ صاحية- مرعب/ مخيف- صندوق/ سيارة صدئة/ جذع مجوف- فكّرت/ فكرة – دغدغة/ رجفة- تعرّجت تنهّدت: تذكرت/ نسيَت- أسماء العدد.
- نتعرّف إلى الكلمات الجديدة، نتحدث عنها: مثلًا: متى يصير الغرض صدئًا؟ أية مواد تصدأ؟ (فكرة لتجارب علمية)/ متى نحسّ بالرعب أو الخوف؟ نتعرف إلى الأفعال ونؤدّيها (تنهّدت- تعرّجت- استيقظت).
- لتعزيز اكتساب المفاهيم المترادفة والمتضادّة، نحضّر ألعابَ ملاءمة من صوَرٍ تناسبها، مثلًا: نلائم صورة لليل مقابل النهار/ النعجة نائمة أو صاحية/ الوعاء الفارغ مقابل المليء إلخ. نساعد الأطفال في وصف الصور والانتباه إلى العلاقة العكسية بينها. قد نضيف الكلمات مكتوبةً لينكشف الأطفال إليها.
- نختار عباراتٍ ونتحرّك وفق معناها ونمثّلها، بحيث تذكر المربّية الكلمة ويمثّلها الأطفال: ننام، نستيقظ/ نفكر/ ندخل الصندوق/ نخرج منه. (فرصة لألعابٍ حركية للمفاهيم).
- نتعرّف على كلمة “تعرّجَت” ونراقب صورتها. هي فرصةٌ للعبةٍ مع الخطوط. نسير وفق خطوطٍ متعرّجة أو مستقيمة. يمكن الاستعانة بالمكعبات أو أية أغراضٍ أخرى لرسم الخطّ/ المسار المطلوب.
هيا نتحدّث:
- نتحاور حول النوم وطقوسه والاستيقاظ وطقوسه لدى كلّ منا.
- نتحدّث حول حقل النعاج (الحظيرة)، من يسكن أيضًا في الحظيرة؟
- نتعرّف إلى مجموعة الحيوانات، ونسمّي حيواناتٍ أخرى نعرفها، أين تسكن؟ ما الفرق بينها؟
الكفايات اللغوية:
- يتكرّر استخدام “لكنّ” في النصّ. نختار قالبًا لغويًّا ونذكر أشياء نحبها لكننا لا نستطيع تحقيقها، مثلًا : “أحبّ سياقة السيارة لكني ما زلت صغيرًا”… ماذا يحب الأطفال أن يفعلوا لكنّ سببًا يمنعهم؟
- نتعرّف إلى مجموعة النعاج والخراف، إلى مجموعة الحيوانات وإمكانيات تصنيفها. قد نصنّف مجسّمات الحيوانات المتواجدة في أركان الرّوضة، ونبني لها مساكن في ركن البناء، ونخططه معًا ليلائمها.
الوعي الصّرفيّ:
- تسكن النعجة نوسة في حقل “ضفدَعون”. قد نبتكر صيَغًا تصغيرية أخرى لتطوير الوعي الصرفيّ: “كلب- كلبون” ربما أيضًا بوَزنٍ آخر، مثل “قط- قطقوط”. قد نتعرف إلى أسماء التحبب التي يُنادى بها الأطفال، وهي فرصة لتنمية الوعي الصرفيّ. قد نعدّ لوحةً بأسماء التحبب لأطفال الروضة (عبّودي- حمّودي- ميمي- سوسو- جابي وغيرهم).
- تعدّ النعجة نوسة رفيقاتها “واحدة، اثنتان”. تعالوا نساعد الخروف ليعدّ رفاقه : واحد، اثنان..” نعدّ أغراضًا في الروضة بالصيغة الملائمة. نتذكر ألا نطالب الأطفال بإتقانَ العد بالمذكر والمؤنث، إنما أن نكشفهم لذلك من خلال اللعب.
الوعي الصوتيّ:
- نقطّع الكلمات الواردة في النصّ ونعدّ مقاطعها بالمعياريّة. (ملائمة لأسماء الأعداد).
الإقبال على الكتاب:
- نصنّف الكتبَ ونُشرِك الأطفال في ترتيب ركن المكتبة، نبحث عن قصصٍ في الروضة تتحدث عن الحيوانات. أية مجموعاتٍ أخرى قد نجد في مكتبتنا؟ نفكّر بمعايير أخرى لتصنيف الكتب.
عملًا ممتعًا.
أنوار الأنوار- المرشدة القطرية للتربية اللغويّة في قسم التعليم قبل الابتدائيّ العربيّ والبدويّ.
نشاط مع الأهل
- نتصفّح مع طفلنا الرّسومات الأولى في الكتاب. ماذا يدلّنا في الرّسومات على خوف هادي؟
- نتحادث مع طفلنا حول أمور تثير عادةً خوفه. ماذا يشعر حين يخاف؟ وكيف يمكن أن يساعد نفسه في التّخفيف من خوفه؟ (مثل أن يلتجئ إلى شخص أو مكان يشعره بالأمان.)
- يشعر العديد من أطفال الصّفّ الأوّل في بداية السّنة بالخوف من المدرسة، فعليهم أن يعتادوا أمورًا كثيرة جديدة عليهم. من المهمّ أن نتحادث مع طفلنا حول ما يخيفه ويقلقه تحديدًا في المدرسة، وماذا يمكن أن يساعده. يمكن لطفلنا أن يرسم مظلّته الخاصّة، ونساعده في أن يكتب عليها ما يمنحه شعورًا بالأمان.
- نستذكر مع طفلنا موقفًا ساعد فيه صديقًا في ورطة، ونتحادث عن أهمّية نجدة الأصدقاء ومن نحبّهم. ربّما يرغب طفلنا في أن يرسم القصّة ونساعده في كتابتها.
- هناك العديد من الألعاب الجماعيّة الجميلة الّتي يمكن أن نلعبها مع أولادنا باستعمال مظلّة الهبوط- البراشوت، نجدها بكثرة في الإنترنت. يمكن شراء البراشوت من حوانيت الألعاب، أو خياطته من فضلات أقمشة أو ملابس بالية متوفّرة في البيت.
- تتميّز رسومات الكتاب بتصوير الأشياء من زوايا وأبعادٍ مختلفة لتنقل مشاعر هادي في لحظاتٍ معيّنة. من الممتع أن نجرّب مع طفلنا تصوير شيء معيّن من زوايا مختلفة، مثل تصوير السّيارة من داخلها، من مكانٍ مرتفع، ومن مكانٍ منخفض. ماذا تكشف لنا كلّ صورة؟
- تخيّل هادي أنّ الشّجرة عالية إلى درجة أنّها ارتفعت فوق الغيوم، فرأى كواكب ومخلوقاتٍ غريبة. لو أنّنا طرنا فوق الغيم، فماذا يمكن أن نرى، أو يُخيّل إلينا أن نرى؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- قبل القراءة الأولى، ادعي الأطفال إلى تصفّح الرّسومات وتخمين الأحداث. تتميّز رسومات الكتاب باللّعب بالأبعاد، ممّا يوحي للقارئ بمخاوف هادي وبخياله الخصب. شجّعي الأطفال على إيجاد الرّسومات التّي تعبّر عن رؤية هادي لأغراض أو أمور على نحوٍ مضخّم.
- بعد قراءة القصّة، تحادثي مع الأطفال حول ما يخيف هادي، وكيف يتغلّب على خوفه. هل هناك أمورٌ أخرى قد تخيف هادي غير الخوف من العلوّ؟ شجّعي الأطفال على التّفكير في طرقٍ تساعد هادي في التّغلّب على هذه المخاوف.
- أيّ أمور تخيفنا نحن في البيت وفي المدرسة؟ كيف يمكن أن نواجهها؟ بمن وبماذا يمكن أن نستعين؟ من المهمّ جدًّا إدارة هذا الحوار بحذر مع الأطفال على نحوٍ يعطي شرعيّة لمخاوفهم من جهة، ويساندهم في التّفكير بطرقٍ عمليّة لمواجهة خوفهم من جهة أخرى.
- يوفّر الكتاب فرصةً للعمل مع الأطفال حول المشاعر وطرقنا المختلفة في التّعبير عنها. نقترح عليك هذا النّشاط: اطلبي من كلّ طفل أن يقسم ورقة بحجم A4 إلى أربعة أقسام، بحيث يحمل كلّ قسم اسم شعورٍ ما، مثل: الفرح، الخوف، الحزن، الدّهشة. وفّري للأطفال مجموعة كبيرة من المجلّات المصوّرة والجرائد، واطلبي من كلّ طفل أن يقصّ ويلصق صورًا أو رسوماتٍ تعبّر عن كلٍّ من هذا المشاعر. وزّعي الأطفال بعدها في مجموعات صغيرة، واطلبي منهم أن يقارنوا بين أوراقهم: ما المشترك في التّعبير عن كلّ شعور، وما المختلف؟ يساعد هذا النّشاط الأطفال في رؤية وتقبّل الاختلافات بيننا كبشر في التّعبير عن مشاعرنا.
- حين ساعد راني فلفل ساعد نفسه. ممكن أن تشجّعي الأطفال على التّفكير في قصّة عن صديقين ساعدا بعضهما في التّغلب على مخاوف. بماذا يتّصف كل منهما؟ قد يرغب الأطفال في كتابة القصّة ورسمها بمساعدة الأهل.
- خلال جلوسه في بيت الشّجرة، يتخيّل هادي أنّه يطير في السّماء بين الكواكب. ماذا نرى لو أنّنا طرنا في السّماء أو الفضاء؟ سيتمتّع الأطفال بتجسيد خيالهم في رسمة أو أيّ عملٍ فنّي آخر.
- تتميّز رسومات الكتاب السّاحرة بعرض الأشياء من زوايا غير مألوفة لنا. من الممتع أن تقومي مع الأطفال بورشة تصوير بسيطة (باستعمال الهواتف الخليوية) في الصّف أو في ساحة المدرسة، بحيث يصوّرون ذات الغرض من زوايا وارتفاعات مختلفة. ماذا تقول لنا الصّور عن وجهات النّظر المختلفة لذات الموضوع؟
- من الممكن القيام بألعاب براشوت لإضفاء جوّ من المرح، كما يبيّن رابط فيديو تجدينه في صفحة الكتاب (https://goo.gl/xSeHUc).
- طوّر هذه الاقتراحات فريق عمل من وزارة التّربية والتّعليم، ومن مؤسّسة غرنسبون. قراءةً ونشاطًا ممتعَيْن!
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع طفلنا حول أمورٍ تسبّب له الخوف. نشجّعه على الحديث حول كلّ أمرٍ: ما الّذي يخيفه تحديدًا، وماذا يشعر في جسمه لحظتها؟
- يختلف النّاس في ردود فعلهم الجسمانيّة في مواقف الخوف، فبعضهم يصبح عصبيًّا، ويعرق ويشعر بالحرّ، وآخر تنشلّ حركته، وقد يشعر بالبرد. قد يساعد أن نشارك طفلنا بأمور تشعرنا نحن أيضًا بالخوف، وما نحسّه في تلك اللّحظة في أجسامنا.
- ماذا يمكن أن يخفّف من حدّة خوفنا في كلّ موقف؟ نفكّر سويًّا في طرقٍ عمليّة تناسب قدرات طفلنا، مثل طلب النّجدة، أو التّنفّس عميقًا، أو التّوجّه إلى شخصٍ يثق به.
- أحيانًا كثيرة، حين نجسّد مصدر خوفنا، نشعر بأنّنا نسيطر عليه فتخفّ حدّة وقعه علينا. يمكن أن نشجّع طفلنا على رسم ما يخيفه، أو على تشكيله بالمعجونة.
- مقابل أن يتحدّث الطّفل عمّا يخيفه ويرسمه، من المفيد أن نشجّعه على التّفكير بقائمة من الأمور/الأشخاص/ الأشياء الّتي تمنحه شعورًا بالطّمأنينة، ورسمها. إنّ رؤية هاتين القائمتين تسانده في شعوره بمقدرته الذّاتية على تخفيف مخاوفه.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- تحدّثي مع الأطفال حول ما يثير خوفهم في البيت، وفي الشّارع، وفي الرّوضة، وفي الأماكن العامّة. يمكن أن تحضّري “سلّم الخوف” من ثلاث درجات باستخدام لونٍ ما، بحيث تشير درجة اللّون الفاتح إلى أمر يخيف الطّفل قليلًا، ودرجة اللّون الأغمق إلى أمر يخيف الطّفل أكثر، والدّرجة الثّالثة الغامقة اللّون إلى أمر يخيف الطّفل كثيرًا. شجّعي الأطفال على الحديث عن مخاوفهم وتدريجها.
- قد ترغبين بمشاركة الأطفال بعض مخاوفك لكي تطمئنيهم بأنّ الخوف شعورٌ طبيعيّ يحسّ به الكبار والصّغار.
- بعض الأطفال يستصعبون الحديث عن مخاوفهم. يمكن أن تشجّعيهم على رسمها، ممّا يسهّل عليهم الحديث عنها في مجموعاتٍ صغيرة.
- شجّعي الأطفال على الحديث عمّا يشعرون بأجسامهم حين يخافون، موضّحة الاختلافات في مظاهر الخوف على النّاس.
- ماذا نفعل عندما نخاف؟ تحدّثي مع الأطفال في مجموعات صغيرة حول طرقهم في مواجهة مخاوفهم. من المهمّ جدًّا أن تُصغي إلى كلّ طفل، وألّا تقولي له ما عليه أن يفعل، وإنّما أن تشجّعيه على التّفكير بسلوكٍ يعطيه شعورًا بالأمان حين يخاف.
- الدّراما أداة ممتازة للمساعدة في التّعامل مع المشاعر الصّعبة، فهي تتيح للطّفل أن يفهم مشاعره على نحوٍ أعمق، وأن يفرّغها. يمكن أن تؤلّفي مع الأطفال مشهدًا تمثيليًّا بسيطًا عن طفل يخاف من أمرٍ ما، وكيف تعامل معه.
- يمكن أن تقرإي مع الأطفال قصّة ” افرضي” الّتي وزّعت في إطار مكتبة الفانوس قبل أربع سنوات، وهي تتناول موضوع الكوابيس الّتي تحلم بها الطّفلة، والطّريقة الجميلة الّتي ساندتها فيها أمّها.
- تمارين اليوغا والخيال الموجّه المناسبة للأطفال هي أداة ممتازة لمساعدة الأطفال القلقين في التّعامل مع قلقهم والتّخفيف منه. يمكنك أن تعدّي لقاءً مع الأهل وأطفالهم للتّدرّب على بعض هذه التّمارين.
الفانوس اللّغويّ
المربّية العزيزة! مع بداية العام الدّراسيّ، قد يُواجه الأطفالُ صُعوبةً في التّأقلُم مع البيئة الجديدة، إنَّ قراءة القصص للأطفال بشكلٍ يوميّ، ممتع وجذّاب، تُساهمُ في تأقلُمهم، لذا نذكّركِ بضرورة الحرص على أجواء المتعة واللعب، ودعم تأقلُم الأطفال عاطفيًّا واجتماعيًّا، وعدم الإثقال عليهم بجوّ تعليميّ مباشر.
في الكتاب:
- النصّ يتيح حواراتٍ عن المشاعر والانفعالات المختلفة، وعن انعكاسها على الملامح والتعابير الجسدية.
في المنهج:
أطفال 5-6 سنوات
- “يستعملون جملًا مركّبةً من نوع جمل العلاقة، ويستعملون جملًا وصفيّةً من نوع جمَل المقارنة والشّرط”.
- “يستجيبون للانفعالات المختلفة في النصّوص المسموعة، ويبادرون للحديث مع رفاقهم والبالغين عن تجاربهم وأفكارهم وبرامجهم”.
- “يُنتجون قصصًا من سلسلة صوَرٍ ويصفون أحداثًا مختلفةً مع استعمال صلة السّبب والنتيجة، التوسّعات الوصفيّة، والتعبير عن موقف”.
حفل الكلمات:
يخفق، يقفز، يهتزّ، يرتجف، النجدة، أشعر بالخوف/ أشعر بالأمان
أخاف/ يخيفونني/ تخيفني/ تُخيفك/ أخافَني/ مخيفة.
- نتعرّف على المفردات ومعانيها، مثلًا: ماذا تعني “النجدة”؟ متى نستعملها؟ مواقف مناسبة/ بمن نستنجد؟
- نتحدّث عن المشاعر المختلفة، وعن تأثيرها على ملامحنا. ماذا أفعل حين أشعر بشيءٍ ما؟ (مثلًا عندما أشعر بالفرح أبتسم/ أضحك)
- نختار حركاتٍ ملائمةً للتعبير عن شعورٍ ما ونضيفها إلى الكلمة المحتفى بها (مثلًا: أبتسم/ أضحك/ أقهقه- شعور الفرح، أبكي/ أكشّر/ شعور الحزن إلخ).
هيّا نتحدّث:
- نتحدّث عن الشّعور بالخوف والشّعور بالأمان: أمور تخيفني أو تمنحني الطمأنينة. موقف في البستان يشعرني بالأمان.
- نتحدّث عن طرق تعبيرنا عن المشاعر المختلفة، وعن تأثيرها على تعابير الوجه والجسد.
- نتحدّث عن تجارب شعرنا فيها بالخوف/ القلق/ الحزن/ الفرح. ونشارك زملاءنا بها.
- نتحدّث عن مشاعر مزعجة، وما يمكن أن نفعل للتخفيف منها. لمن نلجأ طلبًا للمساعدة؟
- نستذكر قصصًا من الرّوضة تحدّثت عن المشاعر، مثلًا: القط ظريف، ونقارن بين الشخصيات وتجاربها.
الكفايات اللغويّة:
- نصِف شكلَ الأرنب في الحالات المختلفة. نقلّد تعابيرَه الحركيّة: نقفز، نرتجف، نهتزّ، ماذا أيضًا؟ نستمع لاقتراحات الأطفال ونقلّدها.
- للتجسير بين المحكية والمعيارية نختار قالبًا لغويًّا ونعبّر عن تجاربنا وفقَه. مثلًا:
“عندما أشعر بالخوف أفعل كذا/ عندما أشعر بالفرح/ عندما أشعر بالحزن. نعبّر بأجسادنا عن المفردات.
- لعبة “صندوق المشاعر”: نحضّر صندوقًا فيه بطاقات صوَرٍ لتعابير وجوهٍ متنوّعة، يسحب الطفل بطاقةً ويقلّد تعابيرَها، ويحاول بقيّة الأطفال تسمية الشعور الذي عبّر عنه. يفضَّل أن ترافق المربّية الطفل بوصفٍ كلاميٍّ يتيح للأطفال متابعة التفاصيل. ثمّ نعرض البطاقة، ونسمّي لها وصفًا. تكتب المربية الكلمة ونضيفها إلى ركن الكلمات. يمكن تصوير الأطفال بتعابيرهم وإضافة الكلمات إلى الصور في الحاسوب، وجمع بطاقاتٍ منها.
الوعي الصّرفيّ:
- نربط بين السبب والنتيجة: “أنا أخاف من الليل/ الليل يُخيفني”/ “أنا أفرح من حضن أمي/ حضن أمي يُفرحني/ أخاف بسبب/ لأنّ… قد نستعمل الصور ونطلب من الأطفال وصفَ الشخصية وسبب شعورها.
- نصرف الكلمات ونبحث عن مفرداتٍ ملائمة: أشعر بالخوف- أنا خائف/ أشعر بالفرح- أنا فرحان.
بدايات القراءة:
- نُنتج قصصًا من سلسلة صورٍ لتعابير أو ملامح. يصف الطفل الصور ويربط بينها بأحداثٍ. توثق المربية ما يقول. نجمع قصصنا في كتيّبٍ نضيفه إلى ركن المكتبة، أو نجمعها في قصّةٍ محوسبةٍ بمتناول يد الأطفال,
ماذا أيضًا:
- نستثمر لوحة “من حضر إلى البستان” لتوثيق مشاعر الأطفال في الصباح، ثمّ نتحدث عنها في اللقاء الصباحيّ. في حال وجود أطفالٍ يشعرون بالحزن، من الجدير تعزيز التعاطف وسماع اقتراحات الأطفال حول إمكانيات مساعدته.
إعداد: أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة
تسجيل صوتي
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا في الصّفحة الأخيرة من نصّ الكتاب، حيث تجتمع رسومات الحيوانات. نسترجع مع طفلنا اسم كلّ حيوانٍ، ولماذا يصعب تربيته في البيت.
- نشجّع الطّفل على اختيار حيوانٍ واحد ورد ذكره في القصّة، ونضحك معًا حين نتخيّل ما يحتاجه هذا الحيوان حتّى يربى في المنزل (فتحة في سقف بيتنا لتمدّ الزّرافة عنقها…)
- نتحادث مع طفلنا حول حيواناتٍ أخرى غريبة ممكن أن تطلبها الطّفلة، ونفكّر معًا لماذا يستحيل أو يصعب تربيتها في البيت.
- إذا كنّا نربّي كائنًا حيًّا في البيت، يمكن أن نتحادث مع طفلنا حول ما يحبّه في هذا الكائن، ودوره في العناية به.
- نتخيّل أنّ الكلب الصّغير الّذي تربّيه الطّفلة قد وسّخ البيت، وأثار استياء الوالدين، فاقترحا على طفلتهما أن تربّيَ حيواناتٍ منزليّة أخرى. أيّ الحيوانات يمكن أن تربّي؟
- حيوانات الكتاب في ضيافتنا! قد نرغب بتشكيل أقنعة لوجوه الحيوانات المذكورة في الكتاب، وتوزيعها على أفراد العائلة؛ فيقلّد كلٌّ منهم صوت ومشية الحيوان! كلّ ما نحتاجه هو رسمة وجه الحيوان، وعود بوظة، وشريط لاصق.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن البدء مع الأطفال من عنوان الكتاب المثير للاستغراب: أريد فيلًا، ونسمع تخميناتهم: من يريد فيلًا؟ أيّ نوع من الفيلة تريد الطفلة (ربّما دمية فيل…)
- في القراءة الأولى، يمكن أن تتوقّفي في صفحة 8 عند بداية السّطر الثالث (بعد أن قال الأب: هذا لا يمكن أبدًا) وتشجّعي الأطفال على التّفكير بسبب يمنع تربية الأسد في البيت. يمكن تكرار ذلك في صفحة 14 (الحصان)، وفي صفحة 18 و20.
- ادعي الأطفال إلى التّفكير في حيواناتٍ أخرى يمكن أن تقترحها الطّفلة، وشجّعيهم على تخيّل مواقف مضحكة قد تحدث إذا ما دخلت هذه الحيوانات البيت.
- يربّي العديد من الأطفال حيواناتٍ أو طيور أو أسماك في بيوتهم. قد يرغب بعض الأطفال بإحضار حيوانهم الأليف إلى الرّوضة، وتعريف الأطفال على عاداته، وطرق العناية به. من المهمّ أن تحضّري الأطفال لاستقبال الحيوانات الأليفة في الرّوضة، بالاتّفاق معهم على مجموعة “أنظمة” في التّعامل مع الزّائر الأليف (تحضير طعام يحبّه بالتّشاور مع صاحبه، التّعامل معه بلطفٍ وعدم تخويفه…) كذلك يمكنك سؤال الأطفال عمّا يرغبون بمعرفته عن الحيوان، كي يكون صاحبه مستعدًّا لإشباع فضول زملائه!
- ماذا نعرف عن الأسد، والبطريق، والجمل، والحصان، وغيرها من الحيوانات المذكورة في القصّة؟ قد ترغبين بجمع ما يعرفه الأطفال، وعرضه باستخدام الرّسومات في زاوية خاصّة في الرّوضة. ماذا ينقصنا من معلومات عن كلّ حيوان؟ وأين يمكننا الحصول عليها؟ هذا سبب كافٍ ووجيه لزيارة أقرب حديقة حيوان!
- “إحزروا، أيّ حيوان أحبّ أن أكون؟” يتمتّع الأطفال بهذا النّشاط الدّرامي وهم يجلسون في حلقة، ويستخدمون الحركات والأصوات لتمثيل الحيوان الّذي يحبونه.
نشاط مع الأهل
- نستعيد مع طفلنا ما غيّر لون حذاء القط ظريف كلّ مرّة: فالتوت حوّله إلى أحمر، والقراصيا إلى أزرق، وغيرهما. نقترح عليه ألوانًا أخرى، مثل البرتقاليّ، والأسود ونشجّعه على التّفكير بما يمكن أن يحوّل الحذاء إلى هذا اللّون.
- نشجّع طفلنا على التّفكير بأكوام أخرى يدوس عليها ظريف في طريقه. بأيّ ألوانٍ سينصبغ حذاؤه؟
- هذه مناسبة لأن نزور معًا دُرج أو خزانة الأحذية في بيتنا، وتفحّص أحذيتنا: أيّ منها مغبّر، ممزّق، مبقّع، مخدوش. تُرًى، على ماذا دُسنا في طريقنا؟
- بالرّغم من اعتزاز ظريف بحذائه الأبيض الجديد، لكنّه يرى الجميل في كلّ لونٍ ينصبغ به حذاؤه. نحاول أن نستذكر مع طفلنا حوادث شبيهة بأغراضٍ شخصيّة لنا: ربّما ثوبٌ تمزّق واستعملناه لغرضٍ آخر، أو قطعة أثاث تلِفت واخترعنا استعمالًا جديدًا لها؟
- ورشة صبغ أقمشة! قد يتمتّع طفلكم باختبار صبغ القماش بألوان مختلفة. يمكن لهذا الغرض استخدام مواد طبيعيّة مختلفة، مثل منقوع الشّمندر، أو مسحوق الكركم المغلي بالماء، وغيرها.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن أن تتتبّعي مع الأطفال مشوار ظريف، وأكوام الموادّ الّتي داس عليها وصبغت حذاءه. شجّعيهم على التّفكير بموادّ أخرى قد يدوس عليها ظريف، والألوان الّتي يمكن أن ينصبغ بها حذاؤه.
- ليس كلّ أطفال الرّابعة كظريف. فبعضهم قد يحزن حين يتّسخ حذاؤه الجديد أو يتلف. اِدعي الأطفال إلى تخيّل ما يمكن أن يحسّه ظريف حين انصبغ حذاؤه. قد يساعدهم أن يستذكروا موقفًا شبيهًا مرّوا به، وما أحسّوا به وقتها.
- لنتخيّل أنّ حذاء ظريف قد انصبغ بلونٍ برتقاليّ، أو أسود، أو أصفر. على أيّ موادّ داس؟
- اِقترحي على الأطفال تغييرًا في الحبكة: ماذا لو لم ينظف حذاء ظريف؟ كيف سيشعر عندها؟
- “عرض أحذيتنا الملوّنة” قد يكون نشاطًا ممتعًا يشارك به الأهل والأطفال. اطلبي من الأطفال أن يُحضروا أحذيةً قماشيّة قديمة، وبمساعدة الأهل يصبغونها بألوانٍ مختلفة. من الجميل أن يستخدموا موادّ طبيعيّة للصّبغ، مثل: منقوع الشّمندر، أو مغلي الكركم، أو مغلي البقدونس، وغيرها. يمكن الاستعاضة عن الأحذية بأقمشة بيضاء يختبر الأطفال صبغها.
- نشاطٌ ممتع آخر يصلح للأيام الدّافئة هو أن يدوس الأطفال بأرجلهم الحافية على أكوام دهان أصابع، ويطبعون كفّات أرجلهم على أوراق كبيرة.
- تجدين في صفحة الفانوس اللّغوي (أنظري “روابط نوصي بها” في صفحة الكتاب) اقتراحاتٍ لأنشطة لغويّة حول الكتاب.
الفانوس اللّغويّ
ماذا في الكتاب؟
في نظرة:
- التصميم يُتيح مجالًا لتنمية المهارات التنويريّة، مثل : فقاعات التفكير، علامات التعجّب، وهي فرصة لحواراتٍ لغويّةٍ وعاطفيّة وذهنيّة ممتعة.
في قراءة:
- النصّ غنيٌّ بعلاقات السّبب والنتيجة (مثل: داس على كومة توت، فصار لونه أحمر).
- علامات التعجّب والاستفهام تفتح إمكانيّاتٍ لقراءاتٍ بنبراتٍ متعدّدةٍ ملائمةٍ لتنمية مهارات الوعي الصّوتيّ.
- في النصّ أفعالٌ وأوصافٌ شعوريّة وحسيّة من المحكيّة والمعياريّة، وهي توفّر فرَصًا للتجسير بين الصيغتَين. (مكيّف- بيجنّن- عظيم…).
نقترح:
- إتاحة حواراتٍ وأنشطةٍ تُثري القاموسَ الشعوريّ والعاطفيّ للطفل.
- إثراء قاموس الوصف والمقارنة والشّرط وتنمية مهارات التداوليّة.
- تطوير أنشطةٍ وألعابٍ للتعرّف على صيَغ الاستفهام والتعجّب (شفهيًّا).
قبل الانطلاق: لنتذكّر ما ينصّ عليه منهج التربية اللغويّة
جيل 3-4 سنوات
- يتمكّن الأطفال من استعمال الأسماء والأفعال والصّفات والضّمائر بصيغتها الصّحيحة حسب اللغة المحكيّة، ويستعملون المبانيَ الصّرفيّة الملائمة. يردّدون أجزاءً من قصّةٍ، ويعبّرون عن مشاعرَ ومواقف.
جيل 4-5 سنوات
- يتمكّنون من استعمال أوزانٍ مختلفةٍ في صيغتها المحكيّة والمعياريّة، يتعرّفون على الكلمات الوظيفيّة ويستعملونها بالطريقة الصحيحة، ومنها كلمات الرّبط التي تدلّ على السّبب (عَشان، لأنّ، بسبب…). يميّزون الانفعالاتِ المختلفةَ، ويتحدّثون عن تجاربَ عاشوها.
تعالَوا نتحدّث:
- نتحدّث حولَ القصّة وحبكتها، وتسلسل الأحداث. نهتمّ بالعلاقة السببيّة بين الأحداث.
- نفكّر بأشياء أخرى يسقط فيها القطّ. ماذا كان سيحدث؟ بأيّ لونٍ يصطبغ؟ ولماذا؟
- أيّة أنواعٍ من الأحذية ينصبغ لونها؟ فرصةٌ للحديث عن أنواع الموادّ المصنوعة منها الأحذية، وتصنيفها حسب أوصافٍ ومعايير.
- نتحاوَر حول شعور القطّ في كلّ مرّة؟ لو كنتَ مكان القطّ بماذا كنتَ ستشعر؟ نبحث عن حلولٍ كان يمكن أن تخفّفَ من شعورٍ سلبيّ.
- نتعرّف إلى فقاعات الأفكار، نرسمها، ويتحدّث كلٌّ منّا عن كلمةٍ تخطر بباله، وتكتبها المربية. قد نبحث أيضًا عن طرقٍ أخرى للتعبير عن الأفكار، مثل شمس التداعيات.
- نختار مفردةً مثل “عظيم” ونبحث عن أوصافٍ مشابهة. لمَن نقولها؟ يبحث كلّ طفلٍ عن زميلٍ يصِف له سلوكَه بها.
حفل الكلمات:
أسماء الألوان (أبيض، أزرق، بنيّ).. أسماء الكَومات (توت، قراصيا، وَحل)، ظريف، مُنحدَر، يسير، داسَ، استمرّ، كَومة، “بِجنّن”، انصبَغَ، عظيم، مَبلول…
- نطوّر أنشطةً حركيّةً مع الأفعال الحركيّة، نجسّدها، ونضيف صوَر الأطفال مع بطاقة الكلمة الملائمة إلى ركن “حفل الكلمات”. (داسَ، سارَ)، نقترح أفعالًا حركيّةً أخرى.
- نطوّر أنشطةً حول المشاعر وطرق التعبير عنها. نلائم بين الكلماتِ الشعوريّة وبين سلوكيّاتٍ تعبّر عنها. ماذا تفعل حين تشعر بشيء ما؟ هي فرصةٌ أيضًا للتذكير بقصّة “ماذا أفعل حين أغضب”.
- نُضيف اقتراحاتِ الأطفال للتّعبير عن المشاعر المذكورة : مثلًا كيف يمكن أن يعبّر القطّ عن أنه “مكيّف”؟ نقترح إمكانيّاتٍ ونمثّلها ونضيفها إلى ركن الكلمات، من المحكيّة والمعياريّة.
الوعي الصّرفيّ والصّوتيّ:
- ماذا لو كانت القطّة ظريفة هي الشخصية؟ نحكي القصّة بصيغة المؤنّث. نختار رمزين: (قطةً وقطًّا)، ونتحدّث مع كلّ مؤشّر بالصيغة الملائمة.
- نقطّع الكلمات بالمذكر والمؤنث ونقارن بين عدد المقاطع (قطّ- قطّة، مبسوط- مبسوطة، أبيض- بيضاء إلخ).
- نتعرّف إلى الحروف التي تكرّرَت (القاف مثلًا)، ونبحث عن كلماتٍ تبدأ بصوتها/ تنتهي بالصوت…
- نلعب مع إشارات الاستفهام والتعجّب المتواجدة في النصّ، نقرأ كلماتٍ مع كلّ إشارةٍ ونلاحظ اختلافَ النبرات والتعابير.
الكفايات اللغويّة:
- نتحدّث عن العلاقة السببيّة: لماذا انصبغَ الحذاء؟ لماذا ظلّ القطّ سعيدًا، ماذا يمكن أن يجعلنا سعداء، نتحدّث عن أمورٍ تُسعدنا. نختار كلماتٍ بالمحكيّة ونجد لها مرادفاتٍ من اللغة المعيارية : مثلاً كيف نقول مكيّف؟ بيجنن؟ نبحث عن مرادفاتٍ ونكتبها معًا. نلعب مع قوالب سببيّة وشرطيّة (أنا بكون مكيّف لمّا/ إذا صار كذا بكيّف ).
- نلعب ألعابًا في القفز بين المحكية والمعيارية. (يمكن أن نسمّيَ المعياريّة لغة الكتاب)، نختار مساحاتٍ ونلوّنها، ونخصّص لونًا للمحكية وآخر للمعيارية. حين نسمع مفردةً نقفز إلى مساحة اللون الذي يلائمها. قد نخصّص أيضًا مساحةً للكلمات الملائمة للصيغتَين.
ماذا أيضًا:
- نحضّر صوَرًا تعبّر عن حركات، مع وجود الكلمات التي تعبّر عنها ونضيفها إلى مركز الرّياضة.
- نبحث عن قصصٍ أخرى في مكتبتنا تتحدّث عن الحيوانات، نرتّبها معًا في رفٍّ خاصّ، ونقارن بينها.
- نجمع أحذيتنا، وأحذيةً من أبناء العائلة والزّملاء، نقيس ونقارنُ بين المقاساتِ. نتعرّف إلى أنواع الموادّ المصنوعة منها الأحذية وخواصّها، نقارن بينها، ونُجري تجاربَ علميّةً مع الموادّ، نقيم يومًا للأحذية في الرّوضة: نعرض صوَرًا ورسوماتٍ، نلعب ونمشي بأحذيةٍ مختلفة، نمشي ونقفزُ حفاةً ( نحضّر المكان والبيئة ونختار الألعابَ الملائمة).
عملًا ممتعًا..
أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة.
نشاط مع الأهل
- قد نُكمل مشاهد الكتاب مع طفلنا: كم نضحك عندما…ونمثّل مواقف أو أفعالٍ تثير عادة ضحك طفلنا، مثل دغدغته، أو حمله على ظهرنا.
- قد نتحادث مع طفلنا حول أمورٍ تضحكه في البيت، وفي الشّارع، وفي الرّوضة. يمكن أن نشجّع الطّفل على رسمها، ونكتبها نحن بلغته.
- ما الّذي يُضحك كلّ فردٍ من أفراد عائلتنا؟ نشجّع الطّفل على القيام “ببحثٍ صغير”، وتقليد طريقة ضحك كلّ فردٍ في العائلة.
- نفتّش معًا بين رفوف مكتبة الطّفل. أيّ كتابٍ يُضحك الطّفل؟ سيكون ممتعًا إذا قرأناه معًا مرّة أخرى، أو ربّما حضرنا معًا فيلمًا مضحكًا يحبّه طفلنا.
- “الصّنم” لعبة مسلّية يتمتّع بها الكبار والصّغار. يتجوّل اللاّعبون في الغرفة أو السّاحة على وقع أنغامٍ موسيقيّة، وحين تصمت الموسيقى، يقف كلّ لاعبٍ بلا حراكٍ، وعلى المهرّج أن يحاول إضحاكه بحركات أو تعابير وجه أو عبارات، شرط ألاّ يلمسه.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- تحدّثي مع الأطفال حول الأمور التي تضحكهم في البيت أو في الروضة. ما هي؟ ولماذا تضحكهم؟ وهل يتّفق الأطفال عليها؟
- ادعي الأطفال إلى تأمّل الرّسومات، وإلى تتبّع تعابير وجوه وأجسام الأطفال حين يضحكون. ما الّذي يحدث في أجسامنا حين نضحك؟ يمكن أن نرى ذلك أمام المرآة.
- قد يرغب الأطفال في رسم أنفسهم وهم يضحكون لإعداد “البوم صورنا الضّاحكة.” وقد ترغبين أيضًا في التقاط صورٍ لأطفال الرّوضة خلال أسبوع في مواقف مضحكة، والحديث عنها. يمكن أيضًا أن تطلبي من الأهل صورةً لطفلهم الضّاحك، وتشجّعي كلّ طفل على الحديث عن صورته في المجموعة.
- إذا ضحكنا معًا في المجموعة تتعالى نغمات وأشكال مختلفة من الضحكات. نلفت نظر الأطفال إلى التنوّع في أصوات ضحكاتنا.
- افتتحي اللّقاء الصّباحي اليومي بتشجيع الأطفال على سرد مواقف مضحكة يمرّون بها، وشاركيهم في الضحك مع بقيّة الأطفال. لا أفضل من بدء اليوم بالضّحكة!
- “يوغا الضّحك” طريقةٌ حديثة في العلاج النّفسي، وفي تحسين صحّتنا النّفسيّة باستخدام الضّحك. ندعوك في هذا الرّابط إلى التّعرف عليها، وعلى بعض الأنشطة المناسبة للعمل مع أطفال روضتك.
نشاط مع الأهل
- نتحدّث مع طفلنا عن نشاط يحبّ أن يقوم به كغيره من الأطفال، وعن نشاطٍ خاصّ يتميّز به ويمنحه متعة. قد نرغب نحن أيضًا بمشاركة طفلنا أنشطة أو هوايات نتميّز بها.
- يختفي الأرنوب فجأة..ماذا يمكن أن يكون سبب غيابه؟ وبماذا شعر أصدقاؤه حين غاب؟
- غياب شخص عزيز من حياة الطّفل خبرةٌ عاطفيّة صعبة، لكنّ الفقدان جزءٌ حتميّ من حياتنا كلّنا. قد تثير القصّة ذكريات ومشاعر مؤلمة لغياب أحد الأشخاص القريبين إلينا وإلى الطّفل. هذه مناسبة لدعم الطّفل في التعبير عن مشاعر الحزن والحنين كجزء من التّعامل الإيجابي مع الفقدان.
- ترك الأرنوب ألوانه وأدواته الموسيقيّة لأصدقائه ليلعبوا ويُبدعوا ويتذكّروه بفرح. قد نرغب في أن نسترجع مع طفلنا ذكرياتٍ جميلة مع عزيزٍ غاب، وأن نوثّقها في ألبوم صورٍ، أو في كتاب نساعد الطفل في تأليفه ورسمه، ويتضمّن مشاهد جميلة يذكرها الطفل بصحبة من غاب.
- يمكننا أن ننظّم “يوم هِوايات العائلة”! يدعو كلّ فردٍ من أفراد العائلة الآخرين لأن يشاركوه نشاطًا يحبّه.
- تتّبع الرّسامة تقنية اللّعب ببقع الألوان في تشكيل الرسومات. يمكننا اختبارها بأن نضع كمية صغيرة من دهان الرّسم الخاصّ بالأطفال على ورقة، وأن ننفخ عليها باستخدام قشّة مصّ بلاستيكية، فيتطاير الدهان على الصفحة ونحصل على لوحة تشكيلية جميلة، أو خلفية ملوّنة لرسومات طفل
- أوراق الشّجر اليابسة في كيس مغلق ، أو حبّات الحمّص الجافّة في علبة لبن مستعملة ومغلقة جيّدًا، توفّر لنا أدواتٍ موسيقيّة ممتازة للتّمتع بنشاط موسيقيّ مع الأطفال!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- عنوان الكتاب غير مألوف، قد يستوقف الأطفال. نسألهم، قبل القراءة الأولى، ماذا يمكن أن تعني كلمة “أرنوبيّة”؟
- يختفي أرنوب فجأة. تحدّثي مع الأطفال حول الأسباب المحتملة لغيابه. كيف شعر أصدقاؤه الأرانب؟ ماذا يدلّنا في رسومات القصّة على حزن الأرانب؟
- في مجموعات صغيرة، شجّعي الأطفال على الحديث عن شخص ( مخلوقٍ) عزيز فقدوه أو غاب عنهم. ماذا شعروا؟ أيّ ذكرى جميلة بقيت لديهم من هذا الشّخص؟ قد يرغب بعض الأطفال في إحضار صورة أو غرض يرتبط بهذا الشّخص والحديث عنه مع الأطفال الآخرين. هذا نشاط على قدر كبير من الحساسيّة، قد يساعد بعض الأطفال في التنفيس عن مشاعرهم وفي تلقّي الدّعم منك ومن الآخرين، لكنّه قد يرجع لأطفال آخرين مشاعر صعبة حادّة مربوطة بالفقدان. أنت تعرفين مجموعة الأطفال جيّدًا وتستطيعين القرار ما إذا كان هذا النشاط مناسبًا للأطفال بستانك.
- في الكتاب فرصة لنشاط موسيقي ممتع مع الأطفال باستخدام أدوات موسيقيّة مختلفة. ممكن أن يبدأ أحد الأطفال بإصدار أصواتٍ من آلة واحدة تشير إلى الأعمال العادية التي يقوم بها الأرنب: فكيف يعبّر الإيقاع عن وثبه، أو فتله لشاربيه؟ بعدها ينضمّ أطفال آخرون يستخدمون آلاتٍ أخرى مذكورة في القصّة لينقلوا أجواء الفرح والحركة في الغابة. أيّ آلة تنقل جوّ الحزن الذي أحسّه الأرانب بفقدان صديقهم؟
- ممكن أن ندمج النّشاط الموسيقي مع الأطفال بنشاط مسرحي حركي ممتع وباستخدام قطع القماش الملوّنة تعبيرًا عن بقع الدّهان التي ينثرها الأرانب في الغابة وفي جحر أرنوب.
- يساعد أرنوب أصدقاءه في “اكتشاف” مواهبهم وطاقاتهم. تحدّثي مع الأطفال في مجموعاتٍ صغيرة حول أعمال يحبّون القيام بها وتمنحهم المتعة.
- يمكن أن تنظّمي يوم “هوايات عائليّة” تدعين بها الأهل وطفلهم لمشاركة الآخرين في هواية يقوم بها أفراد العائلة جميعهم ( تركيب بازل، جمع طوابع، عزف موسيقى…وغيرها).
- تستخدم الكاتبة/الرّسامة أسلوب النّفخ على بقع الدّهان لتشكيل لوحاتها. يتمتّع الأطفال برؤية الأشكال المختلفة التي تنتج على الورقة من النفخ على بقع الدّهان بقشّ المصّ!
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع طفلنا حول سلوك دُنى في البيت وفي الرّوضة: لماذا ترفض ما يقدَّم لها أو يُطلب منها؟ نتحادث حول ما يمكن أن تشعر به دُنى في هذه المواقف.
- نحضّر مع طفلنا بطاقتين، على الأولى نكتب كلمة “بدّي” ( مع وجه مبتسم) وعلى الأخرى “بدّيش” ( مع وجه عابس). حين نرفع البطاقة الأولى، نطلب من الطفل أن يذكر أمرًا يريده دائمًا، والعكس مع البطاقة الثانية. قد نتناوب الأدوار، فنعّبر نحن- الأهل- عن سلوكيّات نريدها أو لا نريدها ضمن حياتنا العائلية.
- نختار موقفًا واحدًا يتكرّر في مشهد عائلتنا، يعبّر فيه الطّفل عن رفضه القيام بعمل ما ( كأن يرتّب أغراضه مثلاً، أو يستحمّ، أو يلبس الملابس التي يختارها له الأهل ) ونمثّله. نشجّع الطّفل من خلال الحوار التمثيلي على التعبير عن سبب رفضه، ونسأل رأيه في اقتراحاتٍ بديلة تخفّف من وتيرة وحدّة الرّفض ( كأن نعرض عليه عدّة إمكانيات للّباس، أو أن يختار جزءًا من الملابس).
- يمكننا أن نصيغ مع الطّفل “اتّفاقيّة ” حول الأمور التي يرغب بأن يقوم بها ونسمح له بذلك، وأخرى لا نسمح له من منطلق مسؤوليتنا كأهلٍ ( كأن يلعب في الشارع). يمكننا أن نستخدم قصاصات صورٍ من الجرائد والمجلاّت وأقلام الرّسم لنحوّل النّشاط إلى ورشة فنيّة ممتعة.
- يمتاز أسلوب الرّسامة باستخدام بارز للدائرة وأجزائها في تشكيل رسومات بتقنيّة الكولاج. قد نحبّ أن نشكّل معًا رسمة كبيرة لأفراد عائلتنا باستخدام هذا الأسلوب.
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- نتوقّف في القراءة الأولى عند العنوان: من هي دُنى برأيكم؟ وماذا تريد؟ تتيح هذه المحادثة للأطفال أن يعبّروا عن أمور يرغبونها.
- نعود مع الأطفال إلى المواقف التي ترفض فيها دنى اقتراحات من حولها: وجبة الفطور، والملابس التي تعدّها الأمّ لها. نتحادث معهم حول أسباب رفض دنى برأيهم ( ربّما لا تحبّ نوع الطعام المقدّم لها، وربّما تريد أن تلبس الثوب الجديد لتريه لأصدقائها). نستخدم تمثيل الأدوار- المربية كأمّ وأحد الأطفال كدنى. نطلب من الأطفال المساعدة في اقتراح حلول بديلة على الأم وعلى دنى.
- ترفض دنى إعطاء اللعبة لصديقتها. نتحادث مع الأطفال حول ما يمكن أن يكون سبب رفض دنى. كيف يمكن أن تشعر دنى، وكيف ممكن أن تشعر صديقتها في تلك اللحظة؟ نشجّع الأطفال على اقتراح حلول بديلة.
- نتحادث حول مواقف شبيهة قد تحدث يوميًا في الروضة. كيف تعامل الأطفال معها، وكيف تعاملت المربية؟
- نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة ( أريد) ووجوهًا عابسة ( لا أريد). نشجّع كلّ طفل على الحديث عن أمرٍ يريده وآخر لا يريده في الروضة، حين يرفع رسمة الوجه الملائم. يتيح لنا ذلك كمربّيات أن نتعرّف أكثر على ميول وأحيانًا صعوبات الأطفال كمجموعة وكلّ طفل كفرد.
- يمكننا أن ندعو الأهل إلى ورشة تأليف كتاب مع طفلهم بعنوان “فلانة/ة يريد/تريد”. وهذه مناسبة أن يتعرّف الأهل على أمور يرغبها أطفالهم في حياتهم العائلية.
- تقنيّة الرّسم – كولاج من الدّائرة وأجزائها- تسهّل على أطفال هذا العمر تشكيل وجوههم وإلصاقها على أغلفة كتبهم الخاصّة مثلاً.
أسباب قد تجعل طفلنا أكثر عنادًا
الأهل الأعزّاء،
“لا أريد”، جملة تكرّرها دُنى وتدعونا من خلالها إلى عالمها، عالم طفلة فضوليّة ترغب في استكشاف البيئة حولها. ولكنّها، كمعظم أطفال سنّها، تمرّ في مرحلة “عناد ورفض”، معبّرة بذلك عن حاجتها لاختبار الحدود التي يضعها الآخرون لها، وعن رغبتها في الاستقلاليّة.
هناك أسباب أخرى قد تجعل طفلنا أكثر عنادًا؛ مثل رغبته في لفت الانتباه أو صعوبته في التعبير عن مشاعره بالكلام، أو حتّى الشعور بالتعب أو الإحباط. إنّ التوجّه الهادئ المتفهّم لحاجة الطفل ومشاعره مع وضع حدود واضحة، يساعد جدًّا في تخطّي هذه المرحلة بسلام. يمكننا مثلًا أن نتيح له الفرصة لتجريب استقلاليّته في أمور بسيطة، مثل اختيار طعم البوظة الذي يحبّ أو نوع الحذاء المفضّل؛ وعلينا في مواقف أخرى أن نضع حدودًا واضحة ومنطقيّة، مثل أن نقول له “بعد الانتهاء من اللعب نعيد الألعاب إلى مكانها”. هذا التوازن يعزّز شعور الطفل بالثقة والمقدرة من جهة، والإحساس بالأمان للتجربة والتعلّم من جهة أخرى.
عملًا ممتعًا!
حول الكتاب
المربّية العزيزة،
يميل الأطفال الثالثة والرّابعة الى العناد، فهم يصّرون على مطلبهم، ويبدو لنا -نحن الكبار- أحيانًا بأنّهم يتحدونا. في الواقع ينشغل طفل هذا العمر بفحص الحدود التي يضعها الكبار، كجزء من مرحلة استقلاله عنهم، إن كان في قضاء حاجاته اليومية، وإن كان في تكوين ذوقه، وميوله واهتماماته. لا ننسى أيضًا
أن ّ طفل هذا العمر ما زال في مرحلة الأنويّة، فمن الصّعب عليه مشاركة الآخرين أغراضه، والتّعاون معهم لإنجاز عمل مشترك.
كما أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية- التطورية يجدون صعوبة في فهم وجهات نظر الآخرين أو مشاركة ممتلكاتهم بسهولة. لذلك، قد يكون من الصعب عليهم التعاون في الأنشطة الجماعية أو العمل المشترك، حيث يكون تركيزهم منصبًّا بشكل أساسي على رغباتهم واحتياجاتهم الخاصة.هذا جزء طبيعي من تطور الإدراك الإجتماعي والإنفعالي لديهم.
إن ّ إدراكنا كمربّيات لهذه المرحلة النّمائية، واحتواء الطّفل ومساعدته على تجاوزها مهم ّ جدًّا من أجل تنمية ثقته بنفسه وقدرته على التّواصل السّليم مع أقرانه. يمكنك تشجيع الطفل على اللعب الجماعي الذي يتطلب التناوب والمشاركة واستخدام عبارات إيجابية مثل: “لنلعب معًا ونتشارك اللعبة بدلًا من أن تبقى مع شخص واحد”، وتشجيعه على الاستماع للآخرين والتفاعل معهم مثال نطلب منه “استمع لي ثم
أخبرني ماذا قلت”. وأخيرا الحوار بعد موقف اجتماعي، حيث يمكنك أن تسألي الطفل:كيف تعتقد أن صديقك شعر عندما أخذت لعبته دون أن تسأله؟ ماذا لو كنت مكانه؟ كيف ستشعر؟ وغيرها.
نتتبّع سلوك دُنى في البيت والروضة، ونسأل طفلنا...
حول سلوك دُنى: نتتبّع سلوك دُنى في البيت والروضة، ونسأل طفلنا: لماذا ترفض دنى ما يُقدَّم لها أو يُطلَب منها؟ كيف شعرت عندما رأت الكتاب مع أبيها؟ ما الذي جعل دُنى تغيّر كلمتها من “لا أريد” إلى “نعم أريد”؟
حول تجارب شبيهة: نسأل طفلنا: هل مررت بمواقف شبيهة وكرّرت “لا أريد”؟ ماذا كنت تريد فعلًا؟ هل حدث معك أن غيّرت كلمة “لا أريد” بكلمة “نعم أريد”؟ متى ولماذا؟
حول توقّعات مختلفة: نختار ونمثّل موقفًا واحدًا يتكرّر مع طفلنا، يعبّر فيه عن رفضه القيام بعمل ما. نشجّع الطفل من خلال الحوار التمثيليّ على التعبير عن سبب رفضه، ونسأل رأيه في اقتراحاتٍ بديلة تخفّف من وتيرة وحدّة الرفض.
نتواصل
نحفّز التعبير عن الرغبات بطريقة مختلفة ونحضّر مع طفلنا بطاقتين، على الأولى نكتب كلمة “أريد” (مع وجه مبتسم) وعلى الأخرى “لا أريد” (مع وجه عابس). حين نرفع البطاقة الأولى، نطلب من الطفل أن يذكر أمرًا يريده دائمًا، والعكس مع البطاقة الثانية. يمكن أن نتناوب الأدوار، فنعّبر نحن كأهل عن سلوكيّات نريدها أو لا نريدها ضمن حياتنا العائليّة.
تتيح المحادثة للأطفال أن يعبّروا عن أمور يرغبونها
نتحادث
حول العنوان: نتوقّف في القراءة الأولى عند العنوان: من هي دُنى برأيكم؟ وماذا تريد؟ تتيح هذه المحادثة للأطفال أن يعبّروا عن أمور يرغبونها.
حول سلوك دنى: ترفض دنى إعطاء اللعبة لصديقتها. نتحادث مع الأطفال حول ما يمكن أن يكون سبب رفض دنى. كيف يمكن أن تشعر دنى، وكيف ممكن أن تشعر صديقتها في تلك
اللحظة؟ نشجّع الأطفال على اقتراح حلول بديلة.
حول تجارب شبيهه: نشجع الأطفال على المشاركة ونتحادث حول مواقف شبيهة قد تحدث يوميًا في الروضة. كيف تعامل الأطفال معها، وكيف تعاملت المربية؟
حول حلول بديلة: نعود مع الأطفال إلى المواقف التي ترفض فيها دنى اقتراحات من حولها: وجبة الفطور، والملابس التي تعدّها الأم ّ لها. نتحادث معهم حول أسباب رفض دنى برأيهم (ربّما لا تحبّ نوع الطعام المقدّم لها، وربّما تريد أن تلبس الثوب الجديد لتريه لأصدقائها).
نستخدم تمثيل الأدوار- المربية كأم ّ وأحد الأطفال كدنى. نطلب من الأطفال المساعدة في اقتراح
حلول بديلة على الأم وعلى دنى.
نتواصل
نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة (أريد) ووجوهًا عابسة (لا أريد). نشجّع كلّ طفل على الحديث عن أمرٍ يريده وآخر لا يريده في الروضة، حين يرفع رسمة الوجه الملائم. يتيح لنا ذلك كمربّيات أن نتعرّف أكثر على ميول وأحيانًا صعوبات الأطفال كمجموعة وكلّ طفل كفرد.
يمكننا أن ندعو الأهل إلى ورشة تأليف كتاب مع طفلهم بعنوان “فلانة/ة يريد/تريد”. وهذه مناسبة أن يتعرّف الأهل على أمور يرغبها أطفالهم في حياتهم العائلية.
نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة (أريد) ووجوهًا عابسة (لا أريد).
نتواصل
نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة (أريد) ووجوهًا عابسة (لا أريد). نشجّع كلّ طفل على الحديث عن أمرٍ يريده وآخر لا يريده في الروضة، حين يرفع رسمة الوجه الملائم. يتيح لنا ذلك كمربّيات أن نتعرّف أكثر على ميول وأحيانًا صعوبات الأطفال كمجموعة وكلّ طفل كفرد.
يمكننا أن ندعو الأهل إلى ورشة تأليف كتاب مع طفلهم بعنوان “فلانة/ة يريد/تريد”. وهذه مناسبة أن يتعرّف الأهل على أمور يرغبها أطفالهم في حياتهم العائلية.
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع الطّفل حول الغيمة التي أحسّ أنّها تشبهه. بماذا يتشابهان؟
- تتمتّع الغيمة بالتّجوال في كلّ مكان. لو كنّا غيومًا، أيّ الأماكن نحبّ أن نزور؟
- تشعر الغيمة بالوحدة حين يخرج والداها للسّهر، فتتسلّى مع رفيقاتها الغيمات. نتحادث مع الطّفل حول مشاعره حين نغيب عنه، ونفكّر معًا بأمور يمكن أن تشعره بالأمان ( مثل التّواصل الهاتفي، أو البقاء مع شخصٍ يحبّه ويرتاح معه)
- الغيمة سعيدةُ باللّعب مع صديقاتها. ماذا نحبّ أن نعمل مع أصدقائنا نحن؟
- يمكننا أن ندعو طفلنا إلى تأليف كتابه الخاصّ: “لو كنت غيمة…”
- سماء الخريف مليئةٌ بالغيوم على أشكالها المختلفة. من الممتع أن نستلقي معًا على الأرض في الحديقة ونتأمّل السّماء: أي أشكالٍ نرى؟
- غيومٌ في بيتنا! نفتّش عن موادّ موجودة في البيت، يمكن أن “نصنع” منها غيومًا صغيرة: كرّات القطن مثلاً، أو صابون الحلاقة الذي إذا أضفنا إليه أصباغ أكلٍ، حصلنا على غيومٍ ملوّنة!
نشاط مع الأهل
- نتحادث مع الطّفل حول خبرته الجديدة في البستان: أيّ جديد تعلّمه؟ ماذا يشعره بالفرح وبالرّغبة في الذّهاب صباحًا إلى البستان؟ وما الذي يشعره بالقلق وبالانزعاج؟
- نتحادث حول أغراضٍ يهمّ الطّفل أن يأخذها معه من البيت إلى البستان الجديد، كلعبةٍ يحبّها، أو أشخاص يرغب باصطحابهم. هل يمكنه ذلك، وما البديل في حال صعب الأمر؟
- نستذكر أمورًا نحبّ أن نقوم بها معًا: كأن نخرج في نزهة عائلية، أو نقرأ كتابًا ، أو نعدّ طبق مفضّلاً من الحلوى، وغيرها. نحاول أن نخصّص وقتًا خلال الأسبوع للتمتّع مع طفلنا بنشاطٍ أو أكثر.
- يختلف النّاس في طرق تعبيرهم عن الفرح، فمنهم من يغنّي، أو يرقص، أو يعانق من يحبّهم. نتحادث حول طرق تعبيرنا نحن عن الفرح، ونفكّر بأشخاصٍ آخرين من العائلة أو الأصحاب، ونتمتّع بتقليدهم.
- ورشة أجنحة الفرح! نتحادث عن أمورٍ تفرحنا، فنشعر كأننا نطير مثل الطفلة في القصّة. قد نرغب في أن نشجّع طفلنا على رسم ما يشعره بالفرح، أو تجسيده بالمعجونة. نصمّم معًا أجنحة نلبسها ونلصق عليها ما يفرحنا، ونطير!
- حين تعتلي الطّفلة كتفَيْ والدها، ترى العالم مختلفًا من فوق. ما الذي يراه طفلنا إذا اعتلى كتفينا؟ وكيف تبدو حارته، مثلاً، إذا شاهدها برفقتنا من سطح البيت؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- تتبّعي مع الأطفال محاولات الطّفلة للطّيران بدون أجنحتها. من ساعدها، وهل تستطيع فعلاً أن تطير إذا وضعت جناحين؟
- تحادثي مع الأطفال حول “الأجنحة”. من يملكها؟ وبماذا تساعده؟
- قد ترغبين بالخروج مع الأطفال إلى السّاحة لنشاطٍ حركيّ جماعيّ: يلوّح الأطفال بأذرعهم، يمدّونها إلى جنب ويركضون، يقفزون، يدورون حول أنفسهم. تحادثي معهم بعد النّشاط عن إحساسهم: متى شعروا كأنّهم يطيرون؟
- تحادثي مع الأطفال عن مواقف في حياتهم، يشعرون بها كأنّهم يطيرون، مثل خبرة مفرحة جدًا، أو خبرة الرّكوب في قطار سريع في مدينة الملاهي. من المُثري أن تربطي ذلك بتعبير شائع في اللّغة العربيّة الفصحى والعامّية: طِرتُ من الفرح.
- يألف الأطفال العديد من الشّخصيات الخياليّة، سواء في أفلام الصّور المتحرّكة أو في الأدب الشّعبي، والّتي تملك أجنحة. تحادثي مع الأطفال حول هذه الشّخصيات: ماذا يميّزها؟ وأيّ منها يفضّلها الطّفل؟
- ورشة تصميم أجنحة فرح! يمكن تنظيم مثل هذه الورشة مع الأهل والأطفال، وتوفير لهم موادّ متنوّعة لبناء الأجنحة، مثل: الكرتون، والرّيش الكبير الحجم، وقطع القماش، ونُتف القطن. تجدين في الجهة اليمنى من هذه الصّفحة روابط لمواقع مساعدة. شجّعي الأهل على التّحادث مع أطفالهم حول ما يشعرهم بالفرح في بيئة العائلة (مثل نشاط مشترك وممتع لأفراد العائلة: نزهة، لعب..) وكتابة ذلك على الجانب الدّاخلي من الجناح. قد يرغب الأهل بتصميم أجنحة خاصّة بهم أيضًا، ومشاركة الأطفال ما يجعلهم يشعرون بأنّهم “يطيرون”.
- النّص غنيّ بالأفعال التي تدلّ على حركة وأعمال يستطيع الطّفل أن يقوم بها لوحده في البيت، وأثناء لعبه في الخارج. يمكن أن تجمعي من الأطفال الأفعال التي قاموا بها لوحدهم في الصّباح قبل القدوم إلى البستان (غسلت، لبست، حضّرت، مشّطت…) والأفعال التي يستطيعون القيام بها خلال لعبهم في السّاحة (قفزت، صعدت، درت، عبّأت…) وكتابتها على بطاقاتٍ، والتّفكير في لعبة ملاءمة أو لعبةٍ حركيّة باستخدام هذه البطاقات. يمنح ذلك الأطفال شعورًا بالمقدرة، حين يستذكرون ما يستطيعون القيام به لوحدهم.
نشاط مع الأهل
- نتأمّل معًا رسومات الكتاب، كيف عبّر أفراد عائلة غوريلاّ الصّغير عن حبّهم له؟ وكيف عبّرت حيوانات الغابة الأخرى عن محبّتها له؟
- وفي عائلتنا، كيف نعبّر عن حبّنا لبعضنا؟ قد نعانق، ونقبّل، وندلّل، ونساعد… كيف يحبّ طفلنا أن نعبّر له عن محبّتنا، وكيف نحبّ نحن أن نشعر محبّته؟
- نتحادث حول ردّ فعل الحيوانات على نموّ غوريلاّ الصّغير كما تظهر في الرّسومات. على ماذا تدلّ، ولماذا؟ ماذا تدلّ تعابير وجه غوريلاّ عن شعوره؟
- هذا هو الوقت لنفتح ألبوم الصّور القديمة، ونتمتّع مع طفلنا بتأمّل صوره في مراحل نموّه المختلفة. يمكننا أن نتتبّع محطّاتٍ مهمّة في نموّه: متى بدأ يحبو، ويمشي، ويأكل لوحده؟ لا شكّ أنّ طفلنا سيشعر بالفخر حين يمثّل لنا ما يستطيع أن يقوم به الآن، وهو على عتبة السّنة الرّابعة من عمره!
- قد تضمّ عائلتنا أُختًا أو أخًا صغيرًا لطفلنا. نتحادث عمّا يستطيع الطّفل أن يقوم به مقارنة بأخيه/أخته الصّغير/الصّغيرة. هذه مناسبة لأن ندعم الطّفل في التّعبيرعن طرق اهتمامه بإخوته الصّغار، وعن ضيقه أحيانًا من أفعالهم.
- عيد ميلاد الطّفل مناسبة مُفرحة له ولنا كأهلٍ. نتحادث عن حفل عيد ميلاده القادم: متى يأتي، ومن يحبّ أن يدعو إليه من أفراد عائلة وأصدقاء، وكيف يحبّ أن يحتفل؟
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- في القراءة الأولى، توقّفي في الصّفحة 19 بعد جملة: “ثمّ في أحد الأيام، حدث أمر ما…” لتشوّقي الأطفال إلى سماع بقيّة القصّة. شجّعي الأطفال على تخمين ما قد حدث.
- تحدّثي مع الأطفال حول مظاهر نموّ الغوريلاّ كما تظهر في الرسومات. أيّ مظاهر نموّ تحدث في جسمنا؟
- تتبّعي مع الأطفال تعابير الودّ أو الحبّ عند حيوانات الغابة للغوريلاّ الصّغير. كيف نعبّر عن حبّنا لأصدقائنا في الرّوضة؟
- حين يبدأ غوريلاّ بالنّموّ تظهر على وجهه علامات الدّهشة والحيرة. تحادثي مع الأطفال حول شعور غوريلاّ، وردّ فعل الحيوانات على نموّه.
- هذه مناسبة للحديث مع الأطفال حول الاحتفالات بأعياد ميلادهم في البيت وفي الرّوضة. كيف يحبّ كلّ طفلٍ الاحتفال بعيد ميلاده؟ من يحبّ أن يحضر الاحتفال؟
- قد يكون من الممتع أن تشجّعي الأهل على أن يصمّموا مع الطّفل ألبوم صورٍ يضمّنونه صورًا للطفل منذ ولادته إلى اليوم الحالي. يتيح ذلك حديثًا مع الطّفل حول مراحل أساسيّة في نموّه (حين بدأ بالجلوس لوحده، أو الحبو، المشي…) وما رافق ذلك من مشاعر لدى الأهل. إنّ التّسلسل الزّمني بالصّور يساعد الطّفل على إدراك مفهوم النّمو.
- أيّ حيوانات غابة نراها في الرّسومات؟ هل نعرف حيواناتٍ أخرى تعيش في الغابة؟
- الغوريلاّ هو أحد الحيوانات المهدّدة بالانقراض. هذه مناسبة للتّحدث مع الأطفال حول معنى ذلك وأسبابه، وما يمكننا نحن- الصّغار والكبار- عمله من أجل حماية هذه الحيوانات.
نشاط مع الأهل
- نتتبّع معًا أساليب رعاية الخلد للزغلول. متى لاءمت رعايته حاجات الزّغلول، ومتى لم تعد تلائمه؟ نتحادث عن الصّعوبة التي واجهها الخلد في إطلاق عصفوره من القفص.
- اعتنى الخلد بالزّغلول لأنّه أحبّه، وشارك أفراد عائلته العناية بالعصفور الصّغير. فالأمّ علّمت صغيرها كيف يطعمه، وأعاره الأب صندوق عدة عمله ليصنع قفصًا. كيف نعتني ببعضنا في عائلتنا؟
- انتقل طفلنا من الحضانة إلى الرّوضة واكتسب قدراتٍ جديدة. من الممتع أن نتحادث معه عن الأمور التي يستطيع أن يقوم به لوحده، وعن أخرى يرغب أن نفسح له المجال ليختبر القيام بها لوحده.
- الانفصال خبرةٌ عاطفيّة صعبة يمر بها الطفل بأشكالٍ مختلفة، وهي جزء طبيعيّ وحتميّ من مسار نموّه. نتحادث عن الانفصال اليومي بيننا وبين طفلنا حين نوصله إلى الروضة. هل هناك “طقس وداع” يوميّ خاصّ بناّ؟ كيف يحبّ الطّفل أن نودّعه وأن نستقبله؟
- هل نربّي في بيتنا طائرًا أو حيوانًا أليفًا؟ ما الذي يحبّه طفلنا في العناية به؟
- تزور العاصفير حدائق بيوتنا باستمرار. من الممتع أن نبني مع أطفالنا “مطعمًا” بسيطًا لها. نأخذ زجاجةً بلاستيكية فارغة، ونقصّ في وسطها فتحة نضع فيها قطع خضارٍ وفواكه، ونعلّقها على شجرة. سيستمتع العصافير بالوجبة، ونتمتع نحن بمرآها وتغريدها!
أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ
- يمكن أن تتحادثي مع الأطفال حول الطّرق التي أظهر فيها الخلد الصّغير حبّه للزّعلول (حرسه في انتظار أمّه لتأخذه، أطعمه، وبنى له قفصًا) وأن تشجّعي الأطفال على الحديث عن رعاية حيوانات أو طيور بيتية يرّبونها في منازلهم.
- على الرّغم من عناية الخلد به، لكنّ الزّغلول كان حزينًا، لماذا؟ شجّعي الأطفال على التّعبير عن كلّ الأسباب التي تخطر ببالهم.
- كان صعبًا على الخلد أن يفارق زغلوله. شجّعي الأطفال على الحديث عن مواقف شعروا فيها بالحزن على فراق شخصٍ أو كائنٍ حيّ يحبّونه. ماذا أحسّوا؟ ماذا ساعدهم في التّغلّب على حزنهم؟
- تحادثي مع الأطفال حول شعورهم حين يتركون بالبيت وأهلهم في الصّباح، ويأتون إلى الرّوضة. بماذا يشعرون؟ كيف يمكن أن يساند أطفال الرّوضة صديقهم/صديقتهم الذي يشعر/تشعر بالقلق من فراق الأهل؟
- في مسار مساندة الأطفال بالتأقلم لحياة الرّوضة، وتخفيف حدّة قلقهم، يمكن أن تتحدّثي معهم حول الأمور التي يستطيعون القيام بها لوحدهم ( مثل استخدام المرحاض، اللّعب مع الأصدقاء…)
- الخلد قارضٌ غير مألوف للأطفال. يتمتّع الأطفال بالتّعرّف عليه في مشروع تعلّمي نشط تبنيه معهم.
- شجّعي الأهل على النّشاط مع أطفالهم في البيت بالحديث عن طرق عناية أفراد العائلة ببعضهم البعض، وتحضير ألبوم صور/رسومات بعنوان: “في عائلتنا نعتني ببعضنا”. من الجميل أن تحتفظي بهذه الألبومات، وأن تنظّمي معرضًا لها في يوم العائلة مثلاً.
- قد ترغبين بجمع أغانٍ عن الطّيور يستمع إليها الأطفال. من المثير للاهتمام أن يقارن الأطفال بين أغنيتين معروفتين: الأولى “عصفور طلّ من الشّباك” لأميمة الخليل والتي تحكي عن عصفور سجين، والثّانية “طيري طيري يا عصفورة” لماجدة الرّومي. تحادثي مع الأطفال حول ما يحسّه كلّ عصفور، وعمّا توحيه الموسيقى من أجواء فرح أو حزن.
- إعداد مطعمٍ للطّيور في ساحة الرّوضة وتزويده يوميًا بالأكل الطّازج، نشاط يتمتّع به الأطفال ويتعلّمون منه الكثير عن رعاية الكائنات التي تشاركنا عالمنا.
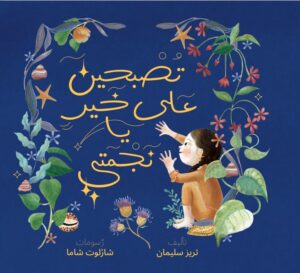 تصبحين على خير يا نجمتي
تصبحين على خير يا نجمتي 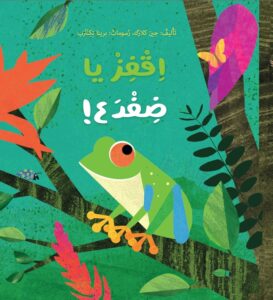 اقفز يا ضفدع!
اقفز يا ضفدع! 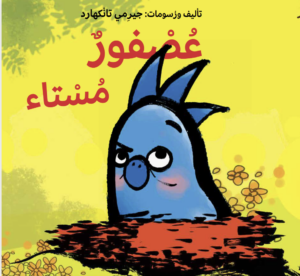 عصفور مستاء
عصفور مستاء 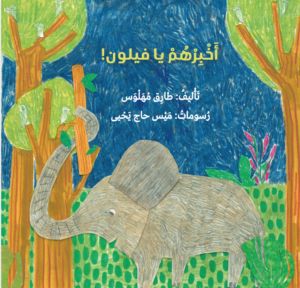 أخبرهم يا فيلون
أخبرهم يا فيلون  موجة
موجة 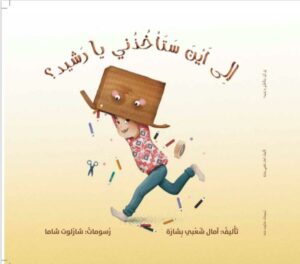 إلى أين ستأخذني يا رشيد؟
إلى أين ستأخذني يا رشيد؟ 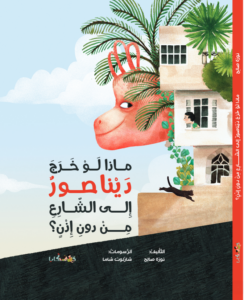 ماذا لو خرج ديناصور إلى الشارع من دون إذن؟
ماذا لو خرج ديناصور إلى الشارع من دون إذن؟ 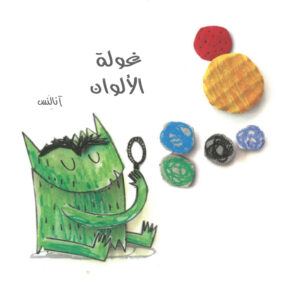 غولة الألوان
غولة الألوان 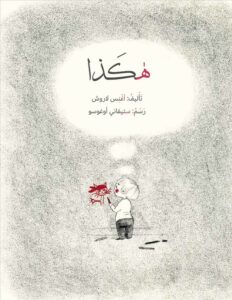 هكذا
هكذا 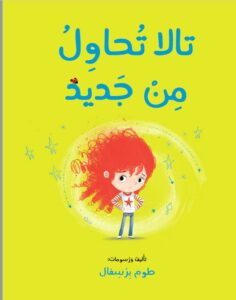 تالا تحاول من جديد
تالا تحاول من جديد 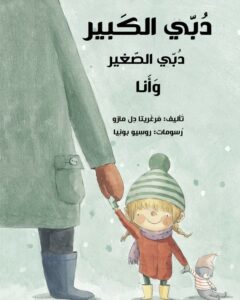 دبي الكبير، دبي الصغير وأنا
دبي الكبير، دبي الصغير وأنا 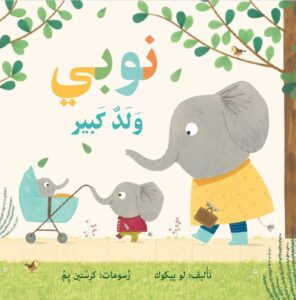 نوبي ولد كبير
نوبي ولد كبير 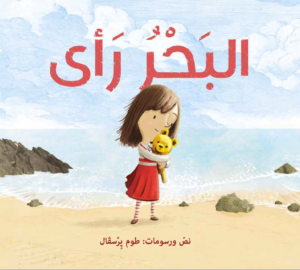 البحر رأى
البحر رأى 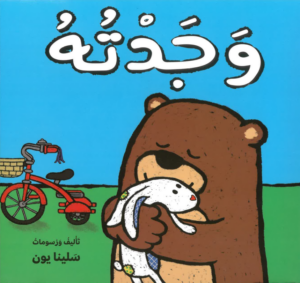 وجدته
وجدته  غمّيضة
غمّيضة 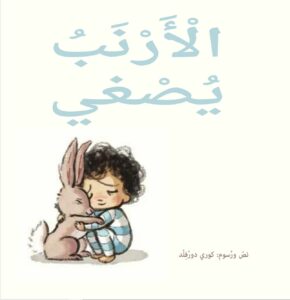 الأرنب يصغي
الأرنب يصغي 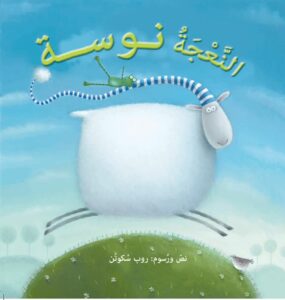 النعجة نوسة
النعجة نوسة 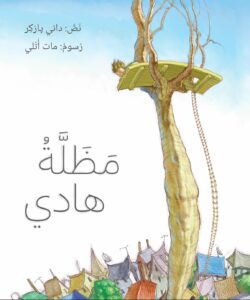 مظلّة هادي
مظلّة هادي 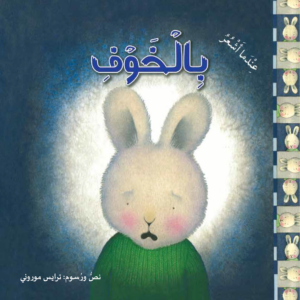 عندما أشعر بالخوف
عندما أشعر بالخوف 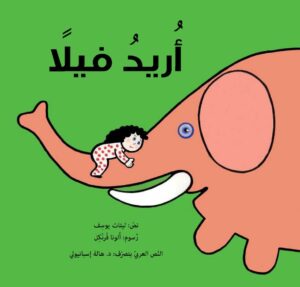 أُريد فيلا
أُريد فيلا 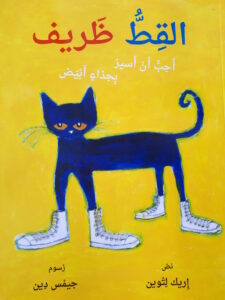 القطّ ظريف – أحبّ أن أسير بحذاء أبيض
القطّ ظريف – أحبّ أن أسير بحذاء أبيض  كم أضحك
كم أضحك 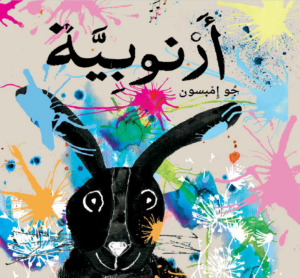 أرنوبيّة
أرنوبيّة 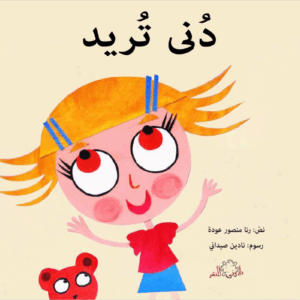 دنى تريد
دنى تريد 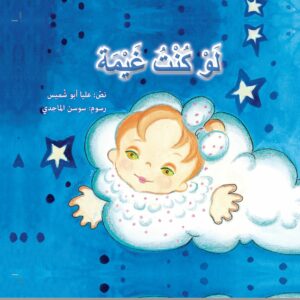 لو كنت غيمة
لو كنت غيمة 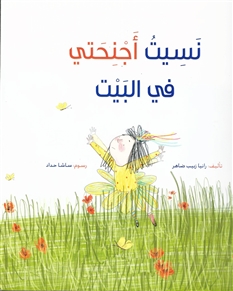 نسيت أجنحتي في البيت
نسيت أجنحتي في البيت 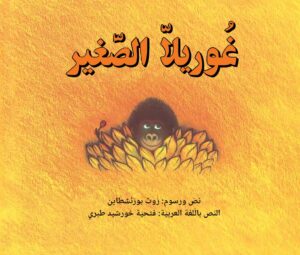 غوريلا الصغير
غوريلا الصغير 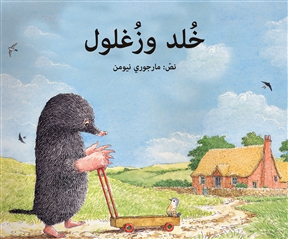 خلد وزغلول
خلد وزغلول 
